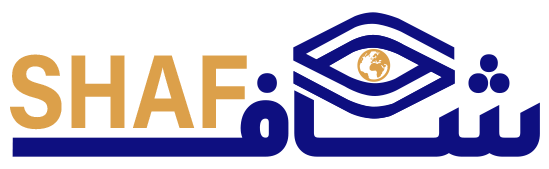المقالات
مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية > تقارير وملفات > وحدة الشرق الأوسط > أوراق بحثية > اتفاق غزة: بين التحديات الراهنة ومتطلبات المرحلة المقبلة
اتفاق غزة: بين التحديات الراهنة ومتطلبات المرحلة المقبلة
- أكتوبر 22, 2025
- Posted by: Maram Akram
- Category: أوراق بحثية تقارير وملفات وحدة الشرق الأوسط
لا توجد تعليقات

إعداد: رضوى الشريف
منسق وحدة شؤون الشرق الأوسط
مقدمة
يُشكِّلُ اتفاق وقْف إطلاق النار في غزة، الذي تمَّ توقيعه في قمة شرم الشيخ للسلام، خطوةً مهمَّةً تضع حدًّا لحربٍ داميةٍ استمرَّتْ لعاميْن، وأدَّت إلى تغيُّر في موازين القوى في المنطقة، كما فتحت المجال أمام مرحلة جديدة من التفاعلات الإقليمية والدولية، وبينما كانت الأنظار تتجه نحو البدْء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقْف إطلاق النار في غزة، شهد القطاع تطوُّرًا خطيرًا هدَّد بعودة الحرب إلى نقطة الصفر؛ ففي 19 أكتوبر 2025، شنَّ الجيشُ الإسرائيليُّ غارات جوية ومدفعية مُكثَّفة على مدينة رفح ومناطق أخرى؛ ردًّا على ما وصفه بـ”خرْق للهُدْنة” من قِبَلِ عناصر تابعة لحركة حماس؛ حيث أسفر التصعيد عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، فيما تبادلت الأطراف الاتهامات بشأن المسؤولية عن تفجير الموقف، وسط تضارُب في الروايات حول ملابسات الاشتباك، وفي اليوم ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي استئناف الالتزام باتفاق التهدئة، مُؤكِّدًا أنه “سيواصل تطبيق وقْف إطلاق النار، مع الرَّدِّ بقوةٍ على أيِّ خرْقٍ مستقبليٍّ”.
هذا الخرْق – ثم العودة السريعة إلى مسار الهدنة – أعاد التذكير بهشاشة الواقع الميداني، ومدى تعقيد البيئة الأمنية والسياسية التي يُنفَّذ فيها الاتفاق؛ فعلى الرَّغْم من أن التفاهمات التي وُقِّعت بعد حرب استمرت لعامين مثَّلت خطوة أولى نحو إعادة ترتيب المشهد في غزة، إلا أن هشاشة الأرضية التي تقوم عليها هذه التفاهُمات تجعلها عرْضة للانهيار في أيَّة لحظة؛ فالاتفاق لا يقتصر على وقْف القتال، بل يشمل ترتيبات أكثر تعقيدًا، من بينها نزْع سلاح حركة حماس، وإعادة تشغيل المعابر، وتشكيل إدارة فلسطينية جديدة بإشراف دولي، وهو ما يجعل أيَّ خللٍ أمنيٍّ قابلًا للتحوُّل إلى أزمة شاملة.
في هذا السياق المضطرب، تسعى هذه الورقة إلى تقديم قراءة تحليلية للاتفاق، عبْر تفكيك أبرز التحديات التي تُهدد فُرَص تثبيته واستدامته، وعرْض المتطلبات السياسية والعملية الضرورية لعبور هذه المرحلة الحَرِجَة، كما تسلط الضوء على التداخل بين الأبعاد السياسية، الأمنية، الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها منظومة مترابطة لا يمكن لأيِّ مسار تسويةٍ أن يستقر دون معالجتها بشكلٍ متكاملٍ وجادٍّ.
التحديات الراهنة أمام تثبيت الاتفاق
رغم ما مثَّلَهُ اتفاق غزة من بارقة أمل لإنهاء الحرب وفتْح مسار سياسي جديد، إلا أن تثبيته يواجه مجموعة من التحديات المُعقَّدة والمتشابكة التي تنبع من طبيعة الأطراف المنخرطة فيه ومن البيئة الإقليمية والدولية المحيطة، ويمكن عرضها كالآتي:
أولًا: التحديات السياسية
تُعَدُّ مسألة مستقبل الحُكْم في قطاع غزة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في سياق تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، بل وربما المعضلة المركزية التي سيتوقف عليها نجاح الاتفاق أو تعثُّره؛ فالاتفاق ينص على إنشاء إدارة فلسطينية جديدة تتولَّى إدارة القطاع بإشراف دولي وأمريكي على أن يكون الرئيس ترامب المرجعية العليا لهذه الهيئة، يعاونه توني بلير، إلى جانب ممثلين من دول عربية، مع استبعادٍ كاملٍ لحركة حماس من الهياكل السياسية والأمنية الجديدة.[1]، ورغم أن السلطة الفلسطينية يُفترض أن تتولَّى دور محوري في هذه الإدارة، إلا أن مدى جاهزيتها وقدرتها على فرْض السيطرة على قطاع لم تحكمه منذ سنوات عديدة يبقى محلَّ شكٍّ.
وتُطرح هنا عدة تحديات متشابكة والتي تتمثل في الشرعية السياسية للإدارة الجديدة، في ظلِّ غياب توافق وطني فلسطيني واسع بشأن ترتيبات ما بعد الحرب، بجانب الموقف الشعبي داخل غزة؛ حيث لا يزال لحماس قواعد دعم محلية قد تُشكِّلُ عائقًا أمام أيِّ سلطة جديدة، خاصَّةً إذا ارتبطت بقوات أمنية أو ترتيبات خارجي، كما أن الإشراف الدولي، الذي رغم أهميته في تثبيت الاتفاق، قد يُوَاجَهُ برفضٍ شعبيٍّ أو يُستخدم من بعض الأطراف كدليل على المساس بالسيادة الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى هشاشة الموقف السياسي للسلطة الفلسطينية نفسها، التي تعاني من تراجعٍ حادٍّ في شعبيتها داخل الضفة الغربية؛ ما يُضعف قدرتها على تصدُّر مشهد “ما بعد حماس” في غزة دون تصعيد داخلي أو احتجاجات مجتمعية.
في المقابل، يبرز الموقف الإسرائيلي باعتباره أحد العوامل الأكثر تأثيرًا في مسار الاتفاق، لا سيما في ظلِّ سيطرة تيارات اليمين المتطرف على الائتلاف الحاكم في تل أبيب؛ فإسرائيل، وإن قَبِلَتْ مبدئيًّا ببنود الاتفاق الأمنية والسياسية، فإنها تتعامل معه باعتباره ورقةً لإعادة هندسة الواقع الأمني في غزة، وليس مدخلًا لحلٍّ شاملٍ أو إعادة إحياء المسار السياسي الفلسطيني، كما تُبْدِي إسرائيل تحفُّظًا واضحًا تِجَاه أيِّ ترتيبات قد تُفسَّرُ لاحقًا كخطوة أولى نحو حل الدولتيْن، الذي لا يزال مرفوضًا من قِبَلِ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومن خلفه الطَّيْف اليميني الذي يرى في إقامة دولة فلسطينية تهديدًا وجوديًّا. ويؤكد ذلك إصرار القيادة الإسرائيلية على فصْل مسار غزة عن الضفة الغربية سياسيًّا وأمنيًّا، ورفضها المعلن لعودة أيِّ رمزيةٍ سياديةٍ فلسطينية مُوَحَّدة.
ثانيًا: التحديات الأمنية
يُمثِّلُ الجانبُ الأمنيُّ التحدِّي الأخطر في سياق تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بعملية نزْع سلاح حركة حماس، التي تحتفظ بمنظومة قتالية تشمل ترسانة من الأسلحة المتطورة، شبكة واسعة من الأنفاق، وقواعد دعم لوجستي مزروعة في عُمْق المناطق المدنية[2]، وتزداد خطورة هذا التحدي بالنظر إلى رفْض حماس المعلن لأيِّ ترتيبات تُفْضِي إلى نزْعٍ شاملٍ لسلاحها، واعتبار أن ذلك يُشكِّلُ مساسًا بخيار المقاومة، وهو ما يُنْذِرُ بصدام مباشر مع جوهر الاتفاق ويفتح الباب أمام انهياره ميدانيًّا قبْل أن يترسخ سياسيًّا.
فعلى الأرض، يفتقر القطاع حاليًا إلى قوة أمنية فلسطينية محايدة وفعَّالة قادرة على تنفيذ هذا البنْد الحَرِج؛ فالسلطة الفلسطينية، رغم ما يُفترض أن تضطلع به من دور في المرحلة المقبلة، لا تمتلك في الوقت الراهن بِنْيةً أمنيةً قادرةً على دخول غزة وفرْض السيطرة دون ترتيبات أمنية دقيقة وتفاهُمات ميدانية مسبقة.
وتُضاف إلى ذلك معضلة الفراغ الأمني، الناتج عن تفكُّك البنية الإدارية للقطاع خلال الحرب، والذي فتح المجال أمام تصاعد نشاط العصابات المسلحة والمجموعات غير النظامية، التي لا تخضع لأيِّ سلطة رسمية، وتستغلُّ حالة الغموض السياسي والانقسام الأمني لتحقيق مكاسب ميدانية أو فرْض نفوذ محلي؛ ما يضيف أبعادًا جديدة من التعقيد على جهود ضبْط الأمن وفرْض النظام.
وفي هذا السياق، يُشكِّلُ الهجوم الجوي الإسرائيلي الأخير على رفح وجباليا، يوم 19 أكتوبر 2025 والذي أدَّى إلى مقتل ما يقارب من 44 مواطن فلسطيني [3] ، مؤشرًا واضحًا على هشاشة الترتيبات الأمنية، ويؤكد وجود خطر حقيقي لانهيار وقْف إطلاق النار وعودة التصعيد. فضْلًا على أن المنطقة العازلة التي تسعى إسرائيل لفرضها على طول حدود غزة، تظلُّ مصدرًا إضافيًّا للتوتُّرات الأمنية،[4] فهي رغم تبريرها بأنها أداة لتحقيق الاستقرار، إلا أنها قد تتحول إلى وسيلة لفرض واقع أمني دائم يتعارض مع السيادة الفلسطينية ويُقوِّضُ فُرَص الاستقرار الشامل، كما يُحتمل أن تصبح هذه المنطقة نقطة احتكاك مباشرة بين المسلحين والقوات الأمنية الجديدة، خاصَّةً مع استمرار إسرائيل في التحكُّم بالمجال الجوي والمعابر، وفْقًا لمنطق السيادة الأمنية المطلقة.
وأخيرًا وإلى جانب هذه التحديات، يبرز الغموض المحيط بمسألة القوة الدولية التي نصَّ الاتفاق على نشْرها لتأمين المناطق المنسحبة منها القوات الإسرائيلية وضمان تنفيذ ترتيبات وقْف إطلاق النار. فرغم أهميتها كآلية انتقالية لحفظ الاستقرار، إلا أن تشكيلها ما يزال يواجه حالةً من الجمود؛ بسبب غياب وضوح في طبيعة مهامها وحدود تدخُّلها الميداني، فضْلًا عن تردُّد الدول التي يُفترض أن تشارك فيها في إرسال قواتها إلى بيئة ما تزال تحت سيطرة حركة حماس،[5] ويثير هذا الغموض مخاوف من أن يؤدي أيُّ تأخير في انتشار هذه القوة إلى خلْق فراغ أمني جديد يُعيد حماس لترسيخ نفوذها في المناطق التي انسحبت منها إسرائيل، أو يدفع إسرائيل إلى التباطؤ في استكمال انسحابها؛ ما يهدد بعرقلة المسار الأمني والسياسي للاتفاق برمته.
ثالثًا: التحديات الاقتصادية
رغم مركزية التحدِّييْن “السياسي والأمني” في بِنْية اتفاق غزة، يظلُّ التحدي الاقتصادي والإنمائي، أحد أكثر المحاور إلحاحًا وحساسية في سياق ما بعد الحرب، بل يُعدُّ أحد أهم المؤشرات على جدّية التحوُّل من منطق إدارة الأزمة إلى منطق بناء السلام، وتزداد الأزمة تعقيدًا عند ربْطها بملف إعادة الإعمار، الذي تُقدَّرُ كُلْفته بـنحو 70 مليار دولار وفْقًا لتقارير أممية، إلا أن التمويل الدولي يظلُّ مشروطًا بتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وفي هذا السياق، بدأت ترتيبات دولية لتأسيس مركز أمريكي لتنسيق جهود إعادة الإعمار بقيادة جنرال بثلاث نجوم، على أن يتمركز هذا الكيان داخل إسرائيل طِبْقًا لشبكة “ABC” الأمريكي، ويُعنى بإدارة التنسيق الأمني والإنساني وتوزيع المساعدات.[6] ورغم أهمية هذه الخطوة في وضع هيكل مؤسسي للعملية، إلا أنها تُثير عددًا من التساؤلات حول سيادة القرار الفلسطيني على أولويات الإعمار، ومدى قدرة المركز على ضبْط توزيع الموارد، وضمان عدم تسربها إلى العصابات المسلحة، كما أن التكهنات بانطلاق المركز من داخل إسرائيل – لا من غزة أو مصر – يُثير مخاوف إضافية من فرْض رقابة أمنية إسرائيلية مباشرة على عملية الإعمار.
الأكثر تعقيدًا أن خطة الإعمار لن تُنفَّذ في فراغٍ، بل في ظلِّ موازين أمنية شديدة الهشاشة، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى الدفع بتأسيس قوة دولية لحفظ الاستقرار، تضم نحو ألف عنصر، بينهم 200 أمريكي للتنسيق والدعم الفني، وتشير المصادر إلى أن القوة ستعمل بالتوازي مع نشْر وحدات فلسطينية خضعت لتدريبات في مصر والأردن؛ ما يعكس حجم التعقيد في خلق بيئة ميدانية آمنة قبْل الشُّروع في الإعمار [7]، كما تتوقف مراحل التنفيذ على ضمان استمرار فتْح معبر رفح، وهو ما لا يزال رهين الموافقة الإسرائيلية النهائية.
ويُضاف إلى ذلك، تحدٍّ بيروقراطي لا يقلُّ خطورة، يتمثل في آليات الرقابة الدولية ومحددات التمويل؛ فالدول المانحة ستشترط وجود جهة شفافة ومحايدة تشرف على التنفيذ، كما أن الإجراءات الأممية الصارمة قد تؤدي إلى بُطْء إيصال المساعدات وتفاقم الأزمة الإنسانية خلال مرحلة الإعمار.
رابعًا: التحديات الإنسانية
خلَّفت الحرب، التي استمرت لعاميْن، دمارًا واسع النطاق شمل كل مظاهر الحياة؛ حيث ذكر مركز أنباء الأمم المتحدة، أن التحليل الأوَّلِيّ أظهر أن 83 % من المنشآت في مدينة غزة وحدها مُدَمَّرٌ، مشيرًا إلى أن نحو 81 ألف وحدة سكنية في المدينة قد تضرَّرت بفِعْل عدوان الاحتلال الإسرائيلي[8]. ، لكن خلْف هذه الأرقام تقف مأساة بشرية لأكثر من مليون ونصف نسمة، معظمهم نازحون بلا مأوى دائم، محرومون من الماء والكهرباء والصرف الصحي، ويعيشون في ظروف غير إنسانية.
في هذا السياق، تواجه البِنْية الصحية في غزة انهيارًا شِبْه كامل؛ إذ توقفت معظم المستشفيات عن العمل، ونَفَدَتْ الأدوية والمستلزمات الطبية، بينما تحذر منظمات أممية من تفشِّي الأوبئة بسبب اختلاط المياه بالصرف الصحي وتكدُّس النفايات؛ حيث تمَّ تدمير ما يقرب من 90% من موارد المياه والصرف الصحي والنظافة في غزة، كما يفتقر أكثر من 60% من المنازل إلى الصابون.[9]
إلى جانب ذلك، يواجه القطاع أزمة غذائية وتعليمية حادَّة؛ فقد أعلنت وكالات إنسانية أن 70% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وسط انهيار الأسواق المحلية، وتعطل سلاسل الإمداد، وتراجع القدرة الشرائية. كما توقفت العملية التعليمية تمامًا، مع تدمير ما يقارب من 92 % المدارس، ونُزُوح آلاف الطلاب،[10] وتفاقم الاحتياج إلى دعْمٍ نفسيٍّ واجتماعيٍّ للأطفال، الذين تعرضوا لصدمات الحرب وخسارة أسرهم ومنازلهم.
في هذا المناخ، يتحوَّلُ الضغط الإنساني إلى تهديد استراتيجي للنسيج المجتمعي في غزة، بما يُعزِّزُ بيئات التطرُّف أو الفوضى في حال غياب استجابة شاملة.
المتطلبات الضرورية للحفاظ على اتفاق غزة
للتغلُّب على التحديات المعقّدة التي تواجه اتفاق وقْف إطلاق النار في غزة، وضمان استمراريته، لا بُدَّ من تجاوز الحلول المؤقتة والانتقال نحو مقاربة أكثر شمولًا من أجل تهيئة بيئة متكاملة تُعزِّزُ الاستقرار وتمنع العودة إلى المواجهة، ومن هذه المتطلبات ما يأتي:
أولًا: بناء منظومة ضمانات أمنية متوازنة
الحفاظ على الاتفاق يقتضي في المقام الأول، تأسيس بِنْية أمنية “واقعية” تستند إلى مبْدأ التوازن بين الأطراف، بحيث لا يشعر أي طرف بتهديد وجودي يدفعه للعودة إلى التصعيد، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء منظومة ضمانات أمنية مصممة “صراحةً”؛ لمعالجة هواجس الجانب الإسرائيلي من جهة، ولحماية السيادة والشرعية الفلسطينية من جهة أخرى، بحيث تُزيل الذرائع الأمنية للاختراق، وتُبْنَى في الوقت نفسه على مشاركة فلسطينية فعلية.
ويُعتبر الهدف الأساسي من المنظومة تحويل الادعاء بخُرُوقات الهُدْنة – التي قد تُستخدم، كما حدث في 19 أكتوبر، مُبرِّرًا للتصعيد – إلى آلية شفَّافة للتحقُّق والاستجابة السريعة، دون أن تتحول هذه الآلية إلى ذريعة لفرْض وصاية أو احتلال دائم.
على مستوى البِنْيَة العملياتية، قد تشمل المنظومة إنشاء غرفة عمليات مشتركة تضُمُّ ممثلين فلسطينيِّين من غزة والضفة، ومراقبين من الدول العربية، مثل “مصر وقطر”، إلى جانب تركيا، بالإضافة إلى فِرَق تحقُّقٍ دوليةٍ محايدةٍ.
كما يمكن أن تُزوَّد الغرفة بآليات ميدانية واضحة تشمل نقاط مراقبة ثابتة ومتنقلة، مراكز اتصال طارئة تعمل على مدار الساعة، وحدات استجابة سريعة مرافقة لمهام التحقق، وبروتوكولات مشتركة لجمع الأدلة، مثل “الفيديو، الاتصالات، ومسْح المواقع”.
وتُقرُّ كذلك آليات توثيقٍ مُوَحَّدة ومعايير واضحة للتحقيق في الخروقات، تُطبق بشكل فوري، إلى جانب جدول عقوبات تصاعُدي قد يبدأ بتنبيه دبلوماسي، تجميد مساعدات أو مشروعات، أو آليات تصحيح، على أن يُنفذ ذلك بعد تدقيق مستقل، وذلك للحدِّ من منطق الانتقام أو التذرُّع بالخُرُوقات دون أدلة دامغة.
ولكي تحظى المنظومة بالقبول والفعالية، يجب أن تُبْنَى على أُسُسٍ قانونيةٍ وإداريةٍ واضحةٍ تشمل تفويضًا مؤقتًا محدَّد المدة، وآليات مساءلة وطنية ودولية، وشفافية كاملة في عرْض النتائج، بما يطمئن كافَّة الأطراف ويُعزِّزُ من ثقتهم.
ثانيًا: بناء إطار سياسي توافقي يضمن الشراكة الفلسطينية الشاملة
تشير تجارب ما بعد النزاعات في السياقات المنقسمة سياسيًّا إلى أن أيَّ اتفاق، مهما بلغت قوة الضغوط الدولية الراعية له، يبقى هشًّا إذا لم يُبْنَ على قاعدة من الشرعية الوطنية الجامعة.
وفي الحالة الفلسطينية، يتعذر تثبيت اتفاق غزة دون معالجة المعضلة الجوهرية المتمثلة في الانقسام السياسي بين الفصائل الفلسطينية، خاصَّةً بين “فتْح وحماس”، والفراغ التمثيلي الذي تُعاني منه مؤسسات السلطة، إلى جانب محاولات استبعاد قوى سياسية مركزية، وعلى رأسها حماس.
وبالتوازي مع انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، تبرز ضرورة فتْح مسار سياسي موازٍ؛ يهدف إلى إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية، وإطلاق محادثات مصالحة داخلية شاملة بين الفصائل ترعاها مصر؛ بهدف التوصُّل إلى صيغة وطنية متوافق عليها لإعادة بناء الأجهزة الأمنية، وتحديد طبيعة القوة الأمنية المقترحة، بما يضمن شراكة فلسطينية حقيقية، ويُجنِّبُ الوقوع في مأزق التفرُّد أو الإقصاء، كذلك من المرجَّح أن تنخرط دول إقليمية فاعلة، مثل “قطر وتركيا”، في دعم هذا المسار، خاصَّةً في ظلِّ مواقفهما الداعمة لحق “حماس” في التمثيل السياسي، ورفْض أيِّ محاولات لتصنيفها كحركة خارجة عن الإجماع الفلسطيني، ويجب ألا تُفْهَم هذه الأدوار على أنها مناوئة للوساطة المصرية، بل تُوَظَّفُ ضمن إطار تنسيقي “عربي –إقليمي” يُسْهِمُ في تليين مواقف الأطراف المتشددة، وتحويل الضغوط الدولية إلى فُرَص تفاهم وليس فرْضًا.
وفي هذا الإطار، فإن تشكيل حكومة وحدة انتقالية تكنوقراطية، تتولَّى إدارة القطاع لفترة محدَّدة، قد يُمثِّلُ خيارًا واقعيًّا لضمان الاستقرار؛ بشرط أن تُمنح هذه الحكومة صلاحيات تنفيذية كاملة، وتخضع لرقابة عربية ودولية محايدة، تكفل تنفيذ المهام المرحلية المرتبطة بإعادة الإعمار، وضبْط الأمن، وتوفير الخدمات الأساسية للسكان.
على ألا يُنظر لهذه الحكومة باعتبارها غاية بحدِّ ذاتها، بل خطوة انتقالية نحو تسوية وطنية شاملة تقوم على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تُعيد إنتاج الشرعية السياسية، وتضمن وحدة النظام السياسي الفلسطيني، بما يُمهِّدُ لإحياء المشروع الوطني على أساس الشراكة، لا الاستقطاب.
ثالثًا: معالجة ملف نزع السلاح ضمن مقاربة تدريجية
تُمثِّلُ المعالجة الأمنية أحد الأعمدة الأساسية التي سيُبْنَى عليها مصير اتفاق غزة، لكن الإصرار على نزْع السلاح الكامل لحركة حماس كشرط لتثبيت الهُدْنة أو الانتقال إلى ترتيبات ما بعد الحرب، يحمل في طيَّاته خطر تقويض الاتفاق بدلًا من تثبيته؛ حيث يُعدُّ السلاح جزءًا من المعادلة الوطنية المُعقَّدة، وليس مجرد ملف أمني يمكن تسويته إداريًّا، وعليه؛ فإن أيَّ مقاربة أمنية فعَّالة يجب أن تراعي السياق المحلي، وتستند إلى منطق التدرُّج والدَّمْج لا الإقصاء والتفكيك.
في هذا الإطار، يمكن تصور مسارين بديلين لنزْع السلاح:
الدَّمْج التدريجي ضمن المؤسسات الأمنية
يقصد هنا دمْج عناصر حماس وفصائل المقاومة ضمن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، التي تُدار حاليًا من قِبَلِ حركة فتْح تحت مظلَّة منظمة التحرير الفلسطينية، ويفترض هذا الخيار انخراط عناصر المقاومة في هذه المؤسسات وفْق برامج تأهيل وتدريب مهنية، بضمانات قانونية ومراقبة دولية تمنع الملاحقة، وتُعزز الشفافية والمهنية، ويتطلب تطبيق هذا المسار توافقًا فلسطينيًّا داخليًّا، وتنسيقًا عربيًّا إقليميًّا، على رأسه “مصر وقطر والسعودية وتركيا”؛ لضمان تسلْسُل تنفيذي غير صدامي، خصوصًا في ظلِّ المخاوف من تفكُّك الأمن أو نُشُوء سلطات موازية.
تجميد السلاح تحت رقابة محايدة
وفي حال تعذُّر المُضيّ الفوري في خيار الدَّمْج التدريجي لعناصر المقاومة ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية، يُمكن اعتماد خيار تجميد مرحلي للسلاح الثقيل كخطوة انتقالية واقعية، ويقضي هذا الطَّرْح بتخزين الأسلحة الثقيلة، مِثْل “الصواريخ وقاذفات الهاون”، في مواقع محددة تخضع لرقابة عربية ودولية محايدة، بما يضمن وقف استخدامها دون المطالبة المباشرة بنزعها أو تسليمها.
وقد أبْدَى عددٌ من مسؤولي حماس – خلال جولات التفاوض السابقة – استعدادًا أوَّلِيًّا لمناقشة هذه الخطوة، بل أشار بعضهم إلى إمكانية التخلِّي عن الأسلحة الثقيلة،[11] ومغادرة عددٍ من قيادات الحركة للقطاع، مقابل الحصول على ضمانات سياسية تتيح لها دورًا في المرحلة الانتقالية ما بعد الحرب، بما يشير إلى وجود هامشٍ يمكن البناء عليه ضِمْن مقاربةٍ تدرُّجِيَّةٍ.
ويتطلب هذا المسار، أن يُعاد تعريف دور القوة الدولية في غزة؛ بحيث لا تقتصر على الرقابة، بل تشارك في بناء وتأهيل الجهاز الأمني الفلسطيني، بما يسمح بخلْق منظومة أمنية مهنية تخضع للمساءلة الوطنية، وتحظى بقبول مجتمعي، ومن شأن هذا النَّهْج أن يفتح الباب أمام ترتيبات أمنية قابلة للتنفيذ، دون أن تمسَّ بسيادة الفلسطينيين أو حقوقهم، وهو ما يُعَدُّ شرْطًا أساسيًّا للاستقرار على المدى الطويل.
رابعًا: إطلاق مسار متكامل لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة
إلى جانب المقاربة الأمنية، يبقى تثبيت اتفاق وقْف إطلاق النار غير ممكن دون ترجمته إلى تحسينات ملموسة في حياة السكان في غزة؛ لذلك لا بُدَّ من إطلاق خطة إعمار وتنمية طويلة الأمد ترتكز على ربْط المساعدات الإنسانية ببرامج إنتاجية تُوفِّرُ فُرَص عمل مستدامة، وتُسهم في إعادة بناء الاقتصاد المحلي بشكل متكامل، ويتطلب ذلك تأسيس صندوق “دولي – عربي” مشترك لإعادة إعمار غزة، يخضع لإشراف مالي صارم وشفَّاف يضمن توجيه الموارد بشكل فعَّال بعيدًا عن الفساد أو التبديد، كما ينبغي أن يُرتبط ملف الإعمار بمسار سياسي واضح، يضمن رفْع الحصار المفروض على القطاع بشكل تدريجي، بالإضافة إلى تحقيق حرية الحركة للأفراد والبضائع عبْر المعابر؛ لأن استمرار القيود والحصار قد يُحوِّلُ المساعدات إلى أداة ضغط سياسي أو ابتزاز؛ مما يعرقل استقرار القطاع ويزيد من معاناة السكان، وهو أمر يتطلب تفادِيه لضمان نجاح العملية برُمَّتِها.
في هذا السياق، لا يمكن إغفال أهمية التنسيق الإقليمي والدولي الذي يضُمُّ دُولًا عربية مؤثرة، خاصَّة “مصر والسعودية وقطر” ومنظمات دولية؛ لتعزيز الدعم المالي والفني، ومتابعة تنفيذ برامج التنمية وإعادة الإعمار على الأرض.
خامسًا: متطلبات تثبيت الدور المصري وتعزيز التنسيق “العربي – الإقليمي”
يُشكِّلُ الدور المصري أحد الأعمدة الأساسية في هندسة اتفاق وقْف إطلاق النار في غزة وضمان تنفيذه؛ انطلاقًا من الموقع الجغرافي لمصر وصلاتها التاريخية والسياسية الوثيقة مع كافَّة الأطراف المعنية، إضافةً إلى خبرتها الطويلة في إدارة الملف الفلسطيني، خاصَّة خلال المحطَّات الحاسمة من الصراع “الفلسطيني – الإسرائيلي”، وقد جاءت التحرُّكات الدبلوماسية المُكثَّفة التي قادتها القاهرة منذ اندلاع الحرب؛ لتتوّج في نهاية المطاف بتوقيع اتفاق وقْف إطلاق النار في مدينة شرم الشيخ، بما منح مصر مكانةً محوريةً كـوسيط وضامن رئيسي لمسار التهدئة.
غير أن استدامة هذا الدور وتطويره، لا يمكن أن تتمَّ بمعزل عن مظلة تنسيق “إقليمي – عربي” داعمة، تتوزع من خلالها الأدوار وتُتقاسم الأعباء والمسؤوليات السياسية والميدانية، بما يوفر بيئة آمنة لتطبيق الاتفاق ويمنع محاولات الالتفاف عليه أو تقويضه.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى بناء آلية تنسيق فعَّالة تضم أطرافًا إقليمية فاعلة، مثل “مصر والسعودية وقطر وتركيا”؛ بحيث يُسهم كل طرف وفْق أدوات التأثير التي يمتلكها في دعْم مسارات الاتفاق، على النحو الآتي:
مصر: استمرارها كضامن أمني ومفاوض رئيسي للهُدْنة، والمسؤولة عن تنسيق المعابر ومتابعة البنود الميدانية.
السعودية: تتولَّى تأمين الغطاء السياسي العربي والدولي، خصوصًا في الأروقة الغربية، كما تلعب دورًا مهمًا في دعم جهود إعادة إعمار غزة، من خلال تقديم التمويل والمبادرات التنموية.
قطر: استمرار دورها في الوساطة لا سيما في ملفات تبادل الأسرى، وملف إعادة الإعمار، بما يضمن تسريع تنفيذ التعهُّدات الدولية.
تركيا: بصفتها طرفًا مُوقِّعًا على الاتفاق، تمتلك أنقرة إمكانيات لوجستية وإنسانية كبيرة، وعلاقات فاعلة مع الفصائل الفلسطينية والدول العربية؛ ما يؤهلها للعب دور مساند في تنفيذ الترتيبات الميدانية للاتفاق، كما يمكن أن تُسهم في تسهيل القنوات الخلفية بين الأطراف المعنية، ضمن إطارٍ داعمٍ للدور المصري ومُكمِّلٍ له.