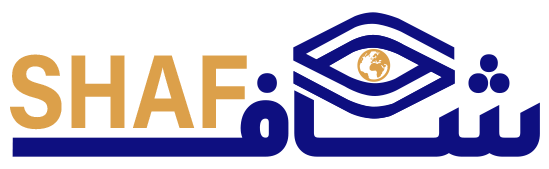المقالات
مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية > تقارير وملفات > الدراسات الأمنية والإرهاب > تحولات الوعي الجمعي: دور التعليم والثقافة في كسر دوائر التطرف والإرهاب
تحولات الوعي الجمعي: دور التعليم والثقافة في كسر دوائر التطرف والإرهاب
- مايو 1, 2025
- Posted by: Maram Akram
- Category: إصدارات دورية الدراسات الأمنية والإرهاب
لا توجد تعليقات

إعداد : إلهام النجار
باحث مساعد في برنامج الإرهاب والتطرف
إيمانًا بأهمية الدور والتثقيف السياسي لدى مراكز الفِكر البحثية، والمسئولية التي تقع على عاتقنا بأهمية نشر الوعي ، يُقدم “مركز شاف للدراسات المُستقبلية وتحليل الأزمات والصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا” هذه السلسلة التي تتضمن تقريرًا شهريًا عن التطرف والإرهاب، وكذلك تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة التي تم تصديرها من الغرب عن التطرف والإرهاب، وأن هذه المجموعة من التقارير المتنوعة تُسلط الضوء على العديد من العوامل والتأثيرات المُتعلِقة بجذور الإرهاب والتطرف، حيث يمثل التطرف العنيف والإرهاب أحد أبرز التهديدات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، بما يحمله من تداعيات أمنية، وسياسية، واقتصادية، وثقافية عميقة، وعلى الرغم من تعدد مقاربات التصدي لهذه الظاهرة، إلا أن التجربة التاريخية والبحث الأكاديمي أظهرا أن المعالجة الأمنية وحدها غير كافية، ما لم تواكبها جهود وقائية عميقة تُعنى بجذور التطرف ومسبباته البنيوية، وفي هذا السياق، تبرز أهمية التعليم والثقافة كخطين دفاعيين أساسيين ضد انتشار الفكر المتطرف، فالتعليم الذي يُعزز قيم التفكير النقدي، والتسامح، والمواطنة العالمية، يُعدّ أداة استراتيجية لبناء أفراد محصنين ضد خطابات الكراهية والعنف، كما أن الثقافة، بما تحمله من روايات متعددة وأشكال إبداعية متنوعة، تسهم في تنمية الخيال الأخلاقي والانفتاح على الآخر، مما يُقلل من قابلية التجنيد والاستقطاب.
وعليه، يناقش التقرير السابع، العلاقة بين التعليم والثقافة من جهة، وبين ظاهرة التطرف والإرهاب من جهة أخرى، مُستعرضًا محاور مثل العلاقة بين الجهل والتطرف، دور بناء الهوية المتعددة، أهمية تحفيز الخيال والانفتاح، تعزيز الذاكرة الجماعية، ومواجهة الأمية والفقر المعرفي كمدخلات أساسية للوقاية، ويختتم التقرير بجملة من التوصيات العملية الرامية إلى تفعيل دور التعليم والثقافة في تعزيز مجتمعات أكثر مناعة، وأكثر قدرة على مقاومة خطابات العنف والإقصاء.
أولًا: العلاقة بين الجهل والتطرف
يمكن توضيح العلاقة بين الجهل والتطرف من خلال الآتي:
1- الجهل كأرضية خصبة للتطرف
يُعد الجهل سواء أكان جهلًا دينيًا، سياسيًا، أو معرفيًا عامًا أحد أبرز العوامل التي تُستغل من قِبل الجماعات المتطرفة لتجنيد الأفراد، خصوصًا من فئة الشباب، فالجهل يُنتج عقلًا هشًا، سهل التأثير، غير قادر على التمييز بين الحقائق والدعاية أو على تحليل الخطاب المتطرف، حيث أن الجهل الديني يسمح بتشويه النصوص وتأويلها خارج سياقها الحقيقي، أما الجهل السياسي يؤدي إلى عدم فهم الواقع السياسي والاجتماعي، وبالتالي سهولة تبني نظريات المؤامرة، والجهل النقدي يمنع الإنسان من مساءلة ما يُعرض عليه من أفكار ومقولات.[1]
2- الأمية والفقر المعرفي كمحفزات للتجنيد
تشير دراسات ميدانية في مناطق النزاعات إلى أن الأميّة وانخفاض مستويات التعليم ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقابلية الأفراد للانخراط في جماعات متطرفة، حيث تُقدم هذه الجماعات نفسها كمصدر “للحقيقة والمعنى”، كما أن هناك دراسة صادرة عن البنك الدولي أظهرت أن ” المناطق التي تعاني من ضعف التعليم وانتشار الأمية لديها معدلات تجنيد أعلى في الجماعات المسلحة مقارنة بالمناطق المتعلمة” [2].
3- تفكيك الأسطورة – هل كل المتطرفين جهلة؟
رغم وجود ارتباط وثيق بين الجهل والتطرف، إلا أن هناك حالات شاذة لأشخاص متعلمين تورطوا في الإرهاب، وهذا يطرح سؤالًا مهمًا: هل المشكلة في مستوى التعليم أم في نوعية التعليم؟
حيث أن التعليم الأُحادي الذي يفتقر للتنوع والانفتاح الثقافي يمكن أن يُنتج متطرفين حتى لو كانوا من حاملي الشهادات العُليا، كما أن التعليم إذا لم يُرافق بوعي نقدي، قد يُستغل أيديولوجيًا.[3]
4- أهمية التعليم النقدي في مواجهة الجهل
التعليم الذي يُنمي مهارات التفكير التحليلي والنقاش المفتوح يُعتبر حاجزًا منيعًا أمام الخطابات المتطرفة، وهو ما يُميز بين التعليم كعملية “حشو معلومات”، والتعليم كـ”بناء وعي”.
ومن أبرز عناصر التعليم المقاوم للتطرف أن يوفر لمتلقيه:
تعزيز القدرة على الشك والتحليل.
فهم التاريخ والسياقات السياسية.
التعرف على الآخر المختلف دون شيطنته.
إشاعة ثقافة التساؤل بدلاً من التلقين.
5- الفرق بين الجهل الاصطلاحي والجهل السلوكي في فهم التطرف
لفهم العلاقة بين الجهل والتطرف بعمق، يجب التمييز بين الجهل الاصطلاحي والجهل السلوكي، وذلك كالتالي:
الجهل الاصطلاحي (المعرفي):
هو غياب المعلومات الأساسية أو نقص الفهم الصحيح للعلوم، الدين، السياسة، أو الواقع الاجتماعي، ويظهر هذا النوع في عدم القدرة على تحليل الخطاب الديني أو السياسي، تبني الأفكار المتطرفة دون تمحيص، والميل إلى التفسيرات السطحية أو المؤامراتية، على سبيل المثال، شاب لا يمتلك معرفة دقيقة بالإسلام، فيُضلل بخطاب يدّعي أن “الجهاد” يعني قتل المخالفين.
أما الجهل السلوكي (العملي):
هو ليس غيابًا للمعلومة بل عدم توظيفها في السلوك، فقد يمتلك الشخص معرفة تعليمية لكنه لا يمارسها أخلاقيًا أو اجتماعيًا، وهو أخطر، لأنه يخلق نوعًا من الانفصام بين الفكر والعمل، على سبيل المثال: خريج جامعة يتبنى سلوكًا متطرفًا رغم معرفته بالقيم الإنسانية أو القوانين.[4]
ويمكن القول، أن الجهل – بمختلف أشكاله – يُعد بيئة حاضنة للتطرف، لكنه ليس السبب الوحيد، فالمشكلة الأعمق تكمن في غياب التعليم الذي يُحصّن الفرد فكريًا وأخلاقيًا، ولهذا فإن مكافحته لا تتم فقط بمحاربة الأمية، بل بإعادة بناء نموذج تعليمي وثقافي شامل يعيد للوعي دوره المركزي في مواجهة الظلامية، كما أن الجهل لا يعني فقط غياب العلم، بل غياب المناعة الفكرية أمام خطاب التطرف، ومكافحة الجهل ليست مسألة تعليم أكاديمي فقط، بل مسألة استراتيجية وطنية لبناء جيل يملك أدوات الفهم، والشك، والنقاش، والعيش المشترك. فحين نضيء العقول، تنكسر سلاسل العنف.
ثانيًا: دور التعليم في تعزيز قيم التسامح والتعددية
التسامح هو احترام وقبول التنوع الثقافي والديني والسياسي، والاعتراف بحق الآخرين في الاختلاف، أما التعددية هي الإقرار بوجود تنوع مشروع داخل المجتمع في الآراء والمعتقدات والأنماط الثقافية والاجتماعية، ويُعد التعليم المنظم أحد أهم الأدوات لتنشئة الأفراد على هذه القيم، عبر المناهج، الأنشطة المدرسية، والتفاعل داخل البيئة التعليمية، كما أن التعليم من أجل التسامح هو الذي يوجه الأفراد نحو تقبل الآخر والتعايش معه بسلام، ويتطلب أكثر من مجرد نقل المعرفة بل بناء مواقف وقيم.[5]
كيف يعزز التعليم قيم التسامح والتعددية؟
1- عبر المناهج الدراسية:
وذلك من خلال تضمين قصص وتجارب من ثقافات وأديان مختلفة، وكذلك تعليم التاريخ من زوايا متعددة لخلق فهم أعمق للصراعات والتنوع، بالإضافة إلى تدريس مفاهيم مثل: حقوق الإنسان، العدالة، الحوار.
2- عبر تكوين المعلمين:
عبر تدريب المعلمين على توجيه النقاش داخل الصف بدون أحكام مسبقة، والتأكيد على احترام اختلاف الآراء داخل الفصول.
3- عبر الأنشطة اللامنهجية:
تنظيم رحلات وفعاليات تعرّف الطلاب بثقافات متعددة، وتشجيع العمل الجماعي المختلط بين خلفيات اجتماعية مختلفة.
4- عبر البيئة المدرسية نفسها:
غرس ثقافة احترام الرأي والرأي الآخر، والتعامل العادل مع كل الطلاب بغض النظر عن خلفياتهم.[6]
ومن أبرز التحديات أمام التعليم في ترسيخ هذه القيم
هيمنة الخطاب الأحادي في بعض المناهج التقليدية.
ضعف تدريب المعلمين على إدارة التعددية داخل الصف.
تسييس التعليم أو تديينه بطريقة تقصي الآخر المختلف.
غياب محتوى تفاعلي معاصر يناسب عقول الشباب اليوم[7].
ثالثًا: الثقافة كأداة للوقاية من التطرف
تُعد الثقافة حصنًا وقائيًا ناعمًا، يُعزز الانتماء والتنوع، ويواجه الخطاب المتطرف من جذوره، ولكن كيف تساهم الثقافة في الوقاية من التطرف؟ وذلك من خلال:
1- بناء الهوية المتعددة بدل الهوية الأحادية
حيث أن الثقافة تُعلّم الفرد أن يكون مسلمًا، وعربيًا، وإنسانيًا في آنٍ واحد، كما تساعد على دمج المكونات العِرقية والدينية داخل الهِوية الوطنية، حيث أن الهوية الأحادية هي نظرة للفرد تُختزل في عنصر واحد (الدين، العرق، اللغة، الطائفة)، وتُلغي باقي أبعاده الإنسانية والاجتماعية، أما الهوية المتعددة تعني الاعتراف بتعقيد الذات الإنسانية، واحتوائها لمكونات متعددة (ثقافية، دينية، وطنية، كونية) تتكامل دون أن تتصارع.
العلاقة بين الهوية الأحادية والتطرف
حيث أن التطرف يستند إلى هوية ضيقة ومنغلقة، مثل: “أنت مسلم فقط”، “أنت عربي فقط”، أو “أنت من طائفة كذا فقط”، هذا النوع من الهوية يُشعر الفرد بأنه مهدد دائمًا، ويغذي خطاب “نحن ضدهم”، أيضًا، سهولة التجييش والتعبئة، كما أن الجماعات المتطرفة تبني سردياتها على الهويات المنغلقة: “أنت مستهدف كمسلم”، “أنت ضحية كعربي”، مما يعزز الرغبة في الانتقام أو الانسحاب، بالإضافة إلى رفض الآخر المختلف، فحين يترسخ تصور “الهوية الوحيدة”، يصبح الآخر عدوًا بالضرورة، وليس شريكًا في الوطن أو الإنسانية[8].
كيف تسهم الهوية المتعددة في الوقاية من التطرف؟
وذلك من خلال التكامل لا الإقصاء،حيث يشعر الفرد أنه يستطيع أن يكون مسلمًا ومواطنًا وإنسانيًا دون تعارض، أيضًا المرونة النفسية والفكرية، التي تعزز قدرة الفرد على تقبّل التعدد والاختلاف، بالإضافة إلى المناعة الفكرية، التي تمنع انجراف الفرد نحو الجماعات التي تروّج لهوية ضيقة ومهددة، والتوازن الاجتماعي الذي يقلل من النزاعات الطائفية والعرقية، وتزيد من روح المواطنة المشتركة[9].
آليات بناء الهوية المتعددة
في التعليم: من خلال تدريس التاريخ من وجهات نظر مختلفة (وليس رواية رسمية واحدة)، وتعزيز قيم التعدد الثقافي والعرقي داخل الفصول الدراسية.
في الإعلام: من خلال عرض شخصيات نموذجية متنوعة تمثل الطيف الكامل للمجتمع، والتصدي لخطاب “الانتماء الأوحد” الذي يُقصي الآخرين.
في المؤسسات الدينية: من خلال نشر خطاب ديني يعترف بالتنوع في الخلق والاعتقاد (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة).
في السياسات العامة: من خلال الاعتراف بحقوق الأقليات، وإشراكها سياسيًا وثقافيًا، وسن قوانين ضد التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة[10].
2- تحفيز الخيال والانفتاح
عن طريق الأدب، السينما، والمسرح تفتح الأفق أمام الآخر المختلف، وأن الفن يُخرِج الإنسان من ثنائية “الخير المطلق/الشر المطلق” التي يروج لها المتطرفون، في المقابل، التطرف يغلق الخيال، ويختزل العالم في أبيض وأسود، ويُلغي إمكانات التنوع والتعاطف.
3- تعزيز الذاكرة الجماعية والسرديات البديلة
من خلال سرد قصص المقاومة السلمية والتعايش في التاريخ، وتقديم شخصيات ثقافية ملهمة (ابن رشد، نجيب محفوظ، الطاهر بن جلون).
أما العلاقة بين الذاكرة والتطرف
التطرف يُنتج ذاكرة انتقائية: يستدعي فترات من “المجد” أو “المظلومية” ويضخّمها خارج السياق، يقدم سردًا ثنائيًا: نحن الطاهرون – هم المعتدون.[11]
النسيان والتهميش يغذيان العنف: الجماعات التي تُقصى رواياتها من التاريخ الرسمي تشعر بالظلم وتسعى للانتقام أو الانفصال.[12]
السرد الموحّد يعمّق الانقسام: حين تحتكر الدولة أو جماعة معينة “رواية الأمة”، يتم إقصاء باقي المكونات (العرقية، الدينية، الجندرية)، مما يؤدي إلى راديكالية الأطراف[13].
4- خلق مساحات للحوار
تُشكّل الثقافة فضاءً للتعبير بدل العنف، وكذلك المنتديات الثقافية والمهرجانات تنشر التفاعل بدلاً من الصدام[14].
ومن أبرز التحديات أمام الثقافة في هذا الدور:
ضعف التمويل الرسمي للمشاريع الثقافية التوعوية.
استغلال بعض وسائل الإعلام للثقافة الشعبية بطريقة سطحية.
تهميش الفئات الهشة ثقافيًا في المناطق المهمشة.
الرقابة الفكرية التي تُصادر مساحات الإبداع والحوار[15].
رابعًا: الأمية والفقر المعرفي كمحفزات للتجنيد في الجماعات المتطرفة
كيف تسهم الأمية والفقر المعرفي في التجنيد؟
وذلك من خلال:
سهولة التلاعب بالخطاب الديني أو السياسي:
الأميون غالبًا ما يتلقون المعرفة من مصادر شفوية محدودة وغير محايدة، ويصبحون أكثر قابلية لتصديق “الفتاوى المتطرفة” أو نظريات المؤامرة.
غياب مهارات التفكير النقدي
الأفراد الذين يعانون من الفقر المعرفي يفتقرون إلى القدرة على التمييز بين المعلومة والدعاية، ما يجعلهم بيئة خصبة لتلقّي الخطاب المتطرف.
البحث عن “المعنى والانتماء”:
ومن يعاني من التهميش التعليمي يشعر غالبًا باللاجدوى، كما أن الجماعات المتطرفة توظف ذلك لتقديم بديل “مقدّس” يعيد له القيمة والدور الاجتماعي.
الاعتماد على رموز محلية غير واعية
في المجتمعات الفقيرة معرفيًا، تسود سُلطة “الشيوخ” و”الزعماء المحليين”، الذين قد يكونون أدوات تجنيد لا واعية.[16]
خامسًا: الفقر المعرفي لا يعني الجهل الكامل
حتى بعض الأفراد المتعلمين ينضمون للتطرف بسبب:
تخصص تعليمي ضيق (دون رؤية نقدية أو فكرية)
غياب الثقافة العامة أو المهارات الاجتماعية.
التعرض لإعلام موجه أو تعليمي مشوّه.[17]
سادسًا: التوصيات
ويمكن تسليط الضور وإبراز أهمها، كالتالي:
إصلاح المنظومة التعليمية لتعزيز قيم التعدد والتسامح.
تحديث المناهج التعليمية لتضم روايات تاريخية متعددة وثقافات متنوعة.
إدماج مفاهيم التربية على المواطنة، وحقوق الإنسان، والتفكير النقدي منذ المراحل المبكرة.
الاستثمار في الفنون والإبداع كوسائل للتعبير والوقاية.
دعم الأنشطة المسرحية والأدبية والبصرية في المدارس والمراكز المجتمعية.
تمويل مشاريع ثقافية تركز على نبذ الكراهية وبناء التماسك الاجتماعي.
تعزيز بناء الهوية المتعددة بدل الهوية الأحادية.
ترسيخ فكرة الانتماءات المركبة (الدينية، الوطنية، الإنسانية) كمصدر قوة لا تهديد.
تدريب المعلمين والإعلاميين على خطاب يقرّ بالاختلاف دون وصم.
محاربة الأمية والفقر المعرفي كأرضية خصبة للتطرف.
تنفيذ برامج محو الأمية المتكاملة في المناطق الهشة.
توفير فرص التعليم غير النظامي وبرامج التكوين المهني للشباب المحرومين.
إنشاء منصات لسرديات بديلة عن العنف والكراهية.
توثيق ونشر قصص الضحايا والناجين من الصراعات والتطرف.
إنتاج محتوى سردي مضاد للتجنيد العنيف على المنصات الرقمية.
تعزيز الثقافة التاريخية والذاكرة الجماعية التعددية.
إنشاء متاحف ومراكز ذاكرة تُعنى بالحقائق التاريخية المختلفة وتمنع احتكار الرواية.
إدماج شهادات وتجارب من كل فئات المجتمع في الخطاب العام والتربوي.
تنمية مهارات الخيال والانفتاح لدى الشباب.
إدراج مواد أدبية وفنية في المناهج تنمي المخيلة الأخلاقية.
تنظيم ورشات حوار بين الثقافات داخل المؤسسات التربوية والجامعية.
تمكين المجتمعات المحلية من إنتاج الثقافة ونشرها.
دعم الجمعيات والنوادي الثقافية على المستوى المحلي، خصوصًا في المناطق المهمّشة.
ضمان الوصول العادل للثقافة والفنون لجميع الفئات الاجتماعية.
تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
اعتماد مقاربة تشاركية بين وزارات التعليم، الثقافة، الشباب، والشؤون الدينية.
إشراك المنظمات الأهلية في تطوير برامج الوقاية من التطرف.
إجراء بحوث دورية حول العلاقة بين الثقافة، التعليم، والتطرف
تشجيع الجامعات والمراكز البحثية على رصد تحولات الخطاب المتطرف.
ربط نتائج الأبحاث بالسياسات التعليمية والثقافية العامة.