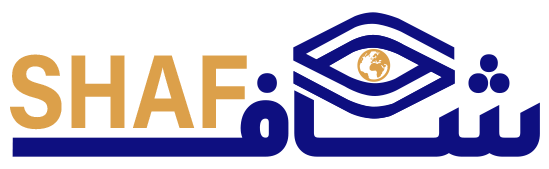المقالات
تسييس الجماعات العِرقية والإثنية وتأثيرها على مُستقبل الأمن الأفريقي
- أغسطس 31, 2025
- Posted by: ahmed
- Category: الدراسات الأمنية والإرهاب تقارير وملفات

إعداد: إلهام النجار
باحث في برنامج الإرهاب والتطرف
تُمثل الصراعاتُ العِرقيةُ والإثنية في أفريقيا أحد أبرز التحديات البنيوية التي تُعيق مسارات الاستقرار والتنمية، حيث تداخلت الهِوياتُ الضيقةُ والانقساماتُ الاجتماعية مع ضعف الدولة الحديثة لتفرز بيئة غير مستقرة، يسهل اختراقها من قِبلِ الجماعات المُسلحة والتنظيمات الإرهابية، وقد تحولت هذه الصراعات من نزاعاتٍ محليةٍ محدودةٍ بين جماعاتٍ إثنيةٍ أو قَبَليةٍ إلى صراعاتٍ مُركبة ذات أبعاد إقليمية ودولية، انعكست تداعياتها على الأمن القومي لدول القارة والأمن الجماعي الدولي على حدٍّ سواء، كما يُبرز هذا الإشكال بوضوح في أقاليم القرن الأفريقي الذي يشهد نزاعاتٍ متجذّرةً بين القوميات والطوائف مثل الصراع بين الأورومو والأمهرة في إثيوبيا، والساحل الإفريقي حيث تتفاقم المواجهات بين الفولاني والطوارق وغيرهم، وصولاً إلى الجنوب الأفريقي الذي لم يتعافَ بعد من إرْثِ التمييز العنصري وانعكاساته على العلاقات بين المجموعات السكانية، وقد ساهمت هذه الصراعات في إنتاجِ جماعاتٍ مسلحةٍ ذاتِ ميولٍ عِرقيةٍ وإثنية، تستغل الانقسامات العميقة لتجنيد الأفراد، وتبرير العنف، وفرض نفوذها في مناطق تعجز الدولة عن بسط سُلطتها فيها.
ومن جانبه، فإنّ خطورةَ هذه الظاهرة تكمُن في أنّها لا تقتصرُ على البُعد الأمني فحسب، بل تتشابك مع أبعاد سياسية واقتصاديةٍ وثقافيةٍ، حيث يؤدي التهميش الاجتماعي والتمييز العِرقي إلى إضعاف الثقة بين المواطن والدولة، ويمنحُ التنظيماتِ الإرهابيةَ بيئةً خِصبةً للتغلغل والتوسع، وبالتالي، فإن فَهم ديناميكيات هذه الصراعات يُعد مدخلاً أساسيًا لتفسير نشوء الحركات الإرهابية ذات الطابع العِرقي والإثني، ولصياغة استراتيجيات شاملة لمعالجتها.
وانطلاقًا من ذلك، يسعى هذا التقرير إلى تناول الصراعات العِرقية والإثنية في القرن الأفريقي والساحل الأفريقي والجنوب الأفريقي بالتحليل والتفصيل، مع إبراز تأثيراتها على مستقبل الأمن في القارة الأفريقية، و في إفراز جماعات إرهابية مُسلحة تتبنّى هوياتٍ ضيقةً، واستشراف التداعيات الأمنية المترتبة على هذه الظاهرة.
أولًا: ملامح عامّة تُفسِّر تسييس الانتماء العِرقي/العشائري في القرن الأفريقي
يُعدّ تسييسُ الانتماء العرقي والعشائري من أبرزَ السمات المميزة للمشهد السياسي والاجتماعي في القرن الإفريقي، حيث تتداخل البُنى التقليديةُ للهويات العِرقية مع غياب مؤسسات الدولة الحديثة وضعف قدرتها على إدارة التنوع، فبدلاً من أن يكون الانتماءُ العِرقيُ إطارًا ثقافيًا واجتماعيًا للتعايش، تحوّل إلى أداةٍ سياسيةٍ تُستخدم لحشْدِ الولاءات وتقسيم الموارد وممارسة النفوذ، ويعود ذلك إلى عدة عوامل تاريخية وبنيوية؛ أهمها الإرث الاستعماري الذي كرّس الحدود المصطنعة متجاهلاً تركيبة المجتمعات المحلية، إضافةً إلى هشاشة النظم السياسية المعاصرة التي عجزت عن بناء هِوية وطنية جامعة.
وفي ظل هذا السياق، أصبح العِرقُ والعشيرةُ وسيلةً للصراع على السُلطة والموارد، وأداة تعبئة رئيسية في النزاعات الداخلية، الأمرُ الذي أسهم في إدامة دوامة العنف وإضعاف فرص الاستقرار والتنمية في الإقليم، وهناك عِدة ملامح تفسر ذلك يمكن توضيحها من خلال الآتي:
هشاشة الدولة واختلاط الجغرافيا القبلية عبر الحدود: تمتدُ جماعات كبرى (الصوماليّون، العفر، الأورومو، الأمهره، التيغراي…) عبر حدود دولٍ حديثةِ التشكّل نسبيًا؛ ما يجعل النزاعاتِ محلية/عابرة للحدود في آن واحد، وتُظهر تقارير الإتحاد الأوروبي لشؤون اللجوء (EUAA) عن الصومال أن الهشاشة الأمنية تُدار عمليًا عبر شبكات العشيرة والحماية المحلية، وهو ما يُنتج فصائل مُسلّحة على خطوط قرابية/قبلية متغيرة. [1]
الاتحادية العِرقية في إثيوبيا: بنية سياسية تُعطي صدارةً للهوية القومية/الإثنية في التنظيم الفدرالي، ومع تعثّر الترتيبات الأمنية وتزاحم المطالب التاريخية، تبرز ميليشياتٌ محليةٌ ذات سردياتٍ عِرقية حادّة (الأورومو، الأمهره، التيغراي…) وهناك تحليلاتٌ تُحذّر من أن تصدّع الترتيبات الفدرالية يُعيد إنتاج العنف بهوية مُسيّسة. [2]
الضغوط المُناخية/المعيشية كسائق مضاعِف: مثّلت موجات الجفاف 2020–2023 في الصومال “مسرّعًا للنزاع” غذّى التجنيد وابتزاز المجتمعات من قِبل الفاعلين المسلّحين.
أنماط الانضمام إلى العنف المتطرّف في أفريقيا: التجارب السلبية مع الدولة (الاعتقال/العنف) وغياب الخدمات هي المحرّك الأبرز للالتحاق بالجماعات المتطرّفة، لا “التديّن” بحدّ ذاته، وهو ما يُفسّر كيف تتلوّن جماعاتُ العنف بلون الهِوية المحلية السائدة في مناطق التجنيد.[3]
ثانيًا: أبرز حالات تسييس الانتماء العِرقي
هناك عِدة حالات يمكن توضيحها كالتالي:
(أ) الصومال: تسييس العشيرة، و”تداخل” الشباب المجاهدين مع البُنى القبلية
رغم طابع “حركة الشباب” الأيديولوجي، فإن عملها اليومي يمرُّ عبر البنية العشائرية: تُوظّف آليات الوساطة وفرض “الجباية” ومجالس الشكاوى، وتستغلّ النزاعاتِ بين عشائر الوسط والجنوب لتثبيت حضورها، كما وثّقتْ تقاريرُ لجنة خبراء مجلس الأمن استمرار قدراتِ الحركة (ومجموعة “داعش–الصومال” في بونتلاند) مع تأثيرٍ مباشرٍ لانقساماتٍ محليةٍ كصراع لاسعانود ، كما يعتمد تقدّم الحكومة على تعبئة “مليشيات المَعَوِّسْلي” العشائرية في هيران/غلغدود، كما أن هذا التقدّم يتعثر كلما تراجعت التفاهمات العشائرية/المحلية أو مع احتدام الجفاف. [4]
وعليه، لا تُفرز العشائر “جماعةً إرهابيةً” بذاتها، لكنها توفّر سوقًا محليةً للشرعية/الحماية والتجنيد تُعيد تشكيل الشباب على خرائط قرابية، فيما تُنتج المواجهة المضادة مليشيات عشائرية مُسلحة بالهِوية.
(ب) إثيوبيا: من الحرب على التيغراي إلى “ترييف” العنف الإثني
تُجسّد إثيوبيا أحد أبرز النماذج في القرن الأفريقي لتحوّل النزاعات السياسيةِ إلى عنفٍ إثنيٍ معمّم، فقد شكّلت الحرب على إقليم التيغراي (2020–2022) لحظةَ انفجارٍ تاريخيٍ للصراع بين المركز وأحد أبرز المكونات القومية في البلاد، ما أدّى إلى إعادة إنتاج الانقسامات العِرقية على نطاقٍ واسع، ومع امتداد النزاع إلى أقاليم أخرى كأوروميا وأمهرا، دخلت إثيوبيا مرحلةً يمكن وصفها بـ “ترييف العنف الإثني”، حيث انتقل العنفُ من ساحاتِ القتال النظامية إلى القرى والأرياف، عبر مجازر محلية وهجماتٍ متبادلةٍ على أُسسٍ عرقيةٍ، هذا الترييف جعل النزاع أكثر تفككًا وخطورة، إذ لم يعُد مقتصرًا على صراعٍ سياسيٍ مع التيغراي، بل تحوّلَ إلى بنيةِ عنفٍ مجتمعٍي إثنيٍ تُهدد بتمزيق النسيج الوطني وتقويض مشروع الدولة الفيدرالية نفسه، ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي:
1- جيش تحرير أورومو (OLA/“شِنِّه: حركة ٌأورومية مُسلّحة تتبنّى خطابًا قوميًا أوروميًا، صنّفها البرلمان الإثيوبي جماعةً إرهابية في 2021، واستمرّت اشتباكاتها في أقاليم أوروميا وأطراف أمهرة/شوا.
2- ميليشيا فانو (الأمهريّة): تشكّلَت كقوةِ تعبئةٍ محليةٍ دعمت الجيش في حرب التيغراي، قبل أن تنقلبَ المواجهةُ بينها وبين الحكومة الفدرالية بعد 2023 في سياق صراع على الأمن المحلي والأراضي والتمثيل.
3- مخلّفات حرب التيغراي (2020–2022): وثّقت منظماتٌ حقوقيةٌ جرائم واسعةَ النطاق، بما فيها مشاركةُ قواتٍ إريتريةٍ وما رافقها من استهداف هويّاتي، على نحوٍ غذّى سرديات انتقام/حماية محلية في التيغراي وأمهرة وأوروميا. [5]
وعليه، يُعاد إنتاج الفعل المسلح على قاعدة “القومية الإقليمية” (أورومو/أمهرة/تيغراي)، مع تزاوج المطالب السياسية والحماية المحلية؛ فتظهر فصائل تُصنَّف إرهابية (OLA) وأخرى تمردًا إثنيًا مسلحًا (فانو) تتقاطع أحيانًا في سردية “الدفاع عن الجماعة”.
(ج) جيبوتي: أفار/عيسه وإرث FRUD
يُشير تقرير إلى أن جيبوتي –رغم استقرارها النسبي– ما تزال تشهدُ نشاطًا متقطعًا لفصيلٍ مسلّحٍ من جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية ذات الجذور الأفارية، مع بقاء الانقسام الإثني (أفار/عيسه) مُحرّكًا كامنًا للصراع وتسرّب العنف عبر حدود إثيوبيا (سِتّي) والصومال/أرض الصومال، سجّل التقرير هجوم تادجوره (أكتوبر/تشرين الأول 2022) كنموذجٍ لتجدّد العنف ذي القاعدة الإثنية، ولا تتغذّى FRUD على أيديولوجيا متطرفة، لكن على تظلماتٍ إثنية وأطراف حدودية مهمّشة؛ ما يرسّخ “عسكرة الهِوية” كبديل عن السياسة التوافقية.[6]
(د) إريتريا: قمعٌ بنيوي وتداخلٌ عابر للحدود
توصّف تقارير حقوقيةٌ دوليةٌ إريتريا كدولةٍ ذات تجنيد وطني إلزامي “مفتوح الأجل” وقمْعٍ منهجيٍ، مع استمرار توثيق انتهاكات خلال تدخل قواتها في حرب تيغراي، هذه البنية تُنتج “دفعًا للخارج” (لجوءًا وهجرة) وتوتّرًا هويّاتيًا على حدود التيغراي/العفر، يُغذّي عسكرة الفضاء الحدودي لدى الجوار. [7]
ثالثًا: آليات التحوّل من نزاع إثني إلى جماعات مُسلّحة “مُمَذْهَبة إثنيًا”
تُظهر تجاربُ العديد من دول أفريقيا والشرق الأوسط أنّ النزاعات الإثنية لا تبقى في حدودها الاجتماعية والسياسية فحسب، بل قد تتطورُ لتأخذَ شكلاً عسكريًا منظمًا عبر بروز جماعات مسلّحة تحمل هوية إثنية واضحة تؤثر على الأمن، ويعود هذا التحوّل إلى تفاعل مجموعة من الآليات المعقدة، أبرزها: التهميش السياسي والاقتصادي الذي يدفع المكوّناتِ العرقيةَ إلى البحث عن أدواتِ ضغطٍ تتجاوز الوسائل السلمية، وتسييس الهوية الإثنية من قِبل النُخبِ أو القوى الخارجية بهدف تعزيز النفوذ أو زعزعة الاستقرار، إضافةً إلى ضعف مؤسسات الدولة وعجزها عن احتكار أدوات العنف الشرعي، كما يلعبُ الخطابُ التعبوي دورًا محوريًا في تحويل المظلومية الإثنية إلى مشروع مقاومة مسلحة، غالبًا ما يرتبط بالسيطرة على الموارد الطبيعية أو الأراضي، أو السعي لتأسيسِ كيانٍ سياسٍي مستقلٍ، ومع مرور الوقت، تترسخ هذه الجماعات كفاعلٍ عسكريٍ ذي طابع “مُمَذْهَب إثنيًا”، ما يجعل النزاع أكثر تعقيدًا ويؤدي إلى إنتاج أنماط من العنف يصعب احتواؤها بالوسائل التقليدية، وبالتالي هناك عِدة آليات يمكن توضيحها كالتالي:
سردية الحِماية/الثأر: كلما ضعفت قدرة الدولة على بسْطِ العدل/الأمن، ارتفع الطلب المجتمعي على “حماية الجماعة” (العشيرة في الصومال؛ القومية الإقليمية في إثيوبيا)، فتملأه فصائل مسلّحة تُعيد تعريف الأمن كامتيازٍ هويّاتي.
اقتصاديات العنف والجباية: الجفاف والتهجير يُتيحان للجماعات فرض الجباية/الخدمات، ما يخلق تكاليف خروج مرتفعة للمجتمعات ويُرسّخ الولاء الهويّاتي، تظهر هذه الديناميكية بوضوح في صومال الوسط والجنوب.
شرعنة الدولة للهوية القتالية: عندما تُصنّف الدولة خصومًا إثنيين كـ”إرهابيين” أو تعتمد ميليشيات محلية، فإنها –ولو بهدف “إنفاذ القانون”– تُعيد إنتاج منطق السلاح بوصفه لغةَ السياسةِ داخل جماعات مُحددة هوياتيًا.
تجاوزات أمنية مُجذِّرة للتطرّف: تُظهر بيانات UNDP أن التجربةَ المباشرةَ مع عنف الدولة عامل حاسم في قرار الانضمام إلى جماعاتٍ متطرّفة؛ ما يفتح الباب أمام إعادة تسليح التظلمات العِرقية[8].
رابعًا: لماذا تُفضي النزاعات العِرقية في الساحل وغرب أفريقيا إلى جماعاتٍ مسلّحة؟
تُفضي النزاعات العِرقية في الساحل وغرب أفريقيا إلى بروز جماعاتٍ مسلّحةٍ لأن البيئة الإقليمية تتميّز بضعف الدولة المركزية، والهشاشة الأمنية، وتوزيع غير عادل للموارد بين المكوّنات السكانية، ففي ظل شعور جماعات إثنية كالفولاني، الطوارق، والدوجون بالتهميش السياسي والاقتصادي، تتحوّل الهويات العِرقية إلى أدوات تعبئة للدفاع عن المصالح والوجود، كما أن انتشارَ السلاح الخفيف، وغياب الثقة في مؤسسات الدولة، والتداخل مع شبكات تهريب عابرة للحدود، يسهّل انتقال النزاع من مجرد خلافٍ محليٍ إلى تشكيلاتٍ مسلّحة منظمة، وإلى جانب ذلك، تستغل الجماعات الإرهابية مثل “القاعدة” و”داعش” هذه التوترات لتجنيد أفراد من إثنيات مهمّشة، ما يعمّق ظاهرة “عسكرة الهوية” ويحوّل الصراعاتِ العرقيةَ إلى بؤرٍ دائمةٍ للعنف المسلح، وهُناك عِدة أسباب، وهي كالتالي:
هشاشة الدولة وتسييس “الأمن الأهلي”: عندما تتراجعُ قدرةُ الدولة على حماية المجتمعات الطرفية، ينشأ طلبٌ على “حماية الهوية” فيتحول الحُرّاس الأهليون إلى ميليشياتٍ تعكسُ خطوطَ الانقسام العِرقي (فولاني/دوغون/موسي/طوارق..). تحذّر تقارير OECD بعد موجة الانقلابات (2020–2023) من أن هذا المُناخَ سرّع اندماجَ الجهادية بالعنف الأهلي وأنتج تفاقمًا لعدم الاستقرار، لا العكس.
اقتصاديات الحرب والمُناخ: الجفاف، التهجير، والطرق غير الرسمية (ذهب، ماشية، تهريب) تُموّل فاعلين محليين يكتسبون شرعية بهوياتٍ محلية، ويستثمرها المتطرفون لاحقًا.[9]
مالي – مركز “التطييف”العنيف (موبيتي وسيغو وغاو)
تُعد مالي إحدى أكثر دول الساحل الأفريقي تأثرًا بظاهرة “التطييف العنيف”، حيث تحوّلت بعض مناطقها الوسطى والشمالية – مثل موبيتي وسيغو وغاو – إلى مسارحَ لصراعاتٍ إثنيةٍ مسلّحةٍ تتقاطع فيها المظالم المحلية مع الأجندات الجهادية العابرة للحدود، ففي موبيتي، تصاعد النزاع بين مزارعين من إثنية الدوجون ورعاة من الفولاني ليتحوّل إلى مواجهاتٍ مسلّحةٍ داميةٍ، أما سيغو، فتمثّلُ منطقة تماس بين الجماعات المحلية والدولة، ما جعلها بيئةً خِصبةً لتعبئة الهِويات العِرقية ضد السُلطة المركزية. وفي غاو، تداخلت مطالب الطوارق بالانفصال مع تمدد الحركات الجهادية، لتصبحَ رمزاً لعسكرة الهويات العرقية وتطييفها العنيف، وهكذا، شكّلت هذه المناطق مراكزَ أساسيةً لتحويل التوترات الاجتماعية والإثنية إلى نزاعات مُسلحة.
كتائب جهادية على قاعدة اجتماعية فولانية:
استثمرت جماعة “كتبية ماسينا” داخل تحالف JNIM تهميش رُعاة الفولاني وخطوط صراع الرُعاة–المزارعين لتتجذّر في الوسط، ثم توسّعت عبر “تسوياتٍ محلية” وحُكمٍ خدماتي موازٍ، وهناك دراسات حديثة توضح كيف تُعيد JNIM زرع نفسها اجتماعيًا عبر وسطاء محليين وهوية لغوية–معيشية مشتركة. [10]
ميليشيات إثنية مضادّة (دوغون/صيّادو الدوزو(:
برزت حركة دان نا أمباساغو (دوغون) بوصفها “حارس المجتمع”ضد JNIM/فولاني، لكنها انخرطت في هجماتٍ واسعة على المدنيين وعمليات تهجير انتقامية، ما غذّى حلقة العنف الإثني–المضاد.[11]
شمال مالي (الطوارق والدوسحاق والتحالفات المتقلبة:
تشكّلت ترتيبات محلية مثل GATIA وMSA “حرس محلي” ذي قاعدةٍ طوارقية/دوسحاق، في مواجهة داعش–الصحراء الكبرى (ISGS) وتحالفات القاعدة، وتداخل ذلك مع صراعات التهريب والسيطرة على المسارات الصحراوية. [12]
وعليه، تلاقت تعبئةٌ إثنيةٌ مضادّة (دوغون/طوارق/فولاني) مع حوكمة جهادية محلية لتشكّل “تشابكًا” بين العنف الأهلي والجهادي؛ ما يُعيد إنتاج الدورات الدموية على أساس الهوية.
بوركينا فاسو – من “حرس القرى” إلى عسكرة الهويّة
في بوركينا فاسو، شكّلت تجربة “حرس القرى” (Koglweogo) نقطةَ تحوّل في مسار الصراعات المحلية، حيث بدأت هذه الميليشيات كقوةٍ أهليةٍ غير رسميةٍ لحماية القرى من اللصوصية وضعف الدولة. غير أنّ توسّعها خارج نطاقها الأمني، وتحوّلها إلى فاعلٍ مسلّحٍ قائمٍ على أساسٍ إثني، ساهم في إعادة إنتاج الانقسامات العرقية وتعميقها، ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي:
المتطوعون للدفاع عن الوطن VDP وكوغلويغو:
أسست السُلطة ميليشيا VDP كقوة أهلية مسانِدة، فغدت لاعبًا مركزيًا في أمن الريف، لكن توثيق الانتهاكات أظهر استهدافًا جماعيًا لفولاني باعتبارهم “حاضنة” للمسلحين، ما فاقم الاصطفاف الإثني والتجنيد الانتقامي.[13]
موجات قتل إثني موثقة حديثًا:
وثّقت هيومن رايتس ووتش في مايو 2025 مجازر قادتها وحداتُ من الجيش وميليشياتٌ مواليةٌ، قُتل فيها أكثرُ من 130 مدنيًا –غالبيتُهم من الفولاني– في بُوقلي دو موهون؛ وأعقبتها هجماتٌ انتقاميةٌ لـJNIM ضد متعاونين مفترضين مع الحكومة، وأكدت تقارير القتل الجماعي على أُسُسٍ إثنيةٍ ودعت لفتْح تحقيقات[14].
تسييس “الأمن الأهلي” كمُولّد للتطرف:
يشيرُ تقرير هيومن رايتس ووتش 2025 عن بوركينا إلى أن مقاربةَ مكافحةِ التمرد القائمة على الميليشيات فاقمت الانتهاكات والعنف المجتمعي بدل احتوائه. [15]
وعليه، شرعنة الحرس الأهلي بدون ضوابط ومساءلة أنتجتْ عسكرة هوية (خصوصًا ضد الفولاني)، ومنحت الجماعات الجهادية مادةَ تعبئةٍ وانتقام محلي مستدام.
النيجر – عقدة الحدود والرعاة والمزارعين
قبل الانقلاب، حدَّت النيجر نسبيًا من الانزلاق إلى مذابحَ إثنيةٍ واسعةٍ مقارنةّ بجوارها عبر وساطات محلية، لكن تدهور العلاقات الأمنية بعد 2023 وانسحاب شركاء خارجيين رفع مخاطر “تطييف” العنف، بخاصة في تيلابيري والحدود مع مالي/بوركينا حيث تنشط ISGS/JNIM على خطوط رعاة–مزارعين وروابط فولانية–طوارقية عابرة.[16]
التمدد جنوبًا (بنين/توجو) بوصفه “تسريبًا للهويّات”
تمدد العنف من بوركينا/النيجر نحو بنين وتوجو رافقته تعبئةٌ محليةٌ حول مساراتِ الرعي والطرق الحرجية، ما يهدد بإعادة إنتاج الانقسام الهوياتي في مجتمعات لم تختبره بهذه الحِدة من قبل. [17]
كيف تتحوّل الهويّة إلى “وقودٍ” لجماعات مُسلحة؟
سردية الحماية/الثأر: عندما تُصوَّر جماعةٌ بعينها كخصمٍ هويّاتي (فولاني = “حاضنة الجهاد”) تتكوّن ميليشياتٌ مقابلةٌ (دوغون/موسي..) ثم تتوسعُ دائرة الاستهداف ضد المدنيين على أسس إثنية. (
الحوكمة الجهادية المُلائمة محليًا: توفر JNIM وISGS وسائل فضّ نزاعات/جباية وأمن طرق مقابل الولاء أو الحياد القسري، وتستندُ إلى وسطاءَ من نُخَبٍ محليةٍ (شيوخ رُعاة/وسطاء تجارة)، فيُعاد توصيف الصراع بوصفه “حماية الجماعة.
تسليح المدنيين بلا مساءلة: برامج الحرس الأهلي (VDP، كوغلويغو، دان نا أمباساغو) قلّصت المسافة بين الأمن العام والولاء الإثني وأطلقت دوائر انتقامية. (ACLED
الانقلابات وتسييس المجال الأمني: تُظهر OECD أن الانقلاباتِ عمّقت انكشافَ الدولة وحدّت من التنسيق الإقليمي، ما زادَ مساحةَ تحرّكِ الجهاديين وعمّق الرهانات الإثنية في الأطراف.
وعليه، في الساحل الأفريقي، لا تُنتِج الهويّة العِرقية العنف المتطرّف من تلقاء نفسها؛ بل تتفاعل مع انكشافٍ أمني، وتسليحٍ أهليٍ غير مُقنّن، ومظالم تاريخية وموارد نزاعية، وهذا أدّى إلى جماعاتٍ مسلّحة “مُمَذْهَبة إثنيًا” أو جهادية تتغذى على تلك الشروخ، وتقليل المخاطر يتطلّب حماية المدنيين ومساءلة صارمة، تفكيك منطق الميليشيات الأهلية، وتسويات محلية حسّاسة للهويّة مع حزم معيشية مخصصة للرعاة والمزارعين؛ وإلا فستستمر دورة “الأمن بالهوية”في إنتاج مزيدٍ من التطرف المسلّح.
خامسًا: الجنوب الأفريقي
الجنوب الإفريقي ليس كتلةً صراعيةً واحدة؛ فجنوبُ أفريقيا وبتسوانا ومالاوي وليسوتو مثلًا أقلّ عرضةً لنزاعاتٍ إثنيةٍ مسلّحة مقارنةً بموزمبيق وأنغولا وناميبيا، لكن إرثَ الحدود الاستعمارية، والتفاوتات الاقتصادية، وسياسات المحسوبية، وتنافس الموارد (غاز، نفط، ماس) وفَّرت «بيئة إعداد» لصراعٍ يتخذ أحيانًا صبغةً إثنيةً ثم يتقاطع لاحقًا مع أيديولوجياتٍ عابرة للحدود (جهادية مثلًا) أو قومية انفصالية.
(1) موزمبيق/كابو دلغادو: انقسام محلي يتقاطع مع “داعش”
في محافظة كابو دلغادو ظهر منذ 2017 تمرّد جماعة محلية تُعرَف بأسماء «أنصار السُّنة/الشباب» ثم بايعت “داعش “ولاية وسط أفريقيا/IS-Mozambique). مثّلت هياكل الانقسام المحلي – خاصةً بين جماعاتٍ ساحليةٍ مسلمة ناطقةٍ بالكِمْواني (المُواني/المَكْوِه) وبين جماعة الماكوندي ذات الحضور القوي في أجهزة الدولة – أرضيةً لفرز الولاءات والتعبئة، تُظهر أبحاث إريك مورييه-جونو وليازات بونات وآخرين أنّ البداية كانت محلية جدًّا، قبل الارتباط الدعائي/العملياتي مع داعش[18]
– ديناميات العنف والتجذّر: تقاطعت المظالم المرتبطة بالتهميش و«لعنة الموارد» (مشروعات الغاز الضخمة في بالما/موكيمبوا دا برايا) مع شبكات دعوية/تجارية محلية، فاستغلّ المتمرّدون بطالةَ الشباب والهوةَ بين المجتمع الساحلي والسلطة المركزية للتجنيد، تُوثّق تقارير الأزمات الدولية (ICG) و«كابو ليغادو/ACLED» هذا المسار وكيفية انتقال التمرّد بين الأحياء والقرى على خطوطٍ عِرقية/محلّية واضحة، مع استهداف متبادل بين مناطق تُرى «مؤيدة للحكومة» [19]
– التدويل والراهن الميداني: رُبطت الجماعة تنظيمياً وإعلامياً بـ«داعش» (ولاية وسط أفريقيا) بينما ظلّت شبكاتُها الاجتماعية محليةً إلى حدٍّ بعيد. وتُظهر تقارير الأمم المتحدة والمراقبين أنّ الارتباط بـ«داعش» عزّز القدرات، لكنه لم يُلغِ محركات الصراع المحلية. [20]
الحصيلة الإنسانية الراهنة: تصاعدت الهجمات مجدّدًا في يوليو 2025 ونتج عنها – خلال أسبوعين- نزوح نحو 60 ألف شخص من كابو دلغادو بحسب الأمم المتحدة، ما يُظهر دورة تجدد العنف برغم التدخلين الرواندي والإقليمي .[21]
وعليه، فإن المزج بين شروخ إثنية/محلّية (مُواني/ماكوندي/ماكوا)، وتهميشٍ تنموي، وتنافسٍ على عوائد الغاز، أفرز جماعةً مسلّحة ذات ميول محليّة واضحة، ثم «قُبِّلَت» دوليًّا ضمن سردية داعش. [22]
(2) أنغولا/إقليم كابيندا: انفصالٌ «جهوي-إثني» يفرز تمرّدًا مسلّحًا
كابيندا جيبٌ غنيّ بالنفط، له تاريخ إداري مغاير في الحُقبة البرتغالية، وتداخل إثني (فيوتي/باكونغو) مختلف عن «أنغولا المتصلة»، و منذ سبعينيات القرن الماضي تبنّت «جبهة تحرير جيب كابيندا» (FLEC) الكفاح المسلّح بمطالبَ انفصالية.
– أثر الانقسام الإثني/الجهوي: يرى باحثون أن سردية «هويةٍ مميّزة» لكابيندا غذّت القابلية للتعبئة المسلحة، كما غذّتها أيضًا اختلالات توزيعية لعوائد النفط، مع أنّ وتيرة العنف تراجعت قياسيًا، لا تزال فصائل من FLEC تُعلن عملياتٍ متقطعة وتُوسَم بالإرهاب من قِبل الدولة – وأشهر أحداث العنف هجوم يناير 2010 على حافلة منتخب توغو في كابيندا .[23]
(3) ناميبيا/إقليم كابريفي: نزعة لوْزية انفصالية انزلقت للإرهاب
في أغسطس 1999 شنَّت «جيش تحرير كابريفي» (CLA) هجماتٍ منسقة في كاتيما موليلو مطالبَةً بانفصال الشريط ذي الأغلبية اللوْزية وارتباطه التاريخي بباروتسيلاند، وصفت الحكومة الهجماتَ بـ«الإرهابية»، وانتهت إلى محاكمات طويلة. [24]
كما قامت الحركة على هويةٍ إثنية/إقليمية محددة (اللوْزي) وشعورٍ بالتهميش السياسي/التنموي قياسًا ببقية ناميبيا، ما يوافق أنماط «التعبئة الإثنية» التي قد تفرز تنظيمًا مسلّحًا عند تقاطع الهوية والحرمان النسبي.
(4) جنوب أفريقيا: العِرق كأيديولوجيا عنيفة (يمين أبيض متطرّف) ، تعبئة كارهة للأجانب
لا تزال جنوب أفريقيا تعكس التوظيف العنيف للعرق كأيديولوجيا سياسية واجتماعية، حيث يبرز من جهة اليمين الأبيض المتطرّف الذي يسعى للحفاظ على إرث الامتيازات العرقية عبر ميليشيات صغيرة وشبكات متشددة تتبنى خطاب العنف. ومن جهة أخرى، تتجلى ظاهرة التعبئة الكارهة للأجانب (Xenophobia) في المدن الكبرى، حيث يتم تحميل المهاجرين الأفارقة مسؤولية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ما يؤدي إلى هجمات جماعية عنيفة ضدهم. هذان البُعدان – العنصرية البيضاء المنظمة وكراهية الأجانب المعممة – يعكسان كيف يمكن للهوية العرقية والإثنية أن تتحول في جنوب أفريقيا إلى أداة للتعبئة العنيفة تهدد الاستقرار الداخلي وتعيد إنتاج منطق الإقصاء الذي ميّز حقبة الفصل العنصري، ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي:
جماعات إرهابية ذات بُعدٍ عِرقي ، ومنها:
بويرماخ (Boeremag): خلية يمين متطرّف (عِرق أبيض/هوية أفريكانر) نفّذت/خططت لسلسلة تفجيرات في 2002؛ أُدين قادتها وسُجنوا عام 2013.
– المقاومة المسيحية الوطنية/الصليبيون» (Crusaders/NCRM): تنظيم أبيض متطرّف خطّط في 2019 لهجماتٍ واسعة ضد السود ومؤسسات الدولة، وقائده «هاري كنوسِن» أُدين بموجب قانون مكافحة الإرهاب (POCDATARA) وحُكم عليه في سبتمبر 2022 بالسجن المؤبّد مرتين و21 عامًا إضافية، شرطة جنوب أفريقيا/الهاوكس هذه حالةٌ نموذجيةٌ على «إرهاب بدافعٍ عِرقي/عنصري. [25]
– تعبئاتٍ عنيفة ليست «إرهابية» لكنها مُسَيَّسة عِرقيًّا/أجنبيًّا:
تصاعدت منذ 2021 حملات vigilantism/xenophobia مثل «أوبريشن دودولا» التي استهدفت المهاجرين الأفارقة وارتبطت بوقائعَ عنفٍ وتهديد ٍوإن لم تُوصَف قانونًا بـ«الإرهاب»، القضية مهمّة لأنها تُظهرُ كيف توظّف الهويات (وطاردات «الأجنبي») لتعبئةٍ منظمة قد تنزلق لاحقًا إلى أنماط عنفٍ أشد2023. [26]
كيف تُنتِج الانقسامات الإثنية جماعاتٍ «إرهابية» في الجنوب الأفريقي؟
في الجنوب الأفريقي، ورغم حضور دولٍ قوية نسبيًا مقارنةً ببقية القارة، فإن الانقساماتِ الإثنية ما تزال تُستخدمُ كأداةٍ للتعبئة السياسية والاجتماعية، وتتحول في بعض السياقات إلى رافعة لتشكيل جماعات مسلّحة ذات طبيعة “إرهابية”. ففي موزمبيق، غذّت التهميشية الإثنية والدينية في شمال كابو ديلغادو صعود حركة “الشباب” المحلية، التي تبنّت خطابًا جهاديًا مع بُعدٍ إثنيٍ واضحٍ، وفي جنوب أفريقيا، شكّلت التعبئة العنيفة على أساس عرقي – سواء عبر الميليشيات اليمينية البيضاء أو عبر الهجمات الكارهة للأجانب – نمطًا آخر لتسييس الانتماء الإثني وتحويلهِ إلى ممارسةٍ عنيفةٍ منظمة. وهكذا، فإن الانقسام الإثني، حين يقترن بضعف الدولة وغياب العدالة الاجتماعية، يصبح بيئة خصبة لإنتاج جماعات مسلّحة تُوصَف بـ”الإرهابية”، تتجاوز كونها مجرد احتجاجات محلية إلى تهديدات إقليمية للأمن والاستقرار، ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي:
روّاد تعبئة «محلّيون»، وسردية مظلومية: قيادات محلية تستثمرُ إرثَ تمييز/تهميش (كابو دلغادو، كابريفي، كابيندا)، فتؤسّس ميليشيات «حماية مجتمع» تتحوّل لاحقًا لتنظيم مسلّح عابر للقرى، ومتى تلاقحت مع أيديولوجيا جهادية/عنصرية تتصلّبُ بنيةُ العنف وتتكثّف وحشيتُه .
لعنة الموارد» والزبائنية: شعور مجتمعاتٍ محليّة بأن ثرواتها (غاز/نفط/خشب/ياقوت) تُنتهَب من «الوافدين/المركز» يُغذي التجنيد المسلّح (كابو دلغادو، كابيندا).
التسييس الرسمي للهويات: تشكيل وحداتٍ محلّيةٍ مواليةٍ للدولة على أسس عشائرية/إثنية (ميليشيات ماكوندي في موزمبيق) يُعيد إنتاجَ «حرب هوّيات» ويمنح المتمرّدين سرديةَ «المدافع عن مجتمعٍ مُستبعَد .
روابطٌ عابرة للحدود تُضخّم الصراع: ارتباطات دَعَوية/مالية/دعائية مع شبكاتٍ جهادية أو دعمٍ من الشتات/الملاذات، تُحوِّل تمرّدًا محليًا إلى «فرعٍ» عابر.[27]
ختامًا:
يتضح مما سبق أنّ الصراعاتِ العِرقيةَ والإثنية في أقاليم القرن الأفريقي والساحل الأفريقي والجنوب الأفريقي لم تكنْ مجرد نزاعاتٍ محليةٍ أو صداماتٍ تقليديةٍ بين مكوّناتٍ مجتمعيةٍ متباينة، بل تحولت إلى بيئةٍ خِصبةٍ لإنتاج أنماط جديدة من العنف المنظم، وظهور جماعات إرهابية مُسلحة تتبنى خطابًا يقوم على استغلال الانقسامات العرقية والإثنية، لقد أسهمت هشاشة الدولة وضعْفُ مؤسساتها، إلى جانب التدخلات الإقليمية والدولية، في مفاقمة هذه الصراعات، مما جعلها تتجاوز بُعدَها المحلي لتتحولَ إلى تهديداتٍ مباشرةٍ للأمن الإقليمي والدولي.
كما إنّ الجماعات الإرهابية في هذه المناطق لم تنشأ بمعزلٍ عن السياق الاجتماعي والعرقي، بل استغلت التهميش والتمييز وانعدام العدالة الاجتماعية لتبرير خطابها وتوسيع قاعدتها الشعبية، وهكذا، أصبحت الصراعاتُ العرقيةُ والإثنيةُ ليست فقط سببًا مباشرًا في اندلاع العنف، وإنما محركاً لإعادة إنتاج الإرهاب بمختلف أشكاله، بدءًا من النزاعات الطائفية والقبلية وصولاً إلى الحروب الأيديولوجية العابرة للحدود.
وبناءً عليه، فإن معالجةَ هذه الظاهرة تتطلب مقاربةً شموليةً تدمجُ بين الأمن والتنمية والحوكمة الرشيدة، بما يضمن إدماجَ كافة المكونات العِرقية والإثنية في العملية السياسية، وتفعيل آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وتعزيز الدور الإقليمي والدولي في منْع تغذيةِ هذه الصراعات بالسلاح أو بالدعم الخارجي، كما أنّ التصدي لتمدّد الجماعات المسلحة ذات الطابع العرقي والإثني يستوجب تفكيكَ خطابها القائم على الهوية الضيقة، وبناء بدائل تنموية وثقافية تركّز على الهوية الوطنية الجامعة.
في النهاية، يمكن القول إنّ استقرار القارة الأفريقية لن يتحققَ ما لم تُعالجْ الجذور البنيوية للصراعات العرقية والإثنية، إذ إنّ تجاهلها يضمن استمرار َدائرةِ العنف والإرهاب، بينما التعاملُ معها بجدّيةٍ وعدالة يُشكل مدخلاً رئيسيًا لبناء سلامٍ مستدامٍ يُعزز الأمن الإقليمي والدولي.
المصادر:
[1]European Union Agency for Asylum ( 2025). “Somalia: Security Situation”. https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2025-06/2025_05_EUAA_COI_Report_Somalia_Security_Situation.pdf
[2] Crisis Group (2024 ).” The Islamic State in Somalia: Responding to an Evolving Threat”. https://www.crisisgroup.org/sites/default/files/2024-09/b201-isis-somalia.pdf?
[3]The BTI Transformation Index is a project of Bertelsmann Stiftung (2024). Djibouti Country Report 2024. https://bti-project.org/en/reports/country-report/DJI?utm
[4] Security Council United Nations (2023).” Report of the Security Council Committee pursuant to
resolution 2713 (2023) concerning Al-Shabaab”. https://docs.un.org/en/S/2024/997?utm
[5] Tirana Hassan(2023). Eritrea Events of 2023, Human Rights Watch. https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/eritrea?utm
[6] مرجع سابق.
[7] Amnesty International , Eritrea 2024, https://www.amnesty.org/en/location/africa/east-africa-the-horn-and-great-lakes/eritrea/report-eritrea/?utm
[8] European Union Agency for Asylum (EUAA),Country of Origin Information:Country of Origin Information: Somalia: Security Situation , https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2025-06/2025_05_EUAA_COI_Report_Somalia_Security_Situation.pdf?utm
[9]The global institute (2024).” From Crisis to Conflict: Climate Change and Violent Extremism in the Sahel “. https://institute.global/insights/geopolitics-and-security/from-crisis-to-conflict-climate-change-and-violent-extremism-in-the-sahel?utm
[10] The Journal of Illicit Economies and Development (2025).” Applying the Transplantation Framework to JNIM’s Expansion in the Sahara-Sahel: A Criminological Lens”. https://jied.lse.ac.uk/articles/10.31389/jied.253?utm
[11] Jalale Getachew Birru (2022).” Actor Profile: Dan Na Ambassagou”, ACLED. https://acleddata.com/report/actor-profile-dan-na-ambassagou?utm
[12] European Council on Foreign Relations.” The Islamic State in the Greater Sahara (ISGS)”. https://ecfr.eu/special/sahel_mapping/isgs?utm
[13] Jalale Getachew Birru (2024).” Volunteers for the Defense of the Homeland (VDP)”, ACLED. https://acleddata.com/profile/volunteers-defense-homeland-vdp?utm
[14] WILSON MCMAKIN (2025).” Burkina Faso forces killed at least 100 civilians in a March attack, Human Rights Watch says”, The Associated Press. https://apnews.com/article/burkina-faso-jnim-attack-junta-solenzo-vdp-40ad6f3fa27abf42aed1669cc067444c
[15] مرجع سابق.
[16] OECD (2024).” MILITARY COUPS, JIHADISM AND INSECURITY IN THE CENTRAL SAHE”. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/05/military-coups-jihadism-and-insecurity-in-the-central-sahel_4f7f928f/522f69f1-en.pdf?
[17] مرجع سابق.
[18] Liazzat J. K. Bonate & others (2024).” God, Grievance and Greed: War in Cabo Delgado, Mozambique”, SciELO. https://www.scielo.org.za/scielo.php?pid=S0259-01902024000100001&script=sci_arttext&utm
[19] Stig Jarle Hansen (2024).” Mosaic; counter-insurgency approaches and the war against the Islamic state in Mozambique”, Taylor & Francis online. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09592318.2024.2417134?utm_source
[20] United Nations (2025).” Monitoring Team Reports” , Security Council. https://main.un.org/securitycouncil/en/sanctions/1267/monitoring-team/reports
[21] ACCORD (2025).” Terminating Insurgency in Mozambique: Reflections on the SADC Mission In Mozambique”. https://www.accord.org.za/ajcr-issues/terminating-insurgency-in-mozambique-reflections-on-the-sadc-mission-in-mozambique/?utm
[22] Africa Center (2021). “Understanding the Origins of Violent Extremism in Cabo Delgado”. https://africacenter.org/programs/2021-10-understanding-origins-violent-extremism-cabo-delgado-mozambique/?utm
[23] Reuters (2010).” Angola rebels FLEC claim Togo football team attack”, https://www.reuters.com/article/markets/stocks/angola-rebels-flec-claim-togo-football-team-attack-idUSLDE60720Q/?utm
[24] Amnesty International (2021). “ Namibia: Justice delayed is justice denied – The Caprivi treason trial”. https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/afr420012003en.pdf?utm
[25] News24 (2022).” Right-wing leader Harry Knoesen found guilty of planning to overthrow the government”, https://www.news24.com/southafrica/news/right-wing-leader-harry-knoesen-found-guilty-of-planning-to-overthrow-the-government-20220606?utm
[26] مرجع سابق.
[27] Emilia Columbo (2023).” The Enduring Counterterrorism Challenge in Mozambique”, Volume 16, Issue 3. https://ctc.westpoint.edu/the-enduring-counterterrorism-challenge-in-mozambique/?utm_source