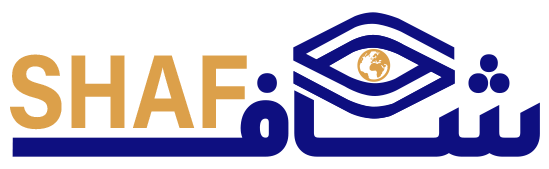المقالات
مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية > تقارير وملفات > الدراسات الأمنية والإرهاب > تصاعد النشاط المُسلح للجماعات المتطرفة في الإقليم الحدودي الأفغاني–الباكستاني
تصاعد النشاط المُسلح للجماعات المتطرفة في الإقليم الحدودي الأفغاني–الباكستاني
- نوفمبر 12, 2025
- Posted by: Maram Akram
- Category: الدراسات الأمنية والإرهاب تقارير وملفات
لا توجد تعليقات

إعداد: إلهام النجار
باحث في برنامج الأمن والإرهاب
يشهدُ الإقليم الآسيوي، وتحديدًا منطقة الحدود الأفغانية – الباكستانية، تصاعدًا متسارعًا في مظاهر عدم الاستقرار منذ عام 2021، عقِب عودة حركة طالبان إلى الحُكم في كابل، وما تَبِعَ ذلك من تحولاتٍ عميقةٍ في خريطة التوازنات الأمنية والاستراتيجية بجنوب آسيا، فقد أفرز هذا التحول بيئةً مضطربةً أعادت إحياء نشاط الجماعات المسلحة، وعلى رأسها تنظيمُ داعش – ولاية خراسان وحركة طالبان باكستان (TTP)، اللذين وجدا في هشاشة الحدود وغياب التنسيق الأمني بين الدولتين فرصةً لتوسيع نفوذهما وتنفيذ هجماتهما عبر الإقليم. وتحوّل الصراع بين أفغانستان وباكستان من مجرد خلافاتٍ حدوديةٍ أو سياسيةٍ إلى حالةٍ من التصعيد الأمني المركّب، تتشابك فيها الأبعاد الجيوسياسية والأيديولوجية والاقتصادية، وتغذّيها التوترات التاريخية حول “خط دوراند” والمواقف المتباينة من الجماعات المتطرفة. كما أسهمت عوامل أخرى، مثل ضعْف الحوكمة، وانتشار الفقر والبطالة، وتراجع دور المجتمع الدولي بعد الانسحاب الغربي من أفغانستان، في تعميق دوامة العنف وتعقيد مسارات الحل.
وفي ظل هذا المشهد، لم يعدْ الصراعُ محصورًا في نطاقه الجغرافي الضيّق، بل أصبح تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، لما يحمله من تداعياتٍ إنسانيةٍ خطيرةٍ، واحتمالاتٍ لانفجار نزاعات أوسع تتجاوز حدود الدولتين. لذا يسعى هذا التقرير إلى تحليل أبعاد الأزمة الراهنة من خلال تناول الفاعلين الرئيسيين ودورهم في التصعيد، واستعراض أسباب الصراع وآلياته، ثم تقييم تأثيراته الإنسانية والاستراتيجية.
أولًا: الفاعلون الرئيسيون
يُشكّل كلٌّ من تنظيم داعش – ولاية خراسان وطالبان باكستان (TTP) وحركة طالبان الحاكمة في أفغانستان أبرز الفاعلين الرئيسيين في مشهد الصراع الراهن بين أفغانستان وباكستان، إذ تتقاطع مصالحهم الأيديولوجية والأمنية في مناطق الحدود الوعرة، ويمكن توضيح أ برز الفاعلين من خلال الآتي:
1- داعش – ولاية خراسان (ISIS-K): فرع جهادي مستقلب من التنظيم الأم، يتميّز بعملياتٍ انتحاريةٍ وهجماتٍ على أهدافٍ مدنيةٍ ورسميّة داخل أفغانستان ومن ثمَّ تهديدات أو ضربات عبر الحدود. لا يزال داعش-خراسان يملك قدرةً على شنّ هجماتٍ سريعة وعنيفة رغم فقدانه «دولة» تقليدية[1].
2- تيار/طالبان باكستان (TTP): شبكات مقاتلة باكستانية أعادت تنظيم نفسها بعد 2020، وزادت هجماتها داخل باكستان بعد تفلّت الملاذات في المناطق الحدودية. تقترب أحيانًا من علاجاتٍ تنظيميةٍ وتنسيقٍ محدود مع جماعات إقليمية أخرى. [2]
3- طالبان-أفغانستان (حكومة كابل الحالية): رسميًا تؤكد الحكومة أنّها لا تدعم هجمات ضد باكستان، لكن قدراتها على السيطرة الفعلية على كلّ جماعات المُقاتِلين في أراضيها محدودة، خاصةً في المناطق الحدودية النائية. هذا خلّف قيودًا على قدرة كابل على تهدئة إسلام آباد. [3]
4- السُلطات الباكستانية والعسكرية: اتّبعت سياساتٍ عسكريةً وأمنيةً تتراوح بين الضربات الجوية، عمليات داخل أراضيها، وادعاءات عن استخدام أراضي أفغانستان كمخبأٍ من قِبل المجموعات المقاتلة. [4]
ثانيًا: دلائل وتطورات تصاعد النشاط
بعد سيطرة طالبان على كابل في منتصف 2021، شهدتْ المنطقة الحدودية موجاتٍ من التحركات وإعادة تموضع مجموعاتٍ مسلحةٍ؛ بعضها استفاد من فراغ السُلطة المحلية، وتوضيح ذلك من خلال الآتي:
2023–2024: تصاعدُ هجماتِ داعش-خراسان داخل أفغانستان واستهدافه لرموز وعمّال مدنيين ودبلوماسيين وسياح.
2024–2025: عودةُ نشاطٍ مكثف لـTTP وارتفاع عدد هجماته داخل باكستان، مع مزاعم باكستانية متكررة بأن مقاتلي TTP ينسّقون أو يجدون ملاذاً عبر الحدود. هذا أدّى إلى حوادث تبادل نيران وضربات عبر الحدود.
خريف 2025 (أكتوبر): تصاعدُ المواجهات والأسئلة حول حماية المدنيين، ودعوات أممية لوقف الأعمال العسكرية عبر الحدود. [5]
ثالثًا: أسباب التصعيد
تعود أسباب التصعيد بين أفغانستان وباكستان إلى تداخل العوامل الأمنية والسياسية، حيث أسهمتْ الملاذاتُ الحدودية للجماعات المسلحة وضعْفُ السيطرة الحكومية في تفجير التوتر. كما أدّت الاتهامات المتبادلة بدعم الإرهاب والتنافس الإقليمي على النفوذ إلى تعميق أزمة الثقة وتصعيد المواجهات بين الطرفين، ويمكن توضيح أبرز هذه الأسباب من خلال الآتي:
1- ملاذاتٌ آمنة وقيودٌ على سُلطة الحكومة المركزية: ضعف النفوذ الحكومي في بعض محافظات شرقي وجنوب-شرقي أفغانستان سمح بوجود قواعد أو تحركات لعناصر TTP وخلخلة قدرات الدولة على إنفاذ القانون.
2- تداخلُ الأجندات الإقليمية: استخدام صراعات النفوذ الإقليمي (اتهامات متبادلة عن دعم أو تساهل مع جماعات مسلّحة) زادَ من درجة العداء السياسي بين كابل وإسلام آباد، مما أدّى إلى ردود فعلٍ عسكريةٍ أو دبلوماسيةٍ حادة.
3- التنافس الأيديولوجي والتجنيد: داعش-خراسان يقدّم نموذجَ تجنيد متشدد وميلاً للسيطرة الإعلامية بعملياتٍ صادمةٍ لجذْبِ المقاتلين؛ في المقابل بعض فصائل TTP تستفيد من سخطٍ محليٍ تجاه السياسات الباكستانية. هذا التداخل يضخّ عناصر عنف جديدة في المنطقة. [6]
4- اقتصاد الحرب والأنشطة المُرافقة: تهريب، شبكات تهريب مخدرات، وموارد محلية تغذّي قدرةَ الجماعات على الاستمرار والتموضع. العمليات الاقتصادية غير القانونية تُسهِم في شرعنة استمرار العنف. [7]
5- تداعيات انسحاب/تغيّر الدور الدولي: تغيّر توازن القوى بعد انتهاء الانتشار الأجنبي في أفغانستان زاد من قدرة بعض الفصائل المحلية والعابرة للحدود على إعادة البناء.
رابعًا: الآليات التي تُغذّي الصراع بين الدولتين
يتغذّى الصراع بين الدولتين عبر مجموعةٍ من الآليات المتداخلة التي تتشابك فيها الأبعادُ الأمنية والسياسيةُ والاقتصادية والاجتماعية، وتُسهم في استمرار حالة العداء وانعدامِ الثقة، على النحو الآتي:
1- العمليات العسكرية المتبادلة عبر الحدود:
تعدّ الضرباتُ الجويةُ والمدفعية التي تنفّذها باكستان داخل الأراضي الأفغانية، بحُجة استهداف مقاتلي طالبان باكستان (TTP)، من أبرز العوامل المحفزة للصراع، إذ تردّ طالبان الأفغانية باتهام إسلام آباد بانتهاك السيادة الوطنية. هذا التبادلُ العسكري يُفاقم التوتر ويؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين، مما يُزيد من تأزيم العلاقات الثنائية.[8]
2- الملاذات الآمنة وضعف ضبط الحدود:
تُشكّل المناطق الجبلية الوعرة على طول خط دوراند بيئةً مثاليةً لتمَركز الجماعات المسلحة، سواء داعش – ولاية خراسان أو TTP، في ظل غيابِ رقابةٍ أمنيةٍ فعالةٍ من الجانبين. وقد أشار تقرير مجموعة الأزمات الدولية إلى أن ضعف التنسيق الأمني الحدودي يسمح بتسلل المقاتلين وتنفيذ الهجمات داخل باكستان ثم العودة إلى أفغانستان دون ملاحقة، وهو ما تراه إسلام آباد دليلاً على “تواطؤ” سلطات كابل.[9]
3- الخطاب الإعلامي المتبادل والتحريض السياسي:
تستخدم كل من الحكومتين خطابًا إعلاميًا يحمّلُ الآخر مسؤوليةَ الانفلات الأمني، ما يخلقُ بيئةً عدائيةً في الرأي العام تُعيق أي تقارب دبلوماسي. وتؤكد دراسة المعهد الباكستاني للدراسات الاستراتيجية أن الحملات الإعلامية المتبادلة تُغذي النزعة القومية والدينية، وتُبرر استمرار السياسات التصعيدية[10].
4- غياب القنوات الدبلوماسية الفعالة:
تراجعُ الحوار الثنائي بعد استيلاء طالبان على السُلطة في كابل عام 2021، إذ أُغلقت قنوات التنسيق الأمني السابقة وتراجعت الاجتماعات المشتركة. وقد ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن انقطاعَ التواصل الرسمي يُسهم في سوء الفهم وتضخيمِ الأحداث الميدانية البسيطة إلى أزمات حقيقية.[11]
5- الضغوط الاقتصادية واللاجئون:
يشكّل ملف اللاجئين الأفغان في باكستان أحد أبرز مصادر التوتر، خاصةً مع قرار الحكومة الباكستانية في عام 2025 ترحيل مئات الآلاف منهم، ما أثار انتقاداتٍ من كابل والمنظمات الدولية. ووفقًا لتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن هذا الإجراء أدّى إلى توتراتٍ إنسانيةٍ وسياسيةٍ عمّقت أزمة الثقة بين البلدين.[12]
6- التداخل بين الجماعات الإرهابية والإجرامية:
تشير دراسات مركز مكافحة الإرهاب في وست بوينت إلى أن شبكات الإرهاب والتهريب والاتّجار بالمخدرات تتقاطع مصالحها في تلك المنطقة، ما يجعلها طرفًا مستفيدًا من استمرار الصراع، حيث تؤمّن هذه الفوضى بيئةً خِصبةً لتمويل عملياتها واستقطاب عناصر جديدة.[13]
وعليه، إنّ استمرار هذه الآليات وتفاعلها – بين الفعل العسكري وردّ الفعل السياسي، والاتهامات المتبادلة، وغياب التنسيق الأمني والدبلوماسي – يجعل الصراع بين أفغانستان وباكستان حالةً مزمنةً يصعب احتواؤها دون تدخلاتٍ إقليميةٍ ودوليةٍ متوازنةٍ، تعتمد على تعزيز الثقة وبناء آلية مشتركة لمراقبة الحدود ومكافحة الجماعات العابرة لها .[14]
خامسًا: تداعيات قائمة
يشهدُ الصراع بين أفغانستان وباكستان تصاعدًا خطيرًا في آثاره الإنسانية والاستراتيجية، حيث تتجاوز تداعياته حدود النزاع الأمني إلى أبعادٍ تمسّ الاستقرار الإقليمي والمجتمعي في جنوب آسيا. ويمكن تحليل أبرز هذه التأثيرات كما يلي:
1- الخسائر البشرية وتدهور الأوضاع الإنسانية:
أدت العمليات العسكرية المتبادلة والهجمات التي تشنّها الجماعات المسلحة – خاصة داعش- خراسان وطالبان باكستان (TTP) إلى ارتفاع أعداد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، خصوصاً في ولايات ننغرهار وخوست الأفغانية، ومناطق خيبر بختونخوا الباكستانية. وأشارت تقارير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إلى أن عام 2024 شهد زيادة بنسبة 20% في الخسائر المدنية مقارنةً بعام 2023، بسبب الغارات الحدودية والقصف العشوائي. كما أن أغلب الضحايا من النساء والأطفال نتيجة استهداف القرى الحدودية دون تمييز.[15]
2- أزمة اللاجئين والنزوح القسري:
أدّى تصاعد التوتر إلى تفاقم أزمة اللاجئين بين البلدين، إذ استقبلت باكستان ما يزيد على 1.7 مليون لاجئ أفغاني، ثم أعلنت عام 2025 عن خطةٍ لترحيل أعدادٍ كبيرةٍ منهم بدعوى المخاوف الأمنية. وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن عمليات الترحيل القسري أسفرتْ عن أزمةٍ إنسانيةٍ في معابر سبين بولدك وتورخام، حيث افتقرت العائلات العائدة للمأوى والخدمات الأساسية. [16]
3- الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية:
تسبّبت حالة عدم الاستقرار الأمني في تعطيل حركة التجارة الحدودية، وإغلاق العديد من المعابر الحيوية، مما أثّر سلبًا على الاقتصاد المحلي في البلدين، خاصةً في المناطق الفقيرة المعتمدة على التجارة غير الرسمية. ووفقًا لتقرير مجموعة الأزمات الدولية، فإن خسائرَ الاقتصاد الحدودي في البلدين تجاوزت 2 مليار دولار سنوياً نتيجة القيود الأمنية والتوتر المستمر. هذا الانكماش الاقتصادي زادَ من معدّلاتِ البطالة، وأوجدَ بيئةً خصبةً لتجنيد الشباب في الجماعات المسلحة.[17]
4- تدهور العلاقات الدبلوماسية والإقليمية:
أثّر الصراع سلبًا على جهود التعاون الإقليمي، إذ تعطّلت مشروعاتُ الربط الاقتصادي والطاقة بين آسيا الوسطى وجنوبها مثل مشروع “TAPI” للغاز، بسبب تدهور الثقة بين كابل وإسلام آباد. وأشار تقرير المعهد الباكستاني للدراسات الاستراتيجية إلى أن تزايدَ الهجمات الحدودية قوّضَ أي مساعٍ لإعادة بناء العلاقات السياسية، وفتْحِ الباب لتدخّلاتِ أطرافٍ خارجيةٍ تستغل الانقسام.[18]
5- تهديد الأمن الإقليمي والدولي:
يمثّل استمرارُ نشاط داعش – خراسان وطالبان باكستان تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي، حيث قد تتحول المناطق الحدودية إلى بؤرةِ انطلاقٍ لعملياتٍ ضد مصالح دول الجوار، خصوصًا الصين وإيران، كما أن تصاعد النشاط الإرهابي في المنطقة يُعيد رسْمَ خريطة التهديدات العالمية، ويجعل من باكستان وأفغانستان مركزًا محتملاً لإعادة إحياء التنظيمات العابرة للحدود.كما أن غياب التنسيق بين البلدين يفتح المجال أمام تمدد الإرهاب نحو آسيا الوسطى.[19]
6- تآكل الشرعية السياسية وتراجع الثقة الشعبية:
أدّت الأزمات المتكررة إلى تآكل ثقةِ المواطنين في قدرة الحكومتين على تحقيق الأمن أو تحسين المعيشة. وتشير دراسة جامعة كابل للعلوم السياسية إلى أن استمرارَ العنف عزّز من نفوذ الجماعات الدينية المتشددة داخل المجتمعات المحلية، ما يهدد مستقبل الاستقرار الداخلي لكلا البلدين.[20]
وعليه، إن التأثيراتِ الإنسانيةَ والاستراتيجية للصراع بين أفغانستان وباكستان تتجاوز المعاناة الميدانية إلى تهديد البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلدين، وتفتح المجال لتدويل الأزمة ما لم يُتَّخذ مسارٌ ٌشاملٌ يجمع بين الأمن والتنمية والدبلوماسية الوقائية
سادسًا: توصيات عملية
تعزيز قنوات التواصل المباشرة بين حكومتي إسلام آباد وكابل لفتْح آليات تحقيقٍ مشتركةٍ في الحوادث الأمنية وتجنّب ردود فعل أحادية مدمّرة.
مبادرات رقابية/ميدانية دولية أو إقليمية (مثلاً بعثات رصد أممية/إقليمية) للتحقق من حوادث عبور الحدود وتقليل فرص التصعيد.
مكافحةُ شبكاتِ التمويل والتهريب عبر تعاون استخباري إقليمي يقطع موارد الجماعات المسلحة.
برامجُ مصالحةٍ محلية وتأهيل بدائل للشباب في المناطق الحدودية (عمل تنموي وتوظيفي) يقلل من قنوات التجنيد.
استراتيجية لمحاصرة الفضاء الأيديولوجي عبر دعم مجتمعاتٍ مدنيةٍ وإعلاميةٍ محلية تعمل على رفض العنف والتطرف.