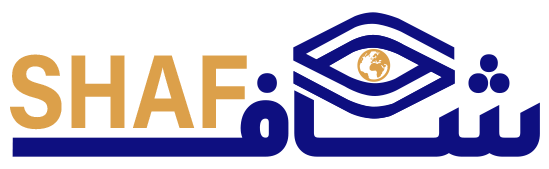المقالات
مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية > تقارير وملفات > وحدة الشرق الأوسط > رؤية نقدية لدراسة بعنوان: Middle East Unrest Clouds Future of Israel-Egypt Gas Deal
رؤية نقدية لدراسة بعنوان: Middle East Unrest Clouds Future of Israel-Egypt Gas Deal
- سبتمبر 23, 2025
- Posted by: Maram Akram
- Category: تقارير وملفات وحدة الشرق الأوسط
لا توجد تعليقات

إعداد: دينا دومه
باحث مساعد في وحدة شؤون الشرق الأوسط
في خضمّ التحوّلات الجيوسياسية الجذرية التي تُعيد تشكيل خرائط النفوذ والمصالح في منطقة الشرق الأوسط، برزت الطاقة بوصفها مُتغيّرًا مركزيًا يُحرّك ديناميكيات الصراع والتعاون، لقد أصبح الترابط بين أمن الموارد الهيدروكربونية واستراتيجيات القوى الإقليمية إطارًا إبستمولوجيًا (معرفيًا) جديدًا لفهم طبيعة العلاقات الدولية، حيث لم تعد المسائل الاقتصادية بمعزلٍ عن الاعتبارات السيادية والأمنية.
وفي هذا السياق، تُعدّ الشراكة الغازية بين جمهورية مصر العربية ودولةِ إسرائيل حالةً بحثيةً فريدةً ولافتةً؛ ليس لكونها نموذجًا للتعاون الاقتصادي العابر للحدود فحسب، بل لأنها تُمثّل مُؤشرًا دقيقًا(Bellwether) يدل على مدى تداخل المصالح الاقتصادية مع الاعتبارات السياسية والأمنية، غير أنّ الحرب الإسرائيلية في غزة المُستمرة الآن أظهرت مدى تأثّرِ هذه الشراكة بالتطورات الإقليمية، ما يجعلها مرهونةً بقدرة الأطراف على المُوازنة بين ضرورات التعاون الاقتصادي وضغوط السياق السياسي المُتأزم، ومن هذا المُنطلق، يأتي هذا التقرير النقدي ليقدّم تحليلًا مُعمّقًا لإحدى الدراسات البارزة في هذا المجال، وهي دراسة: «اضطرابات الشرق الأوسط تلقي بظلالها على مستقبل صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر» [1](Middle East Unrest Clouds Future of Israel-Egypt Gas Deal)، للكاتب John Zadeh“ “، التي نُشرت على موقع “Discovery Alert” بتاريخ 10 سبتمبر2025 ، وهو منصة تحليلية تُعنى بمتابعة التحولات الاقتصادية والسياسية في العالم، مع تركيز خاص على قضايا الطاقة والاستراتيجيات الجيوسياسية في مناطق النزاعات والتوتر.
تهدف هذه الرؤية النقدية إلى تفكيك البُنى التحليلية التي قامت عليها الدراسة المُشار إليها، وذلك من خلال تقييم فرضياتها ومساهمتها في فهم المشهد الطاقي الراهن. وتعتمد على منهج تحليلي نقدي يضع الدراسة قيد التقييم الشامل وفق المحاور التالية:
1- فهْمُ خلفية الكاتب الأكاديمية والمنهج المتّبع: تحليل الخلفية الفكرية والأكاديمية للكاتب، وبيان المنهجية التي اعتمدها في صياغة أفكاره وحججه.
2- عرضُ أفكار وحجج الدراسة: تلخيص الأطروحة الرئيسة للدراسة، وعرض أبرز الأفكار والحجج التي استند إليها الكاتب في تدعيم استنتاجاته.
3- نقاط القوة: تسليط الضوء على الجوانب المنهجية والتحليلية التي تميّز الدراسة وتُعزّز من قيمتها العلمية.
4- أوجْهُ القصور والضعف: تقديم نقد بنّاء لمواطن القصور في التحليل، والثغرات في الحجج، وأي إغفال لعوامل مؤثرة قد يُقلّل من شمولية الدراسة.
أولًا: الخلفية الأكاديمية للكاتب ومنهج الدراسة
تأتي هذه الدراسة من إعداد الكاتب John Zadeh ، الذي يتميّز بخلفيةٍ أكاديميةٍ ومهنيةٍ تتأسس على مجال الاستثمار في الشركات الصغيرة والموارد الطبيعية، وهو مجالٌ يتطلّب إلمامًا واسعًا بمبادئ الاقتصاد، والتمويل، وأسواق المال، فضلًا عن معرفةٍ متينةٍ بأساسيات الجيولوجيا وعلم طبقات الأرض ذات الصلة بالمعادن والغاز والنفط، هذا التكوين الأكاديمي المتداخل بين الاقتصاد والجيولوجيا مكّنه من تطوير رؤية تحليلية مُتكاملة تستند إلى الربط بين المُعطيات العلمية والاقتصادية والسياسية، وهي رؤية انعكست بوضوح في كتاباته، فبدلًا من الاقتصار على الوصف السطحي أو التحليل الأحادي الجانب، يوظّف زاده معارفه العلمية والعملية في رسْم صورةٍ شاملةٍ للمشهد الطاقي، تتجاوز حدود السوق لتطالَ الأبعادَ الجيوسياسية والاستراتيجية.
أما نوع الدراسة التي يقدّمها في مقاله حول التحوّلات في مشهد الطاقة المصري، فيمكن تصنيفها ضمن الدراسات التطبيقية في الاقتصاد السياسي للطاقة؛ فهي ليست مقالةً إخباريةً آنيةً، ولا دراسةً نظريةً محضة، بل دراسة تحليلية تفسيرية تسعى إلى فهم ظاهرة مُعقّدة ـ هي تحوّل مصر من مُصدّرٍ إلى مستوردٍ للطاقة ـ من خلال أدوات البحث العلمي التطبيقي، ومن ثمّ، فهي دراسةٌ تحليليةٌ ذات بُعدٍ استشرافي، تنطلق من الواقع الموثّق بالأرقام والبيانات، ثم تبني عليه استنتاجات وسيناريوهات مُستقبلية مُحتملة.
المنهج المتّبع في هذه الدراسة هو التحليل السياقي متعدّد الأبعاد؛ إذ يبدأ الكاتب بمنهج وصفي تحليلي يستعرض من خلاله المؤشرات الاقتصادية الأساسية مثل مُعدّلات الإنتاج، نِسبِ الاستهلاك، وحجم الاستيراد، ثم ينتقل إلى المنهج التفسيري الذي يضع هذه الأرقام في إطارها الأوسع، مُبرزًا كيف أنّ عوامل سياسيةً وإقليميةً ـ مثل الاضطرابات في الشرق الأوسط ـ تسهم في صياغة مآلات هذا التحوّل الطاقي. وفي مرحلةٍ لاحقة، يوظّف الكاتب المنهج الاستشرافي عبر تقديم سيناريوهات مُستقبلية تتيح للقارئ إدراك حدود المخاطر والفرص التي قد تترتب على تطورات السوق والسياسة في آن واحد.
أما الأسلوب، فهو يجمع بين الصرامة العلمية والوضوح الخطابي؛ إذ إن العلاقة بين خلفية الكاتب الأكاديمية ومنهجه في الدراسة علاقةٌ عضويةٌ. فإلمامه بعلوم الاستثمار وسلوك الأسواق منحه القدرة على تحليل الأبعاد الاقتصادية البحتة، في حين أنّ معرفته بأساسيات الجيولوجيا مكّنته من قراءة التحديات التقنية في إنتاج الغاز والنفط، أما خبرتُه في الذكاء الاصطناعي والتحليلِ الرقمي فقد ساعدته على صياغة رؤى استشرافية تتجاوز حدود اللحظة الراهنة، كل ذلك صاغ أسلوبًا يقوم على التكامل بين التحليل الكمي والنوعي، وبين الوصف الدقيق والتفسير النقدي.
أما فيما يخص الحياد، فيتّسم الكاتب بدرجةٍ عاليةٍ من الحياد النِسبي المرتبط بخلفيته كمُستثمرٍ ومُحلّلٍ في قطاع الموارد الطبيعية، غير أنّ حياده ليس أكاديميًا مُطلقًا، بل حياد وظيفي مُوجّه نحو خدمة غايات استثمارية وتحليلية، فزاوية رؤيته تنحاز إلى رصد الأبعاد الاقتصادية والمالية وتأثيرها على الأسواق، فيما يُقلّل من التركيز على الجوانب الاجتماعية أو البيئية. وبذلك، يُمكن القول إن الكاتب يُمارس موضوعيةً منهجيةً تُعلي من شأن الأرقام والوقائع، لكنها تبقى مشروطة بطبيعة خلفيته الاستثمارية.
ثانيًا: أفكار الدراسة ومحاورها
تسعى دراسة الكاتب John Zadeh إلى تفكيك التحولات الراهنة في مشهد الطاقة في مصر والمنطقة، مركّزةً على الشراكة الغازية بين القاهرة وتل أبيب، يمكن تلخيص أبرز أفكارها وحججها على النحو الآتي:
1- التحول في مشهد الطاقة المصري: واجهت طموحات مصر في ترسيخ مكانتها كمركزٍ إقليميٍ للغاز الطبيعي تحدياتٍ كبيرةً في السنوات الأخيرة. شهدت البلاد تحولًا جذريًا في ثرواتها الطاقية، حيث انتقلت من دولةٍ مُصدّرة صافية للغاز الطبيعي إلى دولةٍ تعتمد بشكلٍ متزايدٍ على الواردات. ينبع هذا التحول من عدة عوامل مترابطة تؤثر على مشهد الطاقة المحلي في مصر، لقد أثّر الاستنزاف الطبيعي لحقول الغاز الناضجة بشكلٍ كبيرٍ على قدرة الإنتاج في مصر، حيث شهد حقل “ظهر” الذي كان غزيرَ الإنتاج تراجعًا في معدلات إنتاجه منذ عام 2022. يأتي هذا الاستنزاف في وقت صعب بشكل خاص حيث لم تَقمْ البلادُ بأي اكتشافات غاز جديدة كبرى منذ عام 2015، مما أدّى إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب، وتزداد الوضع تعقيدًا بسبب الزيادة السريعة في الاستهلاك المحلي للكهرباء في مصر، والتي نمت بمتوسط معدل سنوي قدره 5.3% على مدار العقد الماضي. وقد وضع هذا الارتفاع في الطلب على الطاقة ضغطًا هائلاً على موارد الغاز في البلاد، والتي تشكّل وقودًا لما يقرب من 85% من إنتاج الكهرباء. كما لَعبتْ التحدياتُ الماليةُ التاريخية دورًا في تحول الطاقة في مصر. فنقْصُ العملات الأجنبية وتأخر المدفوعات السابقة للشركات الدولية للطاقة أثنى المستثمرين عن الاستثمار في التنقيب وتطوير الحقول خلال فترات حرجة، مما ساهم في نقص الإنتاج الحالي. لقد حوّلت هذه العوامل المتضافرةُ مصر إلى مستوردٍ صافٍ للغاز منذ عام 2022، مما أجبر البلاد على الاعتماد على كل من الغاز عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل والموارد الأكثر تكلفةً من الغاز الطبيعي المسال (LNG) من الأسواق العالمية لتلبية احتياجاتها المحلية. يعد فهْمِ هذه التحولات أمرًا أساسيًا لتقييم فرص سوق الغاز الطبيعي المسال الناشئة في المنطقة.
2- الأهمية الاستراتيجية والفوائد المتبادلة لصفقة الغاز: تمثّل اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل واحدةً من أهم الشراكات في مجال الطاقة بالمنطقة، حيث تخلق ترابطًا اقتصاديًا يتجاوز التوترات السياسية التاريخية. يُعد حجم هذا التعاون كبيرًا، ففي العام الماضي، استوردت مصر كميةً قياسيةً من الغاز الطبيعي بلغت 981 مليون قدم مكعب يوميًا من إسرائيل، مسجلةً زيادة بنسبة 18.2% عن العام السابق وفقًا لبيانات من “ميدل إيست مونيتور”. ويشكل الغاز الإسرائيلي الآن ما يقرب من 20% من إجمالي إمدادات الغاز في مصر. في أغسطس 2025، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تمديد اتفاقية إمداد الغاز البالغة قيمتها 35 مليار دولار مع شركة “نيوميد إنرجي” الإسرائيلية حتى عام 2040. يتمحور هذا العقدُ طويل الأجل حول الغاز من حقل “ليفياثان” الإسرائيلي الضخم في البحر الأبيض المتوسط، والذي تمَّ اكتشافه عام 2010 ويحتوي على ما يقرب من 22.9 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج، وتقدم الشراكة فوائد كبيرة لكلا البلدين:
لمصر: تأمينُ إمدادات غاز موثوقة بأسعار أقل بكثير من أسعار سوق الغاز الطبيعي المسال، دعمُ توليدِ الكهرباء المحلي لسكانها المتزايدين، تمكين استمرار صادرات الغاز الطبيعي المسال من منشآت الإسالة المصرية، تقليل الضغط على احتياطيات العملة الأجنبية من خلال الحدِّ من مشتريات السوق الفورية المكلفة.
لإسرائيل: توفيرُ سوق تصدير مستقر وطويلِ الأجل لمواردها الغازية، توليد إيرادات كبيرة (35 مليار دولار على مدى فترة العقد)، تعزيز الروابط الاقتصادية الإقليمية والعلاقات الدبلوماسية، تعزيز مكانة إسرائيل كمورّدٍ رئيسيٍ للطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وينص العقد على تسليم ما يقرب من 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي حتى عام 2040، مما يرسّخ هذه الشراكة كحجرِ زاويةٍ للأمن الطاقي الإقليمي لسنواتٍ قادمةٍ.
3- تأثير التوترات الجيوسياسية على تدفقات الغاز: يواجهُ مستقبل صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر الآن حالةً من عدم اليقين وسط تصاعد التوترات الإقليمية. لقد وضعت العديد من التطورات ضغطًا على هذه الشراكة الحيوية في مجال الطاقة، مما يُثيرُ تساؤلاتٍ حول جدواها على المدى الطويل، أدّتْ العملياتُ العسكريةُ الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك أوامر إخلاء سكان مدينة غزة، إلى تصعيد التوترات في جميع أنحاء المنطقة. فبعد فترةٍ وجيزةٍ من وقْفِ إطلاق النار في وقتٍ سابق من العام، عندما عاد مئات الآلاف من الأشخاص إلى مدينة غزة، خلقت أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتجددة مخاوف إنسانيةً واحتكاكاتٍ دبلوماسيةً بين البلدان المجاورة. لقد خلقت دورة التصعيد والتهدئة بيئةً متقلّبةً، حيث تصبح اتفاقيات الطاقة، على الرغم من أهميتها الاقتصادية، خاضعةً للحسابات السياسية والاعتبارات الأمنية. كما تخلق هذه الصراعات الإقليمية “تأثيرات تعريفية كبيرة على التجارة العالمية” مع تعطيل طرق الشحن.
4- الخطاب السياسي وردود الفعل المصرية: أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريحاتٍ تشير إلى رؤية “إسرائيل الكبرى” التي تشمل أراضٍ من الفرات إلى النيل. أثارت هذه التصريحات، التي تمَّ تداولُها على نطاقٍ واسعٍ في وسائل الإعلام الإقليمية، مخاوف في مصر بشأن طموحات إسرائيل الإقليمية على المدى الطويل. وفقًا لتقارير في صحيفة “إسرائيل هيوم”، أصدر نتنياهو تعليمات للمسؤولين “بعدم المُضي قدمًا في صفقة الغاز الضخمة مع مصر دون موافقته الشخصية”، مما يشير إلى أن اتفاقية الغاز قد تُستخدمُ كورقة ضغط في أهدافٍ إقليميةٍ أوسع. هذا الاستخدامُ المحتمل لموارد الطاقة يضيف بُعدًا آخر إلى علاقةٍ معقّدةٍ بالفعل. ردّت مصر بتحدٍّ على الاضطرابات المحتملة، حيث صرح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: “إن نتنياهو يرى في مصر عَقبةً أمام حلمه بإسرائيل الكبرى وخطرًا عليه، وشوكةً في جنبه، خاصةً وأن القاهرة هي خطُّ الدفاع الأول ضد تهجير الفلسطينيين”. وأضاف رشوان أن “الإدارة المصرية لديها بدائل وسيناريوهات لما قد يحدث”، مما يشير إلى أن مصر تَعدُّ خططَ طوارئ في حال انقطاع تدفقات الغاز الإسرائيلية. يشير هذا الخطاب إلى أنه على الرغم من الأهمية الاقتصادية للغاز الإسرائيلي، فإن مصر غيرُ مستعدةٍ للتنازل عن مواقفها السياسية الأساسية.
5- التداعيات الاقتصادية لانقطاع تدفقات الغاز: أي انقطاع للشراكة الغازية بين إسرائيل ومصر سيكون له عواقبُ اقتصاديةٌ كبيرةٌ على كلا البلدين، مع تداعياتٍ خاصة على أسعار الطاقة، وأمن الإمدادات، واحتياطيات العملة الأجنبية. الميزة الاقتصادية لغاز الأنابيب الإسرائيلي مقارنة بواردات الغاز الطبيعي المسال كبيرة وقابلة للقياس الكمي:
يكلّف غاز الأنابيب الإسرائيلي ما يقرب من 7.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
تتوسط أسعار الغاز الطبيعي المسال حاليًا حوالي 13.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، باستثناء تكاليف التخزين العائم.
هذا يمثّل فرقًا في السعر بنسبة تقارب 75% لصالح الغاز الطبيعي المسال مقارنة بغاز الأنابيب الإسرائيلي. بالنسبة لمصر، التي تستهلك ما يقرب من 6.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، فإن استبدالَ الواردات الإسرائيلية بالغاز الطبيعي المسال سيكلفها 2.1 مليار دولار إضافيةً سنويًا بالأسعار الحالية للسوق. هذا العبءُ الماليُ سيضع ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد المصري واحتياطيات النقد الأجنبي.
يمكن أن تستغلَ إسرائيل التوترات الحالية للتفاوض على أسعارٍ أعلى لصادراتها من الغاز. أشارت تقارير من “رويترز” في مايو 2025 إلى أن إسرائيل كانت تدرس زيادة أسعار الغاز المصدّرَ بنسبة 25% تقريبًا، وهو ما سيظل يجعل غاز الأنابيب أكثر اقتصادية من بدائل الغاز الطبيعي المسال. مثل هذه التعديلات السعرية ستسمح للشراكة بالاستمرار بينما توفر لإسرائيل إيراداتٍ إضافيةً، وربما تكون بمثابة حلّ وسط بين الانقطاع الكامل والحفاظ على الوضع الراهن. هذه المفاوضات تأتي وسط “اتجاهات أوسع لسوق النفط” التي شهدت زيادة في تقلب أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.
لقد عانت مصر من نقْصٍ في الكهرباء واضطراباتٍ صناعيةٍ خلال انقطاعاتٍ سابقة لتدفقات الغاز الإسرائيلي. سيجبر الانقطاع المطول مصر على تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصعبة: زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال المكلفة، وتتطلب إنفاقًا إضافيًا من العملة الأجنبية، واحتمال خفْض توليد الكهرباء خلال فترات ذروة الطلب، وقطع إمدادات الغاز عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل إنتاج الأسمنت والأسمدة، ومواجهةِ ضغطٍ أكبر على احتياطيات العملة الأجنبية، مما قد يؤثر على الواردات الأخرى. هذه العواقبُ تؤكدُ على سبب وجود حوافزَ اقتصاديةٍ قويةٍ لكلا الجانبين للحفاظ على تدفقات الغاز، على الرغم من التوترات السياسية.
6- الأصول الرئيسية للطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط: برزَ شرق البحر الأبيض المتوسط كإقليم غاز طبيعي مهم، حيث تدعم العديد من الحقول الكبرى أمن الطاقة الإقليمي وتخلق فرصًا اقتصادية جديدة للبلدان في المنطقة.
حقل غاز ليفياثان: يقعُ على بُعد حوالي 130 كم قبالة سواحل حيفا في المياه الإسرائيلية، ويمتد على مساحة 330 كيلومترًا مربعًا من قاع البحر، ويحتوي على 22.9 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج. يتمُّ تسهيل الإنتاج بواسطة أربع آبارٍ تحت سطح البحر متصلةٍ بمنصةٍ بحريةٍ، وتبلغ طاقته القصوى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا (12 مليار متر مكعب سنويًا). يتم توزيع الغاز على إسرائيل ومصر والأردن عبر شبكات خطوط الأنابيب. تمَّ بالفعل إنتاج ما يقرب من 0.7 تريليون قدم مكعب بحلول نهاية عام 2021. هيكل الملكية: شركة “نيوميد إنرجي” (45.3%)، “شيفرون” (39.7%)، “راتيو إنرجي” (15%). يمثل حقل “ليفياثان” أحد أهم أصول الطاقة في المنطقة، حيث إن قدرتَه الإنتاجية كافيةٌ لتلبية الاحتياجات المحلية لإسرائيل مع دعم صادرات كبيرة إلى البلدان المجاورة. أي قرارات تؤثر على هذا الحقل ستؤثر أيضًا على “تأثير إنتاج أوبك” الأوسع على أسواق الطاقة العالمية.
حقل غاز أفروديت: اكْتُشف عام 2011 في المياه القبرصية، ويقع على بعد 170 كيلومترًا جنوب ليماسول، قبرص، وموقعه على بعد 30 كيلومترًا فقط شمال غرب “ليفياثان”. الملكية: تملك كل من “شيفرون” و “شل” 35%، و”نيوميد إنرجي” 30%. يجري تطويره مع اكتمال حفر بئر التقييم، ويمثّل مصدرًا محتملاً آخر للغاز للإمدادات الإقليمية.
7- السيناريوهات المستقبلية لتجارة الغاز في المنطقة: تواجهُ الشراكة الغازية بين إسرائيل ومصر عدة مستقبلاتٍ محتملةٍ اعتمادًا على كيفية تطور التوترات الإقليمية، مع تداعياتٍ على أمن الطاقة، والاستقرار الاقتصادي، والعلاقات الجيوسياسية.
السيناريو الأول “استمرار التشغيل مع تعديلات في الأسعار” : النتيجة الأكثر عقلانيةً اقتصاديًا ستشهد استمرار تدفقات الغاز على الرغم من التوترات السياسية، وربما مع تعديلات في الأسعار التي لا تزال تجعلُ الغاز الإسرائيلي أكثرَ قدرةً على المنافسة من بدائل الغاز الطبيعي المسال. بموجب هذا السيناريو، سيستمر عقد الـ35 مليار دولار بشروطٍ معدّلةٍ، وربما يتضمن زيادة في الأسعار بنسبة 20-25%.
السيناريو الثاني “انقطاعات مؤقتة”: يمكن أن تحدثَ انقطاعاتٌ قصيرةُ الأجل خلال فترات الصراع المتزايد، على غرار الحالات السابقة التي أغلقت فيها حقول الغاز الإسرائيلية مؤقتًا لأسباب أمنية. ستحتاج مصر إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال خلال هذه الفترات. ستخلق هذه الانقطاعات تقلباتٍ في الأسعار وعدم يقين في الإمدادات، لكنها لن تُنهيَ بالضرورة الشراكة طويلة الأجل.
السيناريو الثالث “الإنهاء الكامل”: الإنهاء الكامل للاتفاقية سيجبر مصر على زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال بشكلٍ كبيرٍ بتكاليف أعلى بكثير. ستحتاج مصر إلى تأمين ما يقرب من 120 إلى 150 شحنةً من الغاز الطبيعي المسال سنويًا لاستبدال غاز الأنابيب الإسرائيلي، الأمر الذي يتطلبُ استثماراتٍ كبيرةً. ستخسر إسرائيل سوق تصدير رئيسيًا ومصدرًا للإيرادات.
السيناريو الرابع “استراتيجيات التنويع”: قد يتبع البلدان استراتيجيات تنويع بغض النظر عن وضع الصفقة الحالي: يمكن لمصر تسريع تطوير موارد الغاز المحلية والبحث عن مصادر استيراد بديلة، ويمكن لإسرائيل توسيعُ وصلاتِ خطوط الأنابيب إلى أسواقٍ إقليميةٍ أخرى أو تطوير قدرات تصدير الغاز الطبيعي المسال.
وفي النهاية يخلص الكاتب إلى أن الشراكةَ الغازيةَ بين إسرائيل ومصر، البالغةُ قيمتها 35 مليار دولار، تقف عند منعطفٍ حَرٍجٍ مع تصاعد التوترات الإقليمية. بينما يشير المنطق الاقتصادي إلى الحفاظ على هذه العلاقة المتبادلة المنفعة، فإن الاعتبارات السياسية والأمنية قد تتجاوز المصالح التجارية. تواجهُ مصر تكاليف طاقة أعلى إذا أُجبرت على استبدال الغاز الإسرائيلي بالغاز الطبيعي المسال الأكثر تكلفة، بينما تخاطر إسرائيل بفقدان سوق تصديرٍ مستقرٍ لمواردها الغازية. ستعتمد النتيجة على ما إذا كانت اعتبارات أمن الطاقة العملية يمكن أن تَسودَ على الصراعات الإقليمية الأوسع. ومهما حدث، فإن هذا الوضع يسلط الضوء على التفاعل المعقّدِ بين تجارة الطاقة والجغرافيا السياسية في واحدةٍ من أكثر مناطق العالم أهمية استراتيجية.
ثالثًا: الرؤية النقدية وتحليل الدراسة
تُقدم دراسة الكاتب John Zadeh تحليلًا ثريًا للشراكة الغازية بين مصر وإسرائيل، مُركزًا على التفاعل المعقّد بين العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، ومع ذلك، يمكن تقديمُ رؤيةٍ نقديةٍ وتحليلٍ مُتكامل لهذه الدراسة، تستكشف نقاط قوتها وتحدد أوجْهَ قصورها، مع تقديم توصيات لتعزيزها، وذلك من خلال ما يلي:
نقاط القوة في الدراسة: تتمتع الدراسة بعدة نقاط قوة رئيسية، حيث يظهر ذلك على النحو الآتي:
العمق الاقتصادي والتحليل الكمي الدقيق: تُعد قدرة الدراسة على تقديم تحليلٍ اقتصاديٍ كمّيٍ دقيقٍ من أبرز نقاط قوتها. لا تكتفي الدراسة بسَرْدِ الحقائق العامة، بل توفر أرقامًا ملموسةً ومقارناتٍ سعريةً تُظهر بوضوح الفوائد الاقتصادية المترتبة على الشراكة الغازية. فمقارنة سعر الغاز الإسرائيلي عبر الأنابيب ($7.75 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) بسعر الغاز الطبيعي المسال الأكثر تكلفة ($13.5) تُشكّل حجّةً اقتصاديةً قويةً تُفسر سبب تمسّكِ مصر بهذه الصفقة رغم التوترات السياسية. هذه الأرقام تُبرز بشكل ملموس العبء المالي الإضافي الذي ستتحمله مصر (حوالي 2.1 مليار دولار سنويًا) في حال انقطاع الإمدادات، مما يجعل التحليل واقعيًا ومقنعًا.
النهج الشمولي والترابط بين العوامل: تتجاوز الدراسة التحليل الأحادي وتتبنى نهجًا شموليًا يربط ببراعة بين العوامل الاقتصادية، والجيوسياسية، والسياسية الداخلية. فالكاتب يربط بذكاء بين تصريحات نتنياهو حول “إسرائيل الكبرى” واستخدام الغاز كورقة ضغط، وبين الردِّ المصري الذي يؤكد على وجود بدائل. هذا الربطُ المتكاملُ يُظهر أن قرارات الطاقة ليست فنيةً أو تجاريةً بحتةً، بل هي جزء لا يتجزأ من حساباتٍ سياسيةٍ وأمنية أوسع. هذا المنهجُ يمنح الدراسة عمقًا استثنائيًا ويعكس مدى تعقيد المشهد الإقليمي.
توازن الطرح: تظهر موضوعية الدراسة إلى حدٍ لا بأس به في تناولها لأوجه الاستفادة المُشتركة من الصفقة، فهي لا تقتصر على تحليل مصالح طرفٍ واحد،ٍ بل تُقدم رؤيةً مُتوازنةً توضح الفوائد الاقتصادية لكل من مصر (تأمين إمدادات أرخص وتقليل الضغط على العملة الأجنبية) وإسرائيل (تأمين سوق تصديرٍ ثابتٍ وإيرادات كبيرة، كما أنها تُحلل التوترات من منظور الطرفين، وتعرض الخطاب السياسي الإسرائيلي وردود الفعل المصرية في ذلك السياق.
التفكير الاستشرافي من خلال السيناريوهات المُستقبلية: تتميز الدراسة بقدرتها على التفكير الاستشرافي من خلال تقديم سيناريوهاتٍ مُستقبليةٍ مُتعددة ومدروسة، بدلاً من التكهن بنتيجةٍ واحدةٍ، تُقدم الدراسة أربعة سيناريوهات محتملة (استمرار مع تعديل، انقطاعات مؤقتة، إنهاء كامل، وتنويع المصادر). هذا النهج المنهجي يُعَد أداةً قويةً ، إذ أن هذا الطرح يرفع من مُستوى الدراسة من مُجرد تحليل للواقع إلى أداةٍ استراتيجيةٍ للتخطيط للمستقبل.
أوجه القصور ونقاط الضعف: تواجهُ الدراسة بعض أوجهِ القصور التي تحد من شموليتها وتوازنها، ويظهر ذلك فيما يلي:
التركيز المُفرط والمُبالغة في الاعتماد المصري على الغاز الإسرائيلي: الدراسة تبالغ في تصوير الاعتماد المصري على الغاز الإسرائيلي، وتغفل أو تقلل من أهمية جهود مصر المتزايدة في تنويع مصادر الطاقة. ففي حين تذكر أن مصر تعدّ خطط طوارئ، إلا أنها لا تستكشف هذه الخطط بعمقٍ. على سبيل المثال، لم تتطرقْ الدراسة بما فيه الكفاية إلى الإمكانياتِ الكبيرة للطاقة المتجددة في مصر، مثل محطات الطاقة الشمسية والرياح، والتي تمثّل استراتيجيةً طويلةَ الأجل لتقليل الاعتماد على الغاز بشكل عام، سواء المحلي أو المستورد، هذا يُضعفُ الحُجة القائلة بأن مصر ستكون في موقفٍ حَرجٍ حتمًا إذا توقفت إمدادات الغاز الإسرائيلي.
غياب البعد التاريخي لسياسات الطاقة المصرية: تصف الدراسة التحول في مشهد الطاقة المصري كأنه حدثٌ مُفاجئٌ أو حديث، متجاهلةً الجذور التاريخية للمشكلات. فالاستنزاف الطبيعي لحقول الغاز لم يحدث بين عشية وضحاها، بل هو نتيجة لعقود من السياسات التي ركزت على الاستهلاك المحلي المدعوم بأسعار مُنخفضة، مما أدى إلى استهلاكٍ مُتسارعٍ للثروات الغازية، لو أن الكاتب أشار إلى هذه الخلفية التاريخية، لكان تحليله أكثر عمقًا ولأظهر أن الأزمة الحالية ليست مجرد نتيجةٍ لانخفاض إنتاج حقل ظهر، بل هي تتويجٌ لسياسات طاقة غير مُستدامة على المدى الطويل.
التحيز لإسرائيل فيما يتعلق بتحليل ديناميكيات القوة: تميل الدراسة إلى تصوير العلاقة بين البلدين من منظورٍ أُحاديٍ، حيث تضع إسرائيل في موقع الفاعل (الفاعل الذي يمكنه استخدام الغاز كورقة ضغط)، ومصر في موقع المتلقي (الذي يتلقى الضغوط ويُجبر على الاستيراد). هذا الطرحُ يُهمل أن مصر نفسها تستخدم هذه الشراكة لتعزيز نفوذها كمركزٍ إقليميٍ للطاقة، حيث تستفيد من محطات الإسالة الخاصة بها لإعادة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، مما يمنحها عائداتٍ اقتصاديةً ونفوذًا جيوسياسيًا. لو أن الكاتب استعرض هذا الجانب، لكان التحليل أكثر توازنًا وأقل تحيزًا في تصوير ديناميكية القوة.
عدم التوسع في دور الأطراف الإقليمية الأخرى: تركّز الدراسة بشكلٍ أساسيٍ على العلاقة الثنائية بين مصر وإسرائيل، مما يُقلل من أهمية أدوار الأطراف الإقليمية الأخرى التي تمتلك مصالح في شرق البحر الأبيض المتوسط. فالدراسة تُشير إلى حقل “أفروديت” في المياه القبرصية وتذكر خط أنابيب “إيست ميد” المقترح، لكنها لا تُحلل كيف يمكن لديناميكيات العلاقة بين قبرص وإسرائيل، أو طموحات تركيا، أو دور الاتحاد الأوروبي، أن تؤثرَ على أمن الطاقة الإقليمي وتُشكل بديلاً مُحتملاً في حال تعطل صفقة الغاز المصرية-الإسرائيلية.
التحليل المحدود للبدائل الطاقية غير التقليدية: تذكر الدراسة أن كلا البلدين يتجهان نحو الطاقة المتجددة كجزءٍ من استراتيجية التنويع، ولكنها تُصنّفها كخيارٍ طويل الأجل فقط. لا تُقدم الدراسة تحليلًا اقتصاديًا أو زمنيًا أعمق للجدوى الفعلية لمشاريع الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح كبديلٍ مباشرٍ وفعّال للغاز الطبيعي في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء على المدى المتوسط. كان من شأن التعمق في تكاليف الإنتاج، وتحديات التخزين، والتكامل مع الشبكة، أن يُوفر تقييمًا أكثر شمولية لموقع الطاقة المتجددة كبديل حقيقي للغاز.
إهمال تحليل دور العوامل والظروف الاقتصادية العالمية: على الرغم من أن الدراسة تُشير بشكل عابر إلى “تأثير الإنتاج في أوبك” أو “اتجاهات سوق النفط”، إلا أنها لا تُدمج هذه العوامل الاقتصادية الأوسع في صميم تحليلها. تظل الدراسة مركّزةً بشكلٍ مفرطٍ على الديناميكيات الإقليمية الثنائية، وتُهمل تأثير عوامل الاقتصاد الكلي العالمي، مثل تغيرات الطلب من الأسواق الأوروبية أو الآسيوية، والتقلبات في الأسعار العالمية للنفط والغاز. كان من شأن دمج هذه المتغيرات أن يُقدّم فهمًا أكثر تعقيدًا للقرارات الاستراتيجية التي تتخذها كلٌ من مصر وإسرائيل، والتي غالبًا ما تتأثر بظروف السوق العالمية بقدر تأثرها بالاعتبارات السياسية الإقليمية.
ضعف في تحليل أدوار الشركات الدولية الكبرى: تُشير الدراسة إلى هيكل ملكية حقلَي “ليفياثان” و “أفروديت”، وتذكر أسماء شركات مثل “شيفرون” و “شل”، لكنها لا تُقدم أي تحليلٍ لدور هذه الشركات كلاعبين مستقلين. هذه الكيانات الدولية العملاقة لديها مصالحُ تجاريةٌ خاصةٌ بها قد لا تتوافق بالضرورة مع الأجندات السياسية الوطنية. كان من الممكن أن تُعزز الدراسة من خلال تحليل الكيفية التي يمكن أن تُمارس بها هذه الشركات ضغطًا دبلوماسيًا أو تجاريًا للحفاظ على استقرار التدفقات، أو كيف يمكن لمصالحها أن تُشكل ديناميكيةً جديدةً في مواجهة التوترات بين الدول.
الطبيعة الافتراضية للنص كحد منهجي رئيسي: يُعد القيد المنهجي الأبرز في الدراسة هو طبيعته الافتراضية، حيث إنه مؤرخ بتاريخ مستقبلي (10 سبتمبر 2025). هذا يعني أن النص ليس تقريرًا صحفيًا أو دراسة قائمة على حقائق مثبتة، بل هو سيناريو استشرافي أو محاكاة لتحليل صحفي. هذا الجانب يُقوّض من الأساس التحليل الأكاديمي إذا ما تم التعامل معه على أنه وثيقةٌ واقعيةٌ. فبما أن كافة “الحقائق” والبيانات الواردة فيه (مثل حجم الواردات في العام الماضي، أو تمديد العقد حتى عام 2040) هي محضُ افتراضات، فإنها تُقلل من قيمته كدراسةٍ علميةٍ يُعتد بها، وتُصنفه في خانة التحليلات القائمة على التوقعات. كان يجب على النص أن يُوضح هذه الطبيعة الافتراضية بشكل صريح مُنذ البداية ليكون أكثر أمانة من الناحية المنهجية.
الطبيعة الاستشرافية الغير مدعومة بالنماذج: تُعد السيناريوهات المستقبلية من نقاط قوة الدراسة، لكنها في الوقت نفسه تمثّل حدودًا كونها افتراضيةً وتعتمد على تقديراتٍ عامة، فالدراسة لا تُقدّم نماذجَ اقتصاديةً أو جيوسياسية توضح المتغيرات المحددة التي قد تدفع بحدوث سيناريو معين على حساب آخر. على سبيل المثال، فإنها تقترح سيناريو “زيادة الأسعار” دون تقديم تحليل لكيفية تأثير مثل هذه الزيادة على الربْحية الإجمالية لمصر أو القدرة التنافسية لإسرائيل في أسواق الطاقة العالمية.