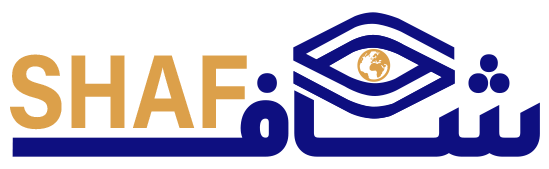المقالات
مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية > تقارير وملفات > وحدة الشرق الأوسط > صراع غير مرئي: مسارات الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل وتداعياتها على الشرق الأوسط
صراع غير مرئي: مسارات الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل وتداعياتها على الشرق الأوسط
- يوليو 2, 2025
- Posted by: Maram Akram
- Category: وحدة الشرق الأوسط
لا توجد تعليقات

إعداد: ريهام محمد
باحث في وحدة شؤون الشرق الأوسط
لم تعد الحروب المعاصرة حبيسة في ميادين القتال التقليدي، بل بات الفضاء السيبراني يُشكل جبهة استراتيجية موازية، تتقاطع فيها الحسابات الأمنية والعسكرية مع أدوات التكنولوجيا والاستخبارات، وتُعاد عبرها صياغة مفاهيم الردع والسيادة بوسائل غير تقليدية، وقد شكلت الحرب الإيرانية-الاسرائيلية في يونيو 2025 نقطة تحول حاسمة في هذا الإطار التغييري؛ إذ تميزت -ولأول مرة بهذا النطاق الواسع- بتآزر ملحوظ بين الضربات العسكرية التقليدية والهجمات السيبرانية المنسقة، التي استهدفت العمق الاستراتيجي للطرفين، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية والمؤسسات المالية وأنظمة القيادة والتحكم.
بناءً عليه، يستند هذا التقرير إلى تحليل زمني يمتد من عام 2010 إلى منتصف عام 2025، وهي الفترة التي شهدت تأسيسًا فعليًا لبنية الحرب السيبرانية بين الطرفين وتحولات نوعية ارتبطت بمساحة العمليات وعمقها وتعقدها، اذ تم اختيار هذه الفترة تحديدًا لأنها تبدأ من الهجوم السايبري المفصلي المعروف بـStuxnet””، الذي كان بمثابة منعطف رئيسي في استخدام الفضاء الرقمي لإدارة الصراع النووي وتصل حتى ذروة التصعيد بشهر يونيو 2025، حيث تبلورت أخطر مواجهة سيبرانية-عسكرية مفتوحة بين إيران وإسرائيل، تكاد تُعيد تعريف معايير الحرب في الشرق الأوسط.
ويتناول التقرير تطور الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل من خلال تحليل متتابع للهجمات وأهدافها الاستراتيجية وتداعياتها المتراكمة، مع التركيز على آثارها المباشرة وغير المباشرة على ديناميكيات الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.
الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل (2010-2025): تسلسل العمليات وتحليل الأهداف والنتائج:
منذ انطلاق العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، دخلت إيران وإسرائيل مرحلة جديدة من الصراع تتجاوز الأنماط التقليدية لتتجذر في الفضاء الرقمي حتى باتت الحرب السيبرانية ساحة مركزية للاشتباك بين الجانبين، وتحولت الهجمات الإلكترونية إلى أدوات ذات أهمية استراتيجية في معادلة الردع الإقليمي، تُستخدم لأغراض استخباراتية وتعطيلية وأحيانًا دعائية، مما يظهر الطابع المُركب لهذا النوع من الحروب غير المتماثلة.
أولًا: تباين الأهداف… صراع بمفاهيم مختلفة:
اتسمت الهجمات السيبرانية التي نفذها الجانبان باختلاف واضح في الأهداف والنطاق والأساليب؛
على الجانب الإسرائيلي، برزت استراتيجية تقوم على الضربات الاستباقية الدقيقة، والتي استهدفت تعطيل أوتقليص الفاعلية للبنية التحتية الإيرانية الحساسة، ولا سيما المنشآت النووية والموانئ ومرافق الطاقة واللوجيستيات، في إطار جهود متواصلة لمنع طهران من بلوغ العتبة النووية أو تعزيز وجودها الإقليمي، وقد استخدمت إسرائيل تقنيات متقدمة مدعومة بجهاز استخبارات إلكتروني قوي يقوده وحدة 8200 والموساد، ما سمح لها بتنفيذ عمليات معقدة تجمع بين البعدين الميداني والسيبراني.
في المقابل؛ اعتمدت إيران على “الهجمات الرمزية والانتقامية”، مستهدفة مؤسسات مدنية داخل إسرائيل مثل المستشفيات وشبكات المياه وشركات التأمين وبعض المواقع الحكومية، وكان الهدف الرئيسي وراء هذه العمليات هو إضعاف ثقة المواطنين الإسرائيليين بنظامهم الأمني والحكومي؛ لتخريب حياتهم اليومية وإرسال رسائل ردع عبر وسائل غير تقليدية، كما استفادت إيران أيضًا من شبكات عملاء سيبرانيين مثل مجموعات “بلاك شادو” و”عصا موسى” وAPT35، وهو ما منحها قدرة على الإنكار وساعدها في تنويع طرق الهجوم وزيادة نطاقه.
ثانيًا: تسلسل تصاعدي للهجمات: من التخريب المحدود إلى الحرب الهجينة الشاملة:
على الجانب الاسرائيلي؛ يمكن تتبّع تطوّر الهجمات الإسرائيلية ضد إيران ووكلائها الإقليميين خلال الفترة من2010 إلى 2025 من خلال أربع مراحل رئيسية، تعكس تحوّلًا تدريجيًا من عمليات سيبرانية تكتيكية إلى حرب هجينة متعددة الأدوات والساحات:
مرحلة التخريب الانتقائي والسيطرة التقنية (2007–2014): بدأت العمليات الإسرائيلية بما يُعرف بـ”الضربات الذكية” التي هدفت إلى تعطيل البنى التحتية الحيوية دون إثارة مواجهة مباشرة، والتي تجسد في الهجوم بـStuxnet” ” كأول هجوم سيبراني هجومي يُنسب إلى إسرائيل والولايات المتحدة، واستهدف برنامج إيران النووي عبر تدمير آلاف أجهزة الطرد المركزي في نطنز، كما شكّلت عملية اعتراض السفينة الإيرانية في البحر الأحمر (2014) مؤشرًا على امتداد البُعد الاستخباراتي العسكري إلى الممرات البحرية، ومن ثم شهدت هذه المرحلة المزج بين التخريب الإلكتروني والعمليات الميدانية السرية، مع الحفاظ على طابع “حرب الظل”.[1]
مرحلة التغلغل الاستخباراتي والسيبراني (2015–2020): اتسع نطاق العمليات ليشمل دولًا ثالثة مثل لبنان، عبر اختراق شركة “أوجيرو” (2017) لأغراض تجسس واسعة، وفي الداخل الإيراني، مثّلت عملية سرقة الأرشيف النووي (2018) ذروة العمل الاستخباراتي المنسّق، أما تفجيرات نطنز المتكررة واغتيال فخري زاده (2020) فشكّلا نقطة تحوّل باتجاه المزج بين التخريب السيبراني والاغتيال الذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي.[2]
مرحلة زعزعة العمق الإيراني وتفكيك شبكات النفوذ (2021–2023): خلال هذه الفترة، كثّفت إسرائيل عملياتها التي تستهدف البنية المؤسسية والأمنية الإيرانية عبر ضربات سيبرانية دقيقة، وفضح اختراقات استخباراتية داخل النظام الإيراني كما ورد في تصريحات “أحمدي نجاد” و”علي يونسي”، كما تم توسيع نطاق الأهداف ليشمل المصانع العسكرية (أصفهان 2023) ومراكز القيادة، بالتوازي مع استخدام المسيرات والأسلحة الموجهة.
مرحلة الحرب السيبرانية–الميدانية الشاملة (2024–2025): مع تصاعد التوتر في منتصف 2024 واغتيال قيادات بارزة كـ “إسماعيل هنية” داخل طهران، دخل الصراع طور الحرب الهجينة الشاملة، وشملت هذه المرحلة عمليات اغتيال لقادة عسكريين داخل إيران، وتفجير أجهزة نداء لآلاف عناصر حزب الله والذي عُرف بتفجيرات “البيجر”، كما امتدت العمليات إلى لبنان عبر سلسلة من الاغتيالات الممنهجة لقيادات الحزب أبرزها اغتيال أمين العام الحزب “حسن نصر الله”، ومنها الى سوريا والبحر الأحمر كمواقع متقدمة للعمل الأمني.
وفي يونيو 2025، تمكّنت إسرائيل من توجيه ضربات دقيقة لأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية المتقدمة، مثل “باور-373” و”خرداد-15″، عبر تدمير راداراتها ومنصات إطلاقها، ما أدى إلى شل قدرة إيران على رصد أو اعتراض الهجمات الجوية، تلاها الاستهداف الممنهج للبنية الدفاعية المرتبطة، شمل أنظمة رادار مثل “كافوش” و”مرصاد”، فضلا عن منصات صواريخ ومستودعات الذخيرة، بالتوازي مع اختراق مراكز الاتصالات العسكرية وتعطيل التنسيق العملياتي داخل الحرس الثوري الإيراني، لا سيما في وحدات الحرب الإلكترونية وقيادة الاتصالات المشفرة.[3]
في الجانب السيبراني، تعرضت إيران لهجمات إلكترونية غير مسبوقة شلّت 97% من شبكة الإنترنت يوم 18 يونيو، وتسببت في انهيار البنية التحتية الرقمية في البلاد، جاء ذلك تزامُنًا مع هجوم على بنك “سباه” أدى إلى سرقة 12 تيرابايت من البيانات الحساسة، وتسريبها علنًا، بينما استُهدفت بورصة Nobitex” ” للعملات الرقمية بخسائر مباشرة بلغت حوالي 90 مليون دولار.[4]
وفي ضوء ذلك يمكن تلخيص التحولات النوعية التي شهدتها الهجمات الاسرائيلية كما يلي:
2010–2014: كانت البداية مع فيروسات متطورة مثل Stuxnet، واختراقات موجهة نحو البنية النووية.
2014–2018: شهدت توسع جغرافي في العمليات الإسرائيلية، لتشمل لبنان وسوريا والبحر الأحمر.
2018–2021: تزايدت العمليات المزدوجة والتي شملت عمليات سيبرانية وميدانية، مثل اغتيالات العلماء.
2022–2025: جسدت تلك الفترة التحول إلى حرب هجينة شاملة، استهدفت الاقتصاد، الإعلام، والقيادات السياسية.
على الجانب الايراني: شكّلت الهجمات السيبرانية الإيرانية على إسرائيل، منذ عام 2011، أحد أبرز مظاهر الحرب غير المعلنة بين الطرفين، حيث سعت طهران إلى استغلال الفضاء الرقمي كوسيلة للضغط والرد، بالإضافة إلى تطوير أدوات ردع غير تقليدية لتعويض نقصها التقليدي في ميزان القوى مع تل أبيب، وعليه؛ يمكن تتبع تطور الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل وحلفائها خلال الفترة من 2010 إلى 2025 كما يلي:
في الفترة ما بين 2011 و2013: تركزت الأنشطة الإيرانية على استهداف مؤسسات أمريكية، خاصة في القطاع المالي، عبر هجمات تعطيل الخدمة DDoS) ) التي استهدفت 47 بنكًا ومؤسسة، إضافةً لذلك، كانت هناك محاولات لاختراق البنى التحتية، مثل محاولة السيطرة على نظام سد مائي بالقرب من نيويورك عام 2013، والتي أُحبطت نتيجة مصادفة تقنية (الصيانة)، كذلك نفذت مجموعات إيرانية عمليات تسلل واسعة النطاق لمؤسسات أكاديمية في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى واستطاعت سرقة أكثر من 31 تيرابايت من البيانات من حوالي 176 جامعة.[5]
بين عامي 2014 و2020: بدأت الهجمات تجاه الجانب الإسرائيلي بشكل محدود أثناء العدوان على غزة عام 2014 (“الجرف الصامد”) حيث تم اختراق حساب وزير الدفاع الإسرائيلي والتشويش على بعض المنصات دون أن تسفر عن أضرار استراتيجية كبيرة، ومع حلول عام 2020، انتقلت المواجهة الرقمية إلى مرحلة أكثر جرأة مع اتهامات لإيران بمحاولات اختراق شبكة المياه الإسرائيلية والسيطرة عليها بهدف القيام بهجوم تخريبي قد يهدد السلامة العامة؛ تلت هذه المحاولات جهود لاستهداف مراكز بحث تعمل لتطوير لقاحات ضد كورونا رغم فشلها في تحقيق أهداف واضحة.[6]
من عام 2020 إلى 2023: بدأت فترة يمكن وصفها بـ”مرحلة الهجمات النفسية والاقتصادية”، حيث برزت جماعة (Black Shadow ) المرتبطة بإيران من خلال اختراق شركة التأمين “شيربيت”، مما أدى إلى تسريب بيانات آلاف العملاء ومطالبتهم بفدية مالية، وفي العام 2021، ظهرت جماعة “عصا موسى” التي استهدفت المستشفيات والشركات الدفاعية الإسرائيلية، وكشفت عن بيانات حيوية وسرقت معلومات حساسة، مما تسبب في شلل مؤقت لبعض المنشآت الصحية، أيضًا حاولت مجموعات مثل APT35 (Charming Kitten) استغلال ثغرات عالمية مثل Log4j لاستهداف سبع هيئات حكومية إسرائيلية، لكن المحاولة أُحبِطت.[7]
وفي مارس 2022، شنت جهات يُعتقد أنها مرتبطة بإيران هجومًا من نوع DDoS) ) على نطاقات الحكومة الإسرائيلية gov.il))، مما تسبب في تعطيل بعض المواقع لفترة معينة، أما هجمات يناير 2023 فقد ركزت على اختراق إعلامي رمزي تمثل في نشر صور لقاسم سليماني ورسائل تهديد عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية.[8]
وفي ضوء ذلك، يمكن تلخيص ملامح العقيدة الإيرانية في هذا المجال على النحو التالي:
– تصعيد تدريجي ومركب؛ يتراوح بين هجمات التشويش والاستهداف المباشر النفسي.
– تنوع الأهداف؛ بما يشمل منشآت حيوية كالمياه وقطاعات مهمة مثل الصحة والتأمين ومنصات إعلامية.
– استخدام تكتيكات التهديد الرمزي والمطالب المالية؛ لإحداث ضغط شعبي وسياسي على الحكومة الإسرائيلية.
– الاستناد إلى جماعات وسيطة؛ ما يمنح طهران مرونة أكبر وقدرة على الإنكار دون تحمل خسائر مباشرة.
تأثير الصراع السيبراني على الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط:
أحدث التصعيد السيبراني بين إسرائيل وإيران في يونيو 2025 تحولًا جذريًا في طبيعة التهديدات الإقليمية، حيث انتقل الفضاء الرقمي من كونه ساحة ثانوية إلى ميدان رئيسي للصراع، وقد شمل هذا التحول أطرافًا متعددة تتجاوز حدود الخصمين التقليديين، ليؤثر على أنظمة الأمن الإقليمي والسيادة للدول المجاورة، وقد ظهرت تداعيات هذه المواجهة عبر عدة مسارات استراتيجية:
توسيع نطاق الصراع إلى أبعاد إقليمية غير تقليدية: أدى استخدام الأدوات السيبرانية إلى تخطي الطبيعة الثنائية للصراع (إسرائيل – إيران)، إذ لوحظت هجمات استهدفت بيئات رقمية في دول عربية مجاورة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء غير حكوميين (هاكتيفست)، ففي قطر، مثلاً، أفاد عدد من سكان الدوحة بوقوع تغييرات غريبة في مواقعهم على هواتفهم المحمولة خلال الأيام الأخيرة من حرب يونيو، حيث تم تحديد موقعهم خطأً كنشاط داخل إيران، ويعني هذا الامتداد أنه أي اشتباك مستقبلي بين القوى الإقليمية الكبرى قد تتسرب آثاره بسرعة إلى دول ثالثة دون تحذير أو استعداد مسبق؛ مما يخلق واقعاً أمنياً جديداً يُظهر أن الحياد لم يعد يوفر حماية ضد التورط الرقمي.[9]
تغيير مفاهيم الردع الإقليمي: فرضت الحرب السيبرانية نمطًا جديدًا من الردع، يعتمد على الرد غير المتماثل وغير المعلن كبديل للرد العسكري التقليدي، فبات بإمكان أي دولة أو حتى منظمة غير حكومية القيام بهجوم معطل للبنية التحتية دون تعرضها لتكاليف سياسية واضحة، وقد أدى هذا التحليل الجديد لقواعد اللعب إلى ارتباك كبير؛ فأصبحت الخطوط الحمراء أكثر ضبابية مما سبق، وهو ما يقلل القدرة على التحكم في التصعيد ويزيد احتمال تفجر أزمات فجائية.
هشاشة البنية المعلوماتية وغياب الحماية المؤسسية: أظهرت الحرب هشاشة معظم البنى التحتية الرقمية في المنطقة، حيث لوحظ أن عددًا كبيرًا من الدول تفتقر إلى آليات دفاع رقمي متكاملة أو استراتيجيات فعالة للتعافي من الهجمات السيبرانية، فأي أزمة سياسية أو أمنية يمكن أن تتطور لتصبح أزمة سيبرانية متوازية، عبر استهداف نظم الدفع الإلكتروني، منصات الخدمات الحكومية، أو مراكز البيانات الحساسة، مما يؤدي إلى شلل جزئي أو كامل في العمليات الحكومية.
ترسيخ الاستقطاب التقني في المنطقة: عمّق الصراع السيبراني الانقسام القائم في الشرق الأوسط بين محورين تقنيين:
المحور الأول يمتلك قدرات هجومية متميزة ويقوده كيان إسرائيلي مدعوم بتقنيات غربية حديثة (شركات الأمن السيبراني الأميركية والأوروبية والمساعدة الاستخباراتية).
أما المحور الثاني فهو يسعى لسد الفجوات عبر الاختراق والمحاكاة أو الاعتماد على الدعم من خصوم الغرب؛ وهذا المحور تقوده إيران ويحظى بدعم جهات مثل روسيا ومجموعات غير حكومية، هذا التمايز لا يكشف فقط عن اختلاف القدرات ولكنه يعمق أيضًا حالة عدم التوازن طويل الأمد ويهدد بخلق “فجوة رقمية ذات سيادة” قد تُستخدم أثناء الأزمات لإعادة تشكيل ميزان القوى.
غياب التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات الرقمية المشتركة: على الرغم من أن معظم الدول العربية تدرك خطورة التهديد، لم تظهر أي علامات على وجود تنسيق إقليمي مشترك خلال فترة الحرب، كما أنه لم يتم تفعيل آليات الإنذار المبكر، ولا يزال هناك نقص في مركز عمليات سيبراني عربي موحد أو إطار عمل جماعي لتبادل المعلومات بين الجهات السيادية، ويعود ذلك لتفاوت مستويات الأمان الرقمي بين الدول المختلفة، واختلاف الرؤى السياسية، وانعدام الثقة الفنية بين بعض الهيئات.
هذا النقص لا يهدد فقط فعالية الاستجابة للأزمات، ولكنه يمنح الخصوم الفرصة لاستغلال نقاط الضعف الفردية لخرق المنظومة العربية بشكل عام.
غياب “الاكتفاء الذاتي الرقمي”: أسفرت الحرب عن بروز إشكالية الاعتماد الخارجي على مزودي خدمات الأمان الرقمي من الخارج، ففي ظل هذا التصعيد، اتجهت بعض الدول الخليجية لتعزيز عقودها مع مزودي الأمن السيبراني من الخارج، وبخاصة من الولايات المتحدة وألمانيا وإسرائيل بشكل غير معلن، وقد أثبتت هذه الترتيبات فعاليتها نسبياً في إحباط بعض المخاطر الرقمية؛ إلا أنها كشفت عن أزمة استراتيجية عميقة تتمثل في غياب “الاكتفاء الذاتي الرقمي”، فالتعويل الكبير على أدوات وشركات أجنبية قد يبدو مفيداً تقنيًا ولكنه يعرض السيادة الرقمية للتدخل الخارجي ويؤجل إنشاء بنية محلية مستقلة.
الخاتمة والتوصيات:
لم تعد الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل مجرد أحد فصول “حرب الظل” بين الطرفين، بل باتت نموذجًا واضحًا على تغيير موازين القوى في القرن الحادي والعشرين، فقد صار ميزان القوة لا يُقاس فقط بحجم الجيوش أو الأسلحة، وإنما بقدرة الدول على التحكم بالمعلومات وتعطيل الأنظمة واختراق العقول قبل الحدود، فقد وفرت البيئة الرقمية لكل منهما ساحة غير تقليدية لتصفية الحسابات، الا أن النتائج كشفت عن تفاوت واضح في الفاعلية، والأهم من ذلك أن هذا الصراع السيبراني لم يعد شأناً ثنائيًا مغلقًا؛ بل هو إشارة تحذيرية لباقي دول المنطقة والعالم بأن أمنها القومي لم يعد محصورًا بالحدود البرية والبحرية والجوية، بل صار معرّضًا للاختراق عبر أكواد واحدة أو ثغرات بسيطة في نظم التشغيل.
وعليه، من المتوقع أن يشهد الصراع تغييرات أعمق على صعيد الأدوات والأطراف المعنية، فيُحتمل أن يتزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الهجمات بدقة وسرعة عالية، مع تقليص الحاجة للتدخل البشري، يأتي ذلك بالتوازي مع خصخصة أدوات الهجوم واستخدام وكلاء رقميين مما يجعل عملية الردع والمحاسبة أكثر تعقيداً، والأخطر من ذلك هو احتمال تسرب هذه الأدوات إلى فواعل غير حكومية، ما قد يؤدي إلى فوضى رقمية تمتد عبر الحدود وتُشكل تهديدًا للأمن القومي للدول دون الحاجة لإعلان حرب، ومع تطورات هذا الوضع، تبرز ضرورة إعادة النظر في مفاهيم الردع والسيادة ضمن الفضاء السيبراني.
واستنادًا إلى ما سبق، تبرز مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تعزز الأمن السيبراني على مستوى المنطقة وتقلل من مخاطر التصعيد الرقمي في سياقات غير مستقرة:
تعزيز السيادة الرقمية كأولوية استراتيجية: ينبغي اعتبار أمن المعلومات جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي، عبر دمج البنية التحتية الرقمية ضمن العقيدة الدفاعية للدولة، ووضع سياسات صارمة لحماية البيانات والمجالات السيبرانية الحساسة.
تأسيس جبهة سيبرانية عربية موحدة: يتطلب الواقع الجديد في الشرق الأوسط إنشاء شبكة دفاع رقمي إقليمية، تعمل وفق استراتيجية مشتركة وآليات متقدمة لرصد التهديدات وتبادل المعلومات، بما يقلص الفجوة مع القوى الإقليمية المتقدمة في هذا المجال.
تطوير قدرات الردع السيبراني الهجومي: لم تعد المقاربات الدفاعية التقليدية كافية، بل يتعين على الدول تبني أدوات ردع رقمية قادرة على استباق التهديدات، وفرض تكلفة سياسية وتقنية على أي جهة تحاول استهداف عمقها الإلكتروني.
تحصين المنشآت المدنية ذات الحساسية العالية: المستشفيات، محطات المياه، وشبكات الطاقة لم تعد مجرد مرافق خدمية، بل أهداف استراتيجية في الحروب السيبرانية، مما يفرض ضرورة إعادة تأهيلها إلكترونيًا وتزويدها بأنظمة حماية مستقلة وفعالة.
الاستثمار في رأس المال البشري السيبراني: لا يمكن بناء بنية دفاع رقمي دون كوادر مؤهلة، ما يستدعي دعم برامج تعليم وتدريب متخصصة في الأمن السيبراني، وتشجيع إنشاء معاهد وطنية ومختبرات بحثية تُنتج أدواتها وتحل مشكلاتها من الداخل.
تقليل الاعتماد على مزودي الأمن الأجانب: لا بد من خفض الاعتمادية على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات الأمن الرقمي، إذ يشكل ذلك خطرًا على السيادة السيبرانية، ويمنح جهات خارجية قدرة غير مباشرة على التأثير في النظم الوطنية خلال الأزمات.