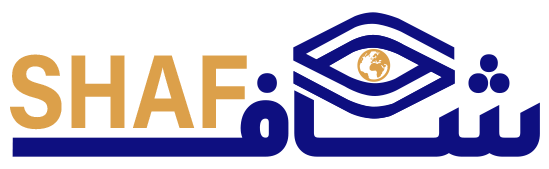المقالات
مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية > تقارير وملفات > وحدة الشرق الأوسط > عرض نقدي > عـرضٌ نقــديٌّ لتقرير بعنوان: ” Syria Political Risk Analysis”
عـرضٌ نقــديٌّ لتقرير بعنوان: ” Syria Political Risk Analysis”
- نوفمبر 17, 2025
- Posted by: Maram Akram
- Category: تقارير وملفات عرض نقدي وحدة الشرق الأوسط
لا توجد تعليقات

إعداد: رضوى الشريف
منسق وحدة شؤون الشرق الأوسط
مقدمة
تشهدُ السَّاحةُ السوريةُ منذ سقوط النظام السابق موْجةً من التحوُّلات السياسية والأمنية العميقة، تتقاطع فيها عمليات إعادة بناء الدولة، ومحاولات ترميم المؤسسات، والتعامل مع قضايا شديدة الحساسية، مثل “دمْج الفصائل المسلحة، وعودة القطاع الخاص، وصياغة شبكة علاقات خارجية جديدة”، وفي ظل واقع “الاستقرار الهشِّ” الذي تتلمَّسُه البلاد، تتزايد الحاجة إلى تقييمات موضوعية للمشهد السياسي والأمني، خصوصًا في ضوء سباق إقليمي ودولي لإعادة التموْضع داخل سوريا ما بعد الحرب.
ضمن هذا السياق، يأتي تقرير “تحليل المخاطر السياسية في سوريا” Syria Political Risk Analysis) ( الصادر في 12 نوفمبر 2025، من إعداد د. Victor J. Willi، المدير التنفيذي لمعهد الشرق الأوسط في سويسرا، بوصفه محاولةً لتقديم تقييم شامل للمخاطر السياسية في سوريا ما بعد الحرب، مُوَجَّهًا في الأساس إلى مستثمرين وشركات بُنَى تحتية تفكِّرُ في دخول السوق السوري، وينطلق التقرير من عملٍ ميدانيٍّ مُكَثَّفٍ استمر أسبوعيْن (من 19 إلى 31 أكتوبر 2025)، شمل مقابلات مع مسؤولين حكوميين، وموظفين في الوزارات، وجامعيين، ورجال أعمال، وعمال، فضْلًا عن زيارات ميدانية لثماني مدن ومحافظات، بما أتاح للباحث بناء سردية تقوم على “مشاهدة من الداخل” وليست مجرد قراءة مكتبية.[1]
يهدف هذا العرض إلى تقديم قراءة نقدية معمقة للتقرير من خلال؛ تقييم خلفية الباحث، وتقديم عرْضٍ لأهمِّ محاور التقرير وحججه، كما صاغها الباحث، وبناء رؤية نقدية تبرز عناصر القوة في هذا العمل، وفي المقابل تكشف حدود مقاربته، وما يغفله أو يهمشه، خاصَّةً فيما يتعلق بسؤال طبيعة الدولة التي تتشكل في سوريا.
أولًا: قراءةٌ في خلفية الباحث
يأتي هذا التقرير من إعداد د. فيكتور ج. ويلي (Victor J. Willi)، وهو خبير بارز في الجيوبوليتك واقتصادات الشرق الأوسط، يمتلك خبرة مهنية تمتدُّ لأكثر من خمسةٍ وعشرين عامًا في مؤسسات دولية وأكاديمية مرموقة، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، وجامعة أكسفورد، وجامعة فينيسيا، وجنيف للدراسات العليا، والأكاديمية الدبلوماسية في فيينا، ومعهد الشرق الأوسط في سويسرا الذي أسّسه ويديره، كما يجمع بين خبرة تحليلية واسعة وخبرة ميدانية مباشرة؛ فهو مستشار استراتيجي لعددٍ من الجهات العامة والخاصة في أوروبا والشرق الأوسط، يساعدها على فهْم ديناميات المخاطر السياسية في الشرق الأوسط وبلدان الجنوب العالمي، يجانب ذلك يتمتع أيضًا بقدرة لغوية لافتة تشمل الإنجليزية والألمانية والفرنسية والعربية، إضافةً إلى دراسة اللغة الصينية، وعليه؛ فإن هذه الشبكة الواسعة من الخبرات والمؤسسات تمنحه موقعًا مميزًا يتيح له الاطلاع المباشر على آليات صنع القرار، وعلى النقاشات الدبلوماسية والاقتصادية التي تُعيدُ تشكيل المنطقة.[2]
مع ذلك، تُظهر قراءة التقرير أن خلفية الباحث ليست خلفية أكاديمية بحتة بقدْر ما هي خلفية “خبراء المخاطر” الذين يعملون في مساحة تفاعلية بين التحليل السياسي وتقدير المخاطر الاستثمارية، وهذا ينعكس بوضوح على طريقة بناء التقرير، الذي يبدو أقرب إلى مذكرة استشارية مُوَجَّهة لشركات البنية التحتية، منه إلى دراسة علمية مُحكّمة؛ فالأسلوب المتبع لكتابة التقرير اعتمد على عمل ميداني سريع استمر أسبوعين فقط، تخللته مقابلات وزيارات ميدانية لثماني مدن، وهي منهجية عملية وفعَّالة في التقاط الدلالات المباشرة من “الداخل السوري”، لكنها لا تُقدّم إطارًا نظريًّا واضحًا، ولا تشتغل على بيانات كمية أو مقاربات مقارنة كما تفعل الدراسات الأكاديمية في العلوم السياسية.
أمَّا على مستوى الحياد، يصعب النظر إلى التقرير كعمل “محايد” بالكامل؛ فالجمهور المستهدف واضح وهو شركات البنية التحتية والاستثمار الدولي، وهذا ينعكس في اللغة المستخدمة (حديث متكرر عن “فرص أول الداخلين”، “إمكانية تحويل المخاطر إلى مكاسب استراتيجية طويلة الأجل”)، وفي طريقة ترتيب الأولويات (تقدّم ملف الاستقرار الأمني والجدوى الاقتصادية على ملفات الحقوق، والعدالة الانتقالية، والمحاسبة). ومع ذلك، لا يعني هذا أن الباحث يقدّم صورة مثالية؛ بل يشير صراحةً إلى هشاشة المؤسسات في سوريا، والصراعات داخل أجهزة الدولة، واستمرار الفصائلية داخل الوزارات السيادية، لكن غالبًا بوصفها مخاطر يجب إدارتها، وليس كقضايا سياسية وأخلاقية تحتاج إلى معالجة جذرية.
ثانيًا: عرْض محاور التقرير وحججه الأساسية
ينقسم التقرير إلى مجموعة محاور مركزية، تعكس أبعاد المشهد السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد، ويمكن عرضها كالآتي:
1- جهود بناء الدولة وتحقيق الاستقرار
أحد أكثر أجزاء التقرير كثافةً هو القسم الخاص بـ “State-Building and Stabilization Efforts”؛ حيث يحاول الباحث تفكيك كيفية إدارة الحكومة الجديدة لعملية بناء الدولة بعد الحرب، ويقدم التقرير هنا صورة مُعقَّدة لدولة تحاول الجمع بين براغماتية شديدة في أدواتها وبين رغبة قوية في الاحتفاظ بالسيطرة.
وعليه؛ ينطلق التقرير من فكرة أن الحكومة اعتمدت استراتيجية متعددة المسارات تختلف من فئة إلى أخرى وهي كالآتي:
مع عناصر النظام السابق، خاصَّة في منطقة الساحل السوري والمناطق ذات الأغلبية العلوية، اختارت السلطة نهْج إعادة الإدماج التفاوضي؛ فبعد أحداث “تمرُّد” محدودة في مارس 2025، انتقلت من القمع المباشر إلى استخدام وسطاء من البيئة نفسها لإبرام اتفاقات عفْوٍ تسمح بعودة الضباط والعناصر إلى الحياة المدنية دون محاسبة، وهذه السياسة في قراءة الباحث تعكس تفضيل “الاستقرار السريع” على مسار عدالة انتقالية حقيقي، بما يحمله ذلك من تراكُم ملفات مظالم مؤجلة.
مع الفصائل المسلحة التي شاركت في الثورة أو في إدارة مناطق خارج سيطرة النظام السابق مثل (هيئة تحرير الشام HTS )، اختارت الحكومة مسار الدَّمْج العسكري بدل التفكيك؛ حيث إدخال المقاتلين في وحدات الجيش على نحو تدريجي، مع الإبقاء مؤقتًا على تماسُك الوحدات القديمة، ومحاولة تفكيك الهويات الفصائلية لصالح “هوية وطنية” على المدى المتوسط، والتقرير يشير هنا إلى دروس استخلصتها الحكومة من تجارب سابقة، مثل “أحداث السويداء، والساحل السوري”، حين أدى تفكيك ميليشيات بشكل سريع إلى فراغات أمنية.
لكن هذه السياسة تحمل تناقضها الداخلي؛ حيث الباحث يقرُّ أن وزارتيْ الدفاع والداخلية ما زالتا خاضعتين بدرجة كبيرة لـ “ثقافة قيادة فصائلية” أكثر منها “ثقافة بيروقراطية مؤسسية”، وأن غياب سلسلة قيادة “مدنية – عسكرية” مُوَحَّدة يعني أن عملية الدَّمْج قد تعيد إنتاج الفصائلية داخل مؤسسات الدولة، بدل أن تنهيها.
في الوقت نفسه، يرصد التقرير وجود بنية حكم مزدوجة؛ حيث يوجد وزارات رسمية تعمل إلى جانب هياكل ثورية موازية، أبرزها المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يترأسه فِعْلِيًّا حازم الشَّرْع (شقيق الرئيس أحمد الشرع)، ويتحكم في رسْم السياسات الاقتصادية الكبرى، بينما يبقى الوزراء التنفيذيون أقرب إلى “مديري تنفيذ” منه إلى صُنَّاع قرار، وعليه؛ فإن هذه الازدواجية تمنح النظام مرونةً في التحرُّك، لكنها تخلق أيضًا حالة ارتباك مؤسسي، وتضعف إمكانية بناء جهاز دولة راسخ بقواعد لعبة واضحة.
يُضافُ إلى ذلك صراع مستتر بين ثلاث كتل بشرية داخل الإدارة وهي؛ ( كوادر ثورية قادمة من إدلب وحكومة الإنقاذ السابقة، موظفو النظام السابق وأصحاب الخبرة التقنية، وكفاءات عائدة من الشَّتات تحمل خبرة دولية لكنها تعاني من أزمة ثقة متبادلة مع السلطة)، وعليه؛ كل هذا يجعل عملية بناء الدولة أقرب إلى “إدارة توازنــــــات” منها إلى مشروع مؤسسي متماسك.
2- الاقتصاد والقطاع الخاص: بين انتعاش جزئي وترسيم نخبوية إعادة الإعمار
يقدم المحور الثاني الذي يأتي تحت عنوان “Private Sector and Investment Climate” ، صورة مُفصَّلة نِسْبِيًّا عن عودة رأس المال السوري والدولي إلى السوق السوري، ويختار الباحث مثالًا دالًّا لشركة غذائية سورية كبرى تأسست عام 1986 في دمشق، توسَّعت لاحقًا إلى تركيا والإمارات ومصر وبولندا والولايات المتحدة، ثم عادت لتعيد تشغيل خطوط إنتاجها في دمشق، وتستحوذ وفْق تقدير التقرير على 80% من سوق اللحوم المعالجة داخل سوريا، وهذه الحالة تُقدَّم كنموذج لنمط من رأس المال العابر للحدود الذي يحتفظ بقنوات اتصال وثيقة مع السلطة الجديدة، ويستثمر عودته إلى الداخل للحصول على امتيازات سوقية واسعة.
كما يشير التقرير إلى لقاءات مباشرة بين كبار رجال الأعمال والرئيس أحمد الشرع، وإلى حالات “تبرع” بمئات الملايين من الدولارات لصالح هيئات حكومية (منها هيئة الاستثمار)، تُقرأ ليس كأعمال خيرية بل كـ”رهان سياسي” على النظام الجديد، وبوَّابة لشراء نفوذ مبكر في البنية الاقتصادية القادمة.
وعلى مستوى السياسة الاقتصادية، يُبرز التقرير أن الحكومة “تفتح الباب قانونياً أمام ملكية أجنبية بنسبة 100% ” في أغلب القطاعات، وتشجع دون إلزام على الشراكات مع شركاء محليين لزيادة الشعور بالأمان القانوني والسياسي لدى المستثمرين، ففي هذا السياق يذكر التقرير حضورًا سعوديًّا قويًّا في قطاعات العقار والحديد والإسمنت، وحضورًا تركيًّا في الطاقة والصناعة، واستثمارات إماراتية وصينية في الموانئ والبنية التحتية، مع إقبال “فرنسي – قطري” على الطاقة والبتروكيماويات.
في المقابل، يعترف الباحث بصراحة أن هذا الانفتاح يجري فوق أرضية مؤسسية ضعيفة تتمثل في الآتي:
تضخّم إداري هائل (في وزارة الاقتصاد وحدها أكثر من 60 ألف موظف، 20 ألف فقط منهم منخرطون فعليًّا في العمل).
تشريعات قديمة تعيق الاستثمار مثل التعميم رقم 10 الذي يمنع ترخيص مصانع خارج المناطق الصناعية التاريخية؛ ما يدفع الحكومة للالتفاف عليه بتحويل مصانع قديمة (كمعمل إطارات في حماة) إلى “مناطق صناعية أمر واقع”.
غياب بيانات دقيقة، ومحاولات متأخرة لبناء قاعدة إحصائية بالتعاون مع الإسكوا ووزارة التخطيط، والإعداد لتعداد سكاني جديد.
كما يعترف التقرير أيضًا بوجود توتر واضح بين مشاريع إعادة إعمار نخبوية مثل مشروع “Marota City” الفاخر في دمشقوبين أحياء مدمرة بالكامل كجوبر والقابون، التي تبقى خارج أولويات الاستثمار، وتُترك عمليًّا “مدنًا ميتةً تحت الركام”، وعليه؛ فإن هذا التفاوت، كما يشير الباحث، ينطوي على مخاطر تزايُد شعور قطاعات واسعة بالتهميش، وبالتالي تآكل شرعية السلطة الجديدة لدى من يُفترض أنهم المستفيدون الأساسيون من ” السلام”.
3- التحديات الداخلية البنيوية
يرصد المحور الثالث من التقرير، المعنون بــ “Key Internal Challenges”، أنّ العُقْدة البنيوية الأهم أمام ترسيخ الدولة الجديدة تتمثّل في واقع الشمال الشرقي الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (SDF)؛ فهذه المنطقة تُعدُّ – كما يصفها الباحث- “قلب سوريا الاقتصادي”؛ إذ تضم حقول النفط الرئيسة، وأراضي القمح الأساسية، إلى جانب بنية إدارية تشكّلت منذ عام 2013 على أساس حكمٍ ذاتيٍّ يمتلك مؤسسات أمنية واقتصادية وتعليمية مستقلة نسبيًّا، وبذلك تبدو قوات سوريا الديمقراطية، في قراءة التقرير، أكثر من مجرد ميليشيا مسلّحة، وأقرب إلى كيان شِبْه دولةٍ موازٍ لسلطة المركز.
وتتمسك قوات سوريا الديمقراطية برؤية لـ”فدرالية موسعة”، تمنحها استقلالية واسعة في الأمن والاقتصاد والتعليم داخل إطار دولة سورية مُوحَّدة نظريًّا، بينما تصرّ الحكومة على نموذج “إدارة محلية موسعة” تحت مركزية قوية، وتدار المفاوضات بين الطرفين، كما يوثّق التقرير، عبْر لجان موضوعية (أمن، تعليم، إدارة محلية، دمج عسكري)، لكن الباحث يرى أن خيار الحسْم العسكري لا يُستبعد تمامًا من جانب دمشق، خاصَّةً مع تعهُّد تركي بدعم أي عملية عسكرية مشتركة ضد قوات سوريا الديمقراطية إذا فشلت المفاوضات.
في المقابل، يقيم التقرير مقارنة مع حالة السويداء، التي يعالجها بوصفها منطقةً ذات وضْعٍ خاصٍّ يتسم بقدْرٍ من الاستقلالية الفعلية عن سلطة المركز، وإن دون موارد استراتيجية أو عمق مؤسسي يماثل ما تمتلكه قوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي، ويصف الباحث تعامُل الحكومة مع السويداء باعتبارها ملفًا ثانويًّا؛ حيث يوجد تراجُع ملحوظ في مستوى الخدمات، وحضور أمني محدود، وترك المجال لصراعات داخلية بين فصائل درزية متنافسة، بعضها يرتبط بقنوات خارجية غير مباشرة، بما فيها إسرائيل، وفي هذا السياق، تبدو السويداء “نقطة رمزية” أكثر مما هي تهديد وجودي للدولة، لكنها في الوقت نفسه، تكشف حدود قدرة الحكومة على فرْض السيادة الكاملة على كامل الجغرافيا السورية.
في الحالتيْن، يرى التقرير أن المعضلة الجوهرية تتمثل في “هل ستقبل الدولة بنموذج من اللامركزية الفعلية يفتح الباب أمام ترتيبات سياسية جديدة؟ أم ستنتقل عاجلًا أم آجلًا إلى محاولة إعادة فرض مركزية قسْرية تحمل في طيَّاتِها بذور جولة صراع جديدة؟”.
4- المقاتلون الأجانب
يُخصِّص التقرير محورًا كاملًا لملف “Foreign Fighters” انطلاقًا من كونه اختبارًا حاسمًا لقدرة الدولة الناشئة على بناء جهاز أمني وطني يتمتع بالشرعية والكفاءة؛ حيث يقدّر الباحث عدد المقاتلين الأجانب المتبقّين في سوريا بما يتراوح بين 10 و15 ألف مقاتل من جنسيات متعددة، من بينهم ما يقارب 4000 مقاتل من حزب تركستان الإسلامي . (TIP) ، ويشدّد التقرير على أن هذا الملف لا يمكن التعامل معه بوصفه تهديدًا أمنيًا داخليًا فحسب، بل باعتباره أيضًا ملفًا دوليًا شديد الحساسية؛ نظرًا لارتباطه المباشر بمواقف دول كبرى وإقليمية، مثل حساسية الصين تجاه المقاتلين الأويغور، والهواجس الأوروبية من احتمال “عودة المقاتلين” ، والمخاوف الإقليمية خصوصًا في السعودية وتركيا من إعادة تشكّل شبكات جهادية عابرة للحدود.
ومن ثَمَّ، يصبح ملف المقاتلين الأجانب، كما يعرضه التقرير، معضلة تتجاوز القدرات الأمنية التقليدية، وتتطلب إدارة دقيقة توازن بين ضرورات الأمن الداخلي ومتطلبات العلاقات الخارجية.
ويمكن تلخيص سياسة الحكومة في هذا الملف، وفْق التقرير، في عبارة”Containment through Integration”؛ أيْ الاحتواء عبْر الدَّمْج، لا عبر التصفية أو الترحيل؛ فالمقاتلون لا يُسمح لهم بالبقاء ككتل منظمة ذات وضْعٍ قانونيٍّ خاصٍّ، لكن في الوقت نفسه، لا يُزالون من المشهد، بل يُعاد توزيعهم كأفراد داخل وحدات عسكرية متخصصة، أو يدمجون في وظائف مدنية وتجارية، مع الإبقاء عليهم تحت رقابة أمنية مشددة ومن دون حقوق سياسية كاملة (لا جنسية كاملة، ولا قدرة على التنظيم السياسي المستقل).
ويتوقف التقرير بالتفصيل عند حالة الحزب الإسلامي التركستاني، بوصفها الأكثر حساسية؛ حيث هناك مساعٍ في البحث عن “مخرج آمن” يسمح بتحويل التنظيم من جماعة مسلّحة إلى كيان مدني / سياسي صوري، يُطَمْئن الصين بأن هؤلاء لن يشكّلوا تهديدًا لأمنها القومي، ويُجنِّبُ في الوقت ذاته سيناريوهات ترحيل قسْري قد تُشعل جبهة جديدة من العنف، خاصَّةً أن كثيًرً من هؤلاء المقاتلين أسسوا حياة اجتماعية وعائلية في سوريا، بما يجعل اقتلاعهم أكثر تعقيدًا من مجرد إجراء أمني.
يرى الباحث أن هذه السياسة حقَّقت حتى الآن “Buying Time”؛ أيْ شراء وقت إضافي وتأجيل الانفجار، لكنها لا تعني بناء جهاز أمني موحّد، بل قد تتحوَّلُ إذا لم تُستكمل بإصلاحات عميقة إلى “Fragmentation Disguised as Consolidation”؛ أيْ حالة من التشرذم المقنّع بمظهر من مظاهر التماسك، بحيث تستمر البُنى الفصائلية في العمل داخل إطار الدولة من دون أن تُعالج جذورها.
5- السياسة الخارجية: شبكة معقدة من الرهانات المتقاطعة
يحاول التقرير في محور “External Diplomatic Engagements” ، رسم خريطة العلاقات الخارجية لسوريا الجديدة، ويقدّم صورة لافتة لمستويات متعددة من الانخراط:
مع الولايات المتحدة (في ظل إدارة ترامب)، يسجّل التقرير “تقدمًا مفاجئًا” في العلاقات، متمثلًا في عقود بنية تحتية واستعداد أمريكي لفتْح قاعدة عسكرية في دمشق، وفْق ما ينقله الباحث عن مصادره، هذا التحوُّل يُقرأ على أنه انتقال من مقاربة “تغيير النظام” إلى مقاربة “احتواء واستثمار”؛ حيث تصبح سوريا شريكًا في توفير الاستقرار مقابل منح امتيازات اقتصادية واستراتيجية.
مع روسيا، يحكم المشهد حسابات سياسية أكثر من التقارب الفعلي؛ فالرئيس الشرع يزور موسكو بهدف تأمين استمرار الدعم في مجلس الأمن، إلا أنّ رفْض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسليم بشار الأسد إلى الحكومة السورية الجديدة يُبقي هذا الملف مفتوحًا ومعلّقًا في الذاكرة السياسية السورية، ويكشف في الوقت ذاته عن حدود النفوذ الروسي في المرحلة الجديدة، وعن المساحة الضَّيِّقة التي يمكن لموسكو أن تناور ضمنها في الملف السوري.
مع الصين، تختزل العلاقة بين البلدين إلى حدٍّ كبيرٍ في ملف الأويغور؛ حيث بكين تُنظَر إليها شريكاً محتملًا في موانئ وبنية تحتية، لكنها في الوقت ذاته مصدر ضغط بسبب إصرارها على ضمان تحييد المقاتلين الأويغور.
مع السعودية، يصف التقرير علاقة استراتيجية عميقة، تتجاوز منطق الجدوى الاقتصادية؛ الاستثمارات التي تضخها الرياض في سوريا تُقرأ كرهانٍ سياسيٍّ على النظام الجديد، وكآلية لتقييد حرية الحركة الإسرائيلية في استهداف الداخل السوري، من خلال خلْق “كلفة سعودية” لأيِّ تصعيد إسرائيلي كبير، وفي هذا السياق، يلعب مجلس الأعمال السعودي السوري الذي ترعاه شخصيات قريبة من ولي العهد دورًا محوريًّا في هذا المسار.
مع قطر، فتقدّم دعمًا ماليًّا ملحوظًا، غير أنّ محاولاتها فرض شروط مشددة على بعض المشاريع الكبرى دفعت الحكومة السورية إلى تنويع شراكاتها الإقليمية والدولية، تفاديًا لأيِّ شكْل من أشكال الاعتماد الأحادي أو ارتهان القرار الاقتصادي لصالح طرف بعينه.
مع تركيا، تُعدُّ أنقرة الدولة الأكثر ارتباطًا بسوريا في المرحلة الراهنة، إذ تُحافظ على العلاقة الأقرب والأكثر تداخُلًا معها. ورغم ذلك، تحرص الحكومة السورية الجديدة على عدم الانزلاق إلى موقع الدولة التابعة لأنقرة، وتسعى إلى إدارة العلاقة ضمن إطار يضمن لها هامش استقلالية معتبر، وتشهد العلاقة تنسيقًا عسكريًّا وسياسيًّا منتظمًا، يتضمّن برامج تدريب للضباط السوريين داخل تركيا.
وبجانب ماسبق، يبقى الحضور الأوروبي في المشهد السوري محدودًا مقارنةً بالفاعلين الآخرين؛ إذ ما تزال الاعتبارات الحقوقية لدى دول الاتحاد الأوروبي تشكّل عاملًا مُعقَّدًا يحدُّ من مستوى الانخراط السياسي والاقتصادي المباشر، ومع ذلك، يشير التقرير إلى استمرار التعاون الفني والتقني في عدد من القطاعات المحددة، وهو تعاون لا يرتقي إلى مستوى الشراكة السياسية الشاملة، لكنه يعكس رغبة أوروبية في إبقاء قنوات التواصل مفتوحة دون التخلِّي عن تحفُّظاتها الأساسية.
وتأسيسًا على ما سبق، فإن هذه الشبكة المُعقَّدة تجعل من السياسة الخارجية السورية مشروع موازنة دقيق بين مصالح متناقضة، وتفتح أيضاً الباب أمام توترات مستقبلية إذا تباينت أجندات هذه القوى أو دخلت في صدام مباشر.
6- مقاربة العلاقة مع إسرائيل
أخيرًا، في محور “Approach towards Israel”، يسلّط التقرير الضوء على تحوّلٍ جذريٍّ في الخطاب الرسمي السوري تجاه الاحتلال الإسرائيلي للجولان، فلم تعُدْ القضية تُقدّم بوصفها ملف “تحرير وطني” بقدْر ما تُصاغ كـ”قضية قانونية” هدفها العودة إلى خطوط اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبْر تعبئة دعم دولي وعربي (خاصة من السعودية) للضغط على إسرائيل، بدل طرح سيناريوهات مواجهة عسكرية مباشرة.
ويعتبر التقرير أن هذا التحوُّلَ يعكس إدراك الحكومة لمحدودية قدراتها العسكرية، وحرصها على عدم فتْح جبهة واسعة مع إسرائيل في ظل انشغالها بترميم الداخل، لكنه يعكس أيضًا انتقالًا من خطاب “الممانعة” إلى خطاب “إدارة نزاع معقَّد” بأدوات سياسية وقانونية، وهنا يظهر بوضوح وزن الدور السعودي في التوسُّط مع واشنطن، وتقديم سوريا بوصفها “رهان استقرار” لا “مصدر تهديد”.
ثالثًا: الرؤية النقدية
بعد هذا العرض لمحاور التقرير، يمكن الانتقال إلى قراءة تحليلية نقدية تُوازن بين تقدير القيمة المعلوماتية التي يقدّمها، وبين فحْص الجوانب التي يعالجها التقرير بدرجة أقلّ من التفصيل أو يتناولها بقدر من التحفُّظ، ويتيح هذا المستوى من القراءة تقييم مدى اتساق التقرير مع أهدافه المعلنة، وحدود مقاربته، وما يضيفه فعليًّا إلى فهْم المشهد السوري، مقارنة بما يبقى خارج إطار تحليله.
أ- عناصر القوة: قيمة ميدانية وتحليل مركّب لبنية الدولة
أبرز ما يُحسب للتقرير أنه يكسر نمط القراءة من الخارج؛ فالباحث لا يكتفي بتحليل الخطابات الرسمية أو تتبُّع تقارير المنظمات الدولية، بل ينزل إلى الميدان، يجلس مع نواب وزراء، ويزور المصانع والمناطق صناعية، يلتقي بمسؤولين في وزارة الثقافة يتحدثون عن “عدالة ثقافية” تشمل الكُرْد والتركمان والشركس، ويعاين بنفسه مشاريع عمرانية نخبوية تأخذ مساحات كبيرة في دمشق بينما تبقى أحياء بكاملها خارج مخططات الإعمار، وهذه التفاصيل الصغيرة هي ما يمنح التقرير قوة توثيقية يصعب تجاهلها.
كذلك يُحسب له أنه يقرأ بنية الدولة الجديدة بوصفها ساحة صراع بين ثلاث ثقافات تنظيمية وهي؛ (ثقافة ثورية قادمة من إدلب، ثقافة بيروقراطية قديمة مؤسسة على أوامر وتعليمات، وثقافة تكنوقراطية عابرة للحدود يحملها العائدون من الشتات).
هذا الوعي بالتعدُّد داخل “الدولة الجديدة الناشئة” يبعد التقرير عن اختزال السلطة في شخص الرئيس أو دائرة صغيرة حوله، ويقدّم صورة أكثر واقعية عن تعقيد عملية بناء مؤسسات بعد سقوط النظام.
أخيراً، يشكّل التحليل الموسّع لملف المقاتلين الأجانب نقطة قوة، لأنه يتحرر من ثنائية “الإرهاب / ومكافحة الإرهاب” السائدة في الخطاب الغربي، ويُظهر كيف أن كل مجموعة من هؤلاء المقاتلين محمولة على شبكة مصالح متشابكة مع دول شتَّى (الصين، تركيا، السعودية، أوروبا)، ما يجعل الملفَّ ملفًّا سياسيًّا بقدْر ما هو ملفٌّ أمنيٌّ.
ب- حدود المقاربة: تغليب منظور المستثمر وتهميش البعد الحقوقي والاجتماعي
مع ذلك، فإن القراءة المتأنية للتقرير تكشف عددًا من الحدود الجوهرية في مقاربته ويمكن عرضها كالآتي:
1- المنظور الاستثماري المهيمن: التقرير في جوهره يتضح أنه موجه بالأساس إلى شركات البنية التحتية والمستثمرين الدوليين الباحثين عن “فرصة” في سوق إعادة الإعمار، وينعكس ذلك بوضوح في طريقة مقاربة المخاطر؛ إذ تُعادُ صياغة كل تهديد سواء تعلق الأمر بـSDF أو الفصائل المسلحة أو المقاتلين الأجانب أو حتى العلاقة مع إسرائيل، بوصفه عاملًا ضمن معادلة “المخاطر القابلة للإدارة”، وليس كقضية سياسية أو أخلاقية لها امتدادات اجتماعية وتاريخيى عميقة، وفي هذا الإطار، يغيب عن التقرير أيُّ نقاش جاد لأسئلة محورية، مثل “من المستفيد الحقيقي من موجة الاستثمارات المتوقعة؟ كيف ستنعكس هذه المشاريع على توزيع السلطة والثروة داخل المجتمع السوري؟ وهل تسهم، عن قصد أو من غير قصد، في إعادة إنتاج نخبة ضيقة تجمع بين رأس المال والنفوذ السياسي، بينما يُدفع الفئات الأوسع من المجتمع إلى الهامش أو تُترك في مناطق لم يصلها الإعمار أصلًا؟”.
2- غياب العدالة الانتقالية من المشهد تقريبًا: رغم إشارات عابرة إلى غياب المحاسبة، فإن التقرير لا يعالج بجدية مسألة الانتهاكات، ولا مصير المعتقلين، ولا سؤال العدالة للضحايا، كل ما يرد في هذا السياق هو اعتراف بأن الحكومة اختارت “عدم التطهير الشامل” لجهاز الخارجية، والسماح لـ 60–70% من كوادره بالبقاء، لكن لا نقاش لسؤال ما الذي يعنيه بناء دولة جديدة فوق أرضية لم تحسم فيها حسابات الماضي، لا قضائيًّا ولا سياسيًّا؟
3- الاقتصــــــاد “من فــــــــــوق”: يركز التقرير على الشركات الكبرى، المصانع، اولاستثمارات الخليجية والصينية والأمريكية، بينما يبقى الاقتصاد الشعبي- أي الأنشطة الاقتصادية الصغيرة وغير الرسمية التي يعتمد عليها الجزء الأكبر من السوريين في حياتهم اليومي – في الهامش، وهذا يجعل الصورة التي يقدمها عن “إمكانيات السوق” جزئية ومنحازة للفوق الاجتماعي.
غياب سيناريوهات الفشل في ملفات حساسة: تبدو بعض تعبيرات التقرير مائلة إلى التقليل من احتمالية الانفجار؛ فمثلاً، في ملف قوات سوريا الديمقراطية، لا يُناقش بجدية سيناريو انهيار المفاوضات وتحول “الوعد التركي بالدعم” إلى عملية عسكرية واسعة.
وفي ملف المقاتلين الأجانب، لا يُوجد إلا اعترافٌ عامٌّ بأن الدَّمْج “يشتري الوقت”، دون تحليل حقيقي لما قد يعنيه انفجار هذا الملف إذا تغيرت موازين القوى المحلية أو الإقليمية.
العلاقة مع إسرائيل خارج سياق الصراع الأوسع: يعالج التقرير علاقة سوريا مع إسرائيل في إطارٍ ضيِّقٍ يركز على خطوط فض الاشتباك لعام 1974، وجود خمس نقاط عسكرية على جبل الشيخ، دور السعودية في تهدئة واحتواء التصعيد عبْر الولايات المتحدة، ورغبة واشنطن في الحفاظ على قدْر من الاستقرار الحدودي، غير أن هذا التناول يظلُّ معزولًا عن السياق الإقليمي الأوسع؛ إذ لا يربط التقرير هذه التطورات بمسارات احتمال التطبيع مع اسرائيل، ولا بما يشهده الإقليم من تحوّلات في ساحات مرتبطة مباشرة بالصراع مع إسرائيل (فلسطين، لبنان، اليمن، العراق)، كما لا يطرح أيَّ مساءلة جادَّة لثمن الانتقال من خطاب “المقاومة” إلى خطاب “إدارة نزاع قانوني” بالنسبة للهوية السياسية لسوريا، ولتموْضعها في معادلة الصراع الإقليمي، وهذا القصور يجعل القراءة التي يعرضها التقرير منقوصة ومُجَزَّأة، ولا تعكس ديناميات التحوُّل الكبرى التي يعاد بموجبها تشكيل العلاقة “العربية – الإسرائيلية” اليوم.