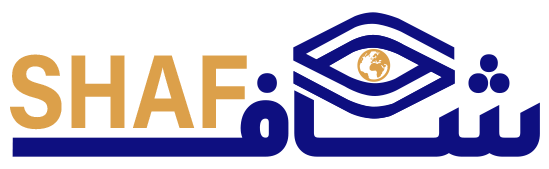المقالات
مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية > تقارير وملفات > وحدة الدراسات التركية > قراءة تحليلية لتقرير بعنوان: Beyond Gaza: The Strategic Fault Lines in Turkey–Israel Relations.
قراءة تحليلية لتقرير بعنوان: Beyond Gaza: The Strategic Fault Lines in Turkey–Israel Relations.
- أكتوبر 27, 2025
- Posted by: ahmed
- Category: تقارير وملفات وحدة الدراسات التركية
لا توجد تعليقات

إعداد/ أماني السروجي
باحث في برنامج دراسات الدول التركية
تُعدّ العلاقاتُ التركية–الإسرائيليةُ من أكثر العلاقات الإقليمية تعقيدًا وتقلّبًا، إذ تجمع بين تاريخٍ طويلٍ من التعاون الاقتصادي والأمني وبين فتراتٍ متكررةٍ من التوتّر السياسي والصدام الدبلوماسي، وقد اكتسبت هذه العلاقة خلال العامين الأخيرين بُعدًا جديدًا في ظل التحولات الجذرية التي شهدتها البيئة الأمنية في الشرق الأوسط، خاصةً مع تصاعد حدّة الحرب في غزة واتّساع رقعة التدخلاتِ العسكرية الإسرائيلية في أكثر من ساحةٍ عربيةٍ وإقليميةٍ. ومع هذه التحولات، لم تعدْ العلاقة بين أنقرة وتل أبيب تُقاس فقط بحدّة الخطاب السياسي أو بمستوى التمثيل الدبلوماسي، بل باتت تُجسّد انعكاسًا مباشرًا لإعادة توزيع موازين القوى وإعادة تعريف الطرفين لمفهوم الأمن الإقليمي ودورهما ضمن النظام الدولي الآخذ في التشكل.
وفي هذا الإطار، يمكن النظر إلى التنافس التركي–الإسرائيلي باعتباره شبكةً معقّدةً من التفاعلات الاستراتيجية التي تمتد إلى مجالات الأمن والطاقة والنفوذ الجيوسياسي والمكانة لدى الفاعليين الدوليين. ويتخذ هذا التنافس في الغالب طابعًا غير مباشر، حيث يتجلّى في سباقٍ على النفوذ داخل مناطق متشابكة مثل شرق المتوسط والقرن الإفريقي وآسيا الوسطى، ويتقاطع مع مصالح فاعلين إقليميين ودوليين آخرين، ما يمنحهُ طابعًا ديناميكيًا يتجاوز حدود الاشتباك الثنائي بين الطرفين.
كما لا يقتصرُ الأمرُ على تضارب المصالح فحسب، بل يمتد إلى تناقضٍ أعمق في الرؤى الأمنية وآليات إدارة الصراعات في المنطقة، الأمر الذي يجعله أحد المحددات الرئيسية في مسار استقرار الشرق الأوسط واتجاهاته المستقبلية، ويبرز الحاجة إلى تتبّع الكيفية التي انتقل بها التفاعل بين البلدين من خلافٍ دبلوماسيٍ محدودٍ إلى مواجهةٍ استراتيجيةٍ متعددةِ المستويات، تتداخل فيها الاعتبارات الإنسانية مع الحسابات الجيوسياسية وموازين القوى.
وفي هذا السياق، صدر تقرير بعنوان “Beyond Gaza: The Strategic Fault Lines in Turkey–Israel Relations” عن المركز العربي في واشنطن (Arab Center Washington DC)، للباحث سليم تشيفيك (Salim Çevik)، تناول فيه ملامح التوتر المتصاعد بين تركيا وإسرائيل بعد حرب غزة، مقاربًا العلاقة من منظور استراتيجي يتجاوز الحدث العسكري المباشر إلى قراءة أوسع لبنية الصراع الإقليمي.
وينطلق سليم من فرضيةٍ أساسيةٍ مفادها أن العلاقة بين أنقرة وتل أبيب لم تعدْ مجرد خلافاتٍ دبلوماسيةٍ حول غزة، بل تحوّلت إلى مواجهةٍ جيوسياسيةٍ شاملةٍ تشمل ملفاتٍ إقليميةً كبرى: سوريا، إيران، وقطر، وفي حين كانت الحرب في غزة بمثابة الشرارة، إلا إنها ليست جوهر الأزمة، إذ يوضح الباحث كيف تحوّل الأمر من احتجاجات إنسانية إلى تحدٍ مباشر يمسّ مكانة أنقرة الأمنية والسياسية. كما يستعرض التقرير أبرز ساحات الاشتباك الإقليمي بين الطرفين، مع تحليلٍ للقيود البنيوية التي تحدّ من انزلاق العلاقة إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
أولاً: تحوّل منطق التوتر – من الأخلاقي إلى الأمني
يبدأ التقرير بتفكيك التحول في الموقف التركي من الحرب الإسرائيلية على غزة، موضحًا أنه بدأ كاستجابةٍ أخلاقيةٍ وإنسانيةٍ للضغط الشعبي الداخلي، حيث ركز أردوغان على إدانة المأساة الإنسانية دون تبنّي إجراءاتٍ قاسية ضد تل أبيب. غير أن تصاعد الغضب الشعبي دفع الحكومة إلى خطوات رمزية مثل إغلاق الأجواء أمام الطيران الإسرائيلي وتعليق التجارة، رغم أن هذه الإجراءات بقيت محدودة من الناحية العملية.
لكن مع اتّساعِ النشاطِ العسكري الإسرائيلي في الإقليم، تحوّل الموقف التركي من الدفاع عن قضيةٍ إنسانيةٍ إلى ردٍّ على تهديد مباشر لمصالحها الأمنية، فإسرائيل لم تكتفِ بعملياتها في غزة، بل وسّعت نطاق ضرباتها لتشملَ إيران وسوريا وقطر، وهي مناطق ترى فيها أنقرة امتدادًا طبيعيًا لنفوذها الإقليمي، عند هذه النقطة، لم يعدْ الخلاف مسألة “قيمة أخلاقية”، بل أصبح صراعًا على موازين القوة في الشرق الأوسط.
ثانيًا: منطق التصعيد المختلف
يرى تشيفيك أن الأزمة الراهنة تستند إلى منطقين متوازيين للتصعيد:
تصعيدٌ رمزيٌ–شعبي مرتبط بملف غزة، حيث تستخدم أنقرة الملف لاسترضاء الرأي العام وتأكيد دورها الأخلاقي في الدفاع عن الفلسطينيين.
تصعيدٌ استراتيجي–إقليمي يرتبط بتنامي النفوذ الإسرائيلي في محيط تركيا المباشر، لا سيَّما سوريا، وهو ما تعتبره أنقرة تهديدًا فعليًا لأمنها ومكانتها كقوة إقليمية.
بهذا المعنى، تجاوزت الأزمة طبيعتها الخطابية إلى تجسيد تناقض أعمق في الرؤى الاستراتيجية بين البلدين حول شكل النظام الإقليمي ومستقبل مراكز النفوذ فيه.
ثالثًا: أبرز ساحات التصعيد الإسرائيلي والتباينات الاستراتيجية بين البلدين
يشير الكاتب إلى أن التوتر التركي–الإسرائيلي لم يعدْ محصورًا في أزمة غزة الإنسانية، بل امتد ليشملَ تصعيدًا مباشرًا في ملفاتٍ إقليميةٍ حساسةٍ تمثّل نقاطًا استراتيجية لتنافس النفوذ في الشرق الأوسط، ويعرض كل دولة على حدة لإبراز الطبيعة المختلفة للتحدي الذي تمثّله كل ساحةٍ بالنسبة لأنقرة.
سوريا:
يقدّم التقرير قراءةً لساحة التنافس السوري، باعتبارها أكثر ملفات الخلاف حساسية بين أنقرة وتل أبيب، فمع ملامح النظام الجديد في دمشق بعد سقوط الأسد، تعتبر تركيا أن سوريا تمثّل منطقةَ النفوذ الأكثر أمانًا لتوسيع حضورها الإقليمي، إذ تسعى إلى إعادة بناء الدولة السورية عبر مؤسساتٍ مركزيةٍ قويةٍ وجيشٍ منضبطٍ قادرٍ على بسط الأمن، بما يتيح لها لَعِبَ دورٍ محوريٍ في مرحلة إعادة الإعمار من خلال شركاتها وخبرتها التقنية، على أن تموَّل العملية بأموال خليجية وغربية.
في المقابل، تعتمد إسرائيل رؤيةً مناقضة تمامًا، تقوم على إبقاء سوريا ضعيفة ومجزأة، على نحوٍ يشبه الحالة اللبنانية، بحيث لا تتشكل فيها بنيةٌ عسكريةٌ قادرةٌ على تهديدها، ولهذا تواصل إسرائيل شنّ غارات على مواقع عسكرية سورية، وتوسّع احتلالها في الجولان، وتقدم نفسها كـحامٍ للأقليات لتبرير تدخلاتها.
ويبرز أن هذا التباين الحاد جعل من سوريا ساحة صراعٍ غير معلنٍ بين أنقرة وتل أبيب، حيث بدأت تركيا تدريب القوات السورية وتقديم دعم أمني محدود، فيما استهدفت إسرائيل مواقع يُعتقد أن أنقرة تخطط لاستخدامها كقواعد عسكرية مستقبلية، ومع ذلك، حرص الطرفان على تجنّب المواجهة المباشرة، مع وجودِ قنواتٍ خلفية للتنسيق – خاصةً عبر أذربيجان – للحفاظ على مستوى من “إدارة التنافس” دون الانزلاق إلى صدام مفتوح.
إيران:
يُظهر تشيفيك أن علاقة تركيا بإيران تقوم على مزيجٍ من التنافس والتوازن، فمن جهة، ترى أنقرة أن إضعاف النفوذ الإيراني في سوريا والعراق ولبنان يخلق لها مساحةً أوسع للنفوذ السياسي والعسكري، ومن جهة أخرى، فهي تعتبر استهداف إيران بشكلٍ مباشرٍ تجاوزًا للخطوط الحمراء، لأنه يهدد استقرار الإقليم بأسره ويُفقد تركيا شريكًا ضروريًا في معادلات الطاقة والأمن.
وبينما لا تمانع تركيا ضمنيًا في الضربات الإسرائيلية ضد ميليشيات إيران في سوريا ولبنان، فإنها تعارض الهجمات المباشرة على الأراضي الإيرانية، لأنها تفتح الباب أمام فوضى إقليمية غير محسوبة، وهنا تتقاطع رؤيتها مع مواقف دول الخليج التي تشاركها العداء لإيران، ولكنها تفضّل “إدارة التوازن” لا إسقاط النظام الإيراني.
قطر:
يُعتبرُ تشيفيك أن الضربةَ الإسرائيلية على قطر في سبتمبر الماضي كانت المنعطفَ الأخطرَ في العلاقات التركية–الإسرائيلية، لأنها استهدفت الحليف الأوثق لتركيا في الخليج. فالعلاقة بين أنقرة والدوحة تتجاوزُ التحالف السياسي إلى شراكةٍ اقتصاديةٍ وأمنيةٍ عميقةٍ، ترتبط بملفات ليبيا والبحر الأحمر والتمويل المشترك.
من وجهة النظر التركية، فإن مهاجمةَ دولة تعتبر “حليفًا رئيسيًا لواشنطن خارج الناتو” تعني كسر أحد المحرّمات الإقليمية، وتكشف استعداد إسرائيل لتجاوز كل القيود التي كانت تضبط سلوكها حتى تجاه حلفاء الولايات المتحدة. هذا الحدثُ – بحسب المقال – لم يهزّْ فقط أنقرة، بل أضعف ثقة معظم دول المنطقة في المظلّة الأمنية الأمريكية، بعدما فشلت واشنطن في ردْعِ إسرائيل أو حماية قطر رغم وجود قواعدها على أراضيها.
رابعًا: مسار مستقبل التوتر في العلاقات التركية الإسرائيلية
محددات التصعيد وضوابطه الاستراتيجية
على الرغم من حدّة الخطاب السياسي، يؤكد تشيفيك أن التصعيد التركي–الإسرائيلي لا يزال مضبوطًا بسقفٍ استراتيجيٍ يمنع تحوّله إلى صدام مباشر. فتركيا، رغم تصاعد لهجتها، ما تزال جزءًا من النظام الغربي وعضوًا فاعلًا في حلف الناتو، ولا ترغب في الخروج من هذا الإطار على الرغم من شكوكها العميقة تجاه فعالية الحلف.
حيث يشير إلى أن ثقةَ أنقرة في الناتو تراجعت بعد مواقف الحلْف الغامضة في أزماتٍ سابقةٍ، مثل حادثةِ إسقاط الطائرة الروسية عام 2015 ومقتل الجنود الأتراك في إدلب عام 2020. وقد دفعت هذه السوابق صانعي القرار في أنقرة إلى الشكِّ في مدى التزام الحلف بالدفاع عنها في حال نشوب مواجهة مع إسرائيل، لا سيّما إن وقعت داخل الأراضي السورية.
في المقابل، تُدرك إسرائيل أن تركيا تمتلكُ قدراتٍ عسكريةً لا يُستهان بها، ما يجعل خيار المواجهة المباشرة محفوفًا بالمخاطر، ومع ذلك، تبقى احتمالات الاحتكاك غير المقصود قائمةً في الساحة السورية، إذ يمكن لغارة إسرائيلية أن تُصيبَ مواقعَ تركيةً دون قصدٍ، الأمرُ الذي قد يفتح الباب أمام تصعيد غير محسوب.
ويضيف الكاتب أن القيود العسكرية التي تواجهها تركيا – كإقصائها من مشروع الطائرة F-35 وتأخر تحديث أسطول F-16 – تدفعها إلى تفضيل الردود السياسية والرمزية على المواجهة الميدانية، من خلال خطابٍ حادٍ وإجراءاتٍ دبلوماسيةٍ دون الانزلاق إلى تصعيد فعلي.
الديناميات الداخلية ودورها في تأجيج التوتر
يُبرز تشيفيك بُعدًا داخليًا مهمًا في تفسير استمرار التوتر، إذ يرى أن كلاً من أردوغان ونتنياهو يوظّف الأزمة مع الطرف الآخر لتعزيز موقعه الداخلي، فـأردوغان يستخدم القضية الفلسطينية لاستعادة شعبيته التي تراجعت بفعل الأزمةِ الاقتصادية والانتكاسات الانتخابية، مستندًا إلى خطابٍ حادٍ ضد إسرائيل يعيد تعبئة قاعدته الإسلامية والقومية، دون الدخول في مغامرةٍ عسكريةٍ مكلّفةٍ.
بينما يستثمر نتنياهو في منطق “التهديد الخارجي” للحفاظ على تماسك قاعدته اليمينية وسط الانقسامات الداخلية بشأن الإصلاح القضائي واتهامات الفساد، فيُسهم التصعيد مع تركيا في ترسيخ سردية “الحصار الدائم” وإعادة إنتاج صورته كرجل الأمن القادر على مواجهة الخصوم.
وهكذا، يغدو التصعيد بين الطرفين أداةً سياسيةً داخليةً أكثر منه خيارًا استراتيجيًا في السياسة الخارجية، إذ يستفيد كلٌّ من أنقرة وتل أبيب من بقاء الأزمة مفتوحة لأنها تمنحهما رأسمالًا سياسيًا أمام جمهور مضطرب داخليًا.
خامسًا: أبرز تداعيات التصعيد الإسرائيلي على بنية النظام الأمني الإقليمي
في الختام يذهب تشيفيك إلى أن التطورات الأخيرة تمثّل نقطةَ انعطاف في النظام الأمني الإقليمي، إذ أدّى تصاعد الهجمات الإسرائيلية على كلٍّ من إيران وقطر إلى تقويض ما كان يُعرف سابقًا بـ”الخطوط الحمراء” التي ضبطت سلوك الدول لعقود، فلم تعدْ هناك ضماناتٌ لعدم استهداف دولٍ ذات سيادة، كما لم تعدْ التحالفاتُ التقليدية – وعلى رأسها التحالف مع الولايات المتحدة – توفر الحماية أو الردع الفعلي كما في السابق.
هذا التآكل في منظومة الردع الإقليمي دفع العديدَ من دول المنطقة إلى انتهاجِ سياساتٍ أكثر استقلالية وتحوطًا، مثل توقيع اتفاقاتٍ أمنيةٍ جديدة – كالاتفاق بين السعودية وباكستان – أو العمل على تطوير القدرات الدفاعية الذاتية كما تفعل تركيا عبر تعزيز صناعاتها العسكرية وتقليل اعتمادها على الغرب. وتكشف هذه التحركات عن قناعةً متزايدةً لدى العواصم الإقليمية بأن الولايات المتحدة لم تعدْ قادرةً أو راغبةً في ضبط إيقاع أزمات المنطقة.
ويحذّر الكاتب من أن استمرار هذا المسار قد يجعل إسرائيل الطرف الأكثر تحكّمًا في وتيرة الأحداث، في ظل غيابِ رادعٍ أمريكيٍ أو توازنٍ إقليميٍ فاعل، ما يفتحُ الباب أمام سلسلةٍ من الأزمات غير المحسوبة التي قد تبدأ في سوريا أو الخليج وتمتد آثارها إلى النظام الدولي ككل.
سادسًا: أبرز الاستنتاجات
لم يعدْ الخلاف التركي–الإسرائيلي مرتبطًا بالحرب في غزة أو الاعتبارات الإنسانية، بل تحوّل إلى صراعٍ أعمق حول النفوذ الإقليمي وإعادة تعريف موازين القوى في الشرق الأوسط.
تمثّل الساحاتُ الثلاثة ( سوريا وإيران وقطر) الأبعاد المختلفة للتصعيد الإسرائيلي ضد مصالح تركيا الإقليمية، إذ تمثّل سوريا ساحةَ نفوذٍ استراتيجية على الأرض، حيث يتركز الصراع على التنافس العسكري والسياسي المباشر على الأرض، بينما تمثّل إيران خطًا أحمر استراتيجيًا، حيث تُركز تركيا على توازن القوى وتتفادى أي تصعيد إقليمي واسع، وإما عن قطر فهي حليفًا حساسًا وذو رمزية سياسية ودبلوماسية كبيرة.
تآكل منظومةِ الردع والتحالفات التقليدية: حيث يشير تشيفيك إلى أن الضمانات الأمنية الغربية – سواء المظلة الأمريكية أو حلف الناتو – فقدت كثيرًا من مصداقيتها في نظر أنقرة والعواصم الإقليمية، وقد دفع ذلك إلى سياساتٍ أكثر استقلاليةً وتحوطًا، مثل تعزيز الصناعات الدفاعية الوطنية أو تنويع الشراكات الأمنية خارج الغرب.
استمرار الضبط الاستراتيجي للتصعيد: فعلى الرغم من تصاعد الخطاب العدائي، يبقى الطرفان محكومين باعتباراتٍ الردع والحذر؛ فتركيا لا ترغب في مواجهة عسكرية مع إسرائيل، وإسرائيل تدركُ كُلفةَ الاشتباك مع قوةٍ إقليمية بحجم تركيا، لكن خطر التصعيد غير المقصود، خصوصًا في الساحة السورية، يظل قائمًا.
تسييس التوتر داخليًا: حيث يُعدّ العامل الداخلي أحد أهم محركات استمرار الأزمة.
إعادة تشكيل البيئة الإقليمية: حيث يُبرز التقرير أن استمرارَ تآكل الخطوط الحمراء، وتراجع الردع الأمريكي، وصعود المبادرات الأمنية الذاتية، كلّها مؤشراتٌ على تشكّل نظامٍ إقليميٍ جديد أكثر فوضوية وأقل قابلية للضبط، وفي هذا السياق يرى الكاتب أن إسرائيل ستظل لاعبًا مهيمنًا على إيقاع الأزمات، بينما تتحرك تركيا لتثبيت موقعها عبر مزيج من الحذر والتحدي.
سابعًا: تأملات نقدية
رغم العمق التحليلي الذي يقدمه تشيفيك في تفكيك أبعاد التوتر التركي–الإسرائيلي، يمكن تسجيلُ عددٍ من الملاحظات النقدية التي تكشف عن جوانب لم تُمنح ما يكفي من التركيز أو التحليل المقارن.
يُلاحظ أن الكاتب يضخّم من الدور الإسرائيلي في إعادة تشكيل النظام الإقليمي، متجاهلًا محدداتٍ داخليةً مؤثرةً في تركيا نفسها، مثل تطور بنية صناعاتها الدفاعية ومحاولاتها تحقيق استقلال استراتيجي عن الغرب، كما أن السياسات الأمريكية المتقلبة تجاه كلٍّ من أنقرة وتل أبيب تشكل بُعدًا لا يقل أهمية عن العوامل الإسرائيلية في إعادة توزيع موازين القوة بالمنطقة.
لم يتوقفْ الكاتب بما يكفي عند البُعد «العملياتي» للتوتر، والمتمثل في استهداف إسرائيل لمواقع أو معداتٍ تركيةٍ داخل سوريا، أو دعمها لقوى محليةٍ مثل الدروز والأكراد بما يتعارض مع المصالح التركية المباشرة، هذا المستوى من الاحتكاك الميداني يعكسُ طبيعةَ جديدةً للصراع تتجاوز الخطاب السياسي إلى اختبار حدود النفوذ على الأرض.
يتجاهل التقرير الإشارات الميدانية الدقيقة التي تؤكد استهداف إسرائيل المباشر لمواقع ومعدّات تركيةٍ داخل سوريا، مثل المنشآت قرب منطقة الكسوة جنوب دمشق. هذه التطورات تُعد مؤشراتٍ نوعيةً على انتقال التوتر من المجال الدبلوماسي إلى اشتباكات غير معلنة على الأرض.
لا يولي الكاتب اهتمامًا كافيًا لتطور القدرات الدفاعية التركية التي تُعد عنصرًا أساسيًا في ضبط التوازن مع إسرائيل، مثل المقاتلة الشبح “قآن”، والدبابة “ألتاي”، ومنظومات الدفاع الجوي، وصفقات “يوروفايتر تايفون”. هذه التفاصيل التقنية لا تعبّر فقط عن تحديث عسكري، بل عن مشروع تركي متكامل لإعادة تعريف الردع الإقليمي.
يتعامل تشيفيك مع احتمال الصدام بين أنقرة وتل أبيب من منظور التوتر اللفظي، دون إبراز أن الاستهداف المباشر لتركيا لا يزال مستبعدًا بسبب وزنها الإقليمي وقدرتها على إحداثِ ردودِ فعلٍ واسعةٍ، وهو ما يدفع إسرائيل إلى تجنّب التصعيد المباشر رغم توسّع عملياتها ضد حلفاء أنقرة في الإقليم.
بينما يصوّر تشيفيك المشهد الراهن كعلامةٍ على انهيار النظام الإقليمي القديم، فإن القراءة الأرجح تشير إلى عملية إعادة تشكّل تدريجية، تتّسم بتراجع المظلة الأمريكية وصعود الترتيبات الإقليمية المتعددة، دون أن تختفي تمامًا آلياتُ الردع القديمة أو خطوط التفاهم الضمنية بين القوى الكبرى.
لم يُعطِ اهتمامًا كافيًا لامتداد التنافس إلى دوائر النفوذ الإقليمية الأوسع، لا سيَّما الخليج العربي وآسيا الوسطى وافريقيا، حيث يتخذ الصراع بين أنقرة وتل أبيب أشكالاً متعددةً تتجاوز حدود المشرق، من التعاون الدفاعي التركي–القطري والسعودي، إلى الشراكات الإسرائيلية–الإماراتية في مسار “اتفاقيات إبراهام”، وصولاً إلى التنافس غير المباشر في آسيا الوسطى عبر أذربيجان، وفي أفريقيا من خلال أدوات متباينة تجمع بين القوة الناعمة والأمن السيبراني.
ورغم أن سليم تشيفيك اختتم تحليله بإشارةٍ لافتةٍ إلى تحوّلٍ النظام الأمني الإقليمي، إلا أن تحليله لم يتعمّق في تداعياتٍ هذا التحول على الأمن الإقليمي، فقد ركّز على وصف التغيّر البنيوي دون استكشاف نتائجه المحتملة، مثل مخاطر التصعيد الميداني بين تركيا وإسرائيل في ساحات النفوذ المشتركة، أو انعكاس التوتر على بروز تنظيمات عابرة للحدود، وتعقيد بناء ترتيباتٍ أمنيةٍ مستقرة، وتزايد الاستقطاب بين التحالفات الإقليمية، إلى جانب تنامي سباق التسلح وتراجع أدوات الحل السياسي.
الخاتمة
في ضوء ما سبق، يتضح أن العلاقات التركية–الإسرائيلية تمرّ بمرحلةِ إعادة تشكّلٍ عميقةٍ تتجاوز حدود الخلافات الظرفية لتلامس جوهر النظام الأمني الإقليمي. فالتوتر بين الجانبين لم يعد ناتجًا عن الموقف من غزة فقط، بل يعكس صراعًا مركّبًا على النفوذ وتوازنات القوة في الشرق الأوسط. ومع تراجع فاعلية المظلة الغربية وصعود المبادرات الأمنية الذاتية، تبدو المنطقة أمام مشهدٍ أكثر هشاشةً، تتقاطعُ فيه حساباتُ الردع مع اعتبارات الداخل والسياسة الرمزية، لتبقى العلاقة بين أنقرة وتل أبيب محكومةً بمعادلةٍ دقيقةٍ بين التنافس الحذر والتصعيد المقيّد.
المصادر:
- Salim Çevik, Beyond Gaza: The Strategic Fault Lines in Turkey–Israel Relations, Arab Center Washington DC, Oct 2, 2025. https://arabcenterdc.org