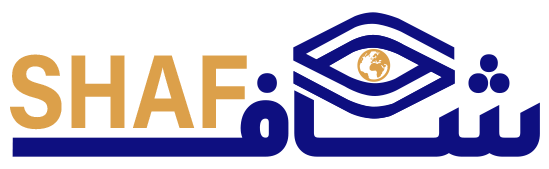المقالات
مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية > تقارير وملفات > وحدة الشرق الأوسط > مشروع فرض السيادة الإسرائيلية: قراءة في تصويت الكنيست الإسرائيلي على ضم الضفة الغربية وغور الأردن
مشروع فرض السيادة الإسرائيلية: قراءة في تصويت الكنيست الإسرائيلي على ضم الضفة الغربية وغور الأردن
- يوليو 25, 2025
- Posted by: ahmed
- Category: تقارير وملفات وحدة الشرق الأوسط
لا توجد تعليقات

إعداد: دينا إيهاب
باحث مساعد في وحدة شؤون الشرق الأوسط
في خطوةٍ تُنذر بتحولٍ استراتيجيٍ في مسار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، صوّت الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025، لصالح مشروعِ قانونٍ يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، وهي مناطقُ تُعدُّ وفق القانون الدولي أراضيَ مُحتلة منذ عام 1967، وقد جاء التصويتُ بأغلبيةٍ لافتةٍ بلغت 71 عضوًا مُقابل 13 معارضًا فقط، ما يعكسُ حالةَ شبْه إجماعٍ داخل الائتلاف الحكومي بقيادة اليمين المتشدد على الدفع نحو مسار “شرعنة الضم”، حيث بادرَ إلى طرْحهِ عددٌ من أعضاء الكنيست التابعين إلى تيارات اليمين القومي والديني، وعلى رأسهم “دان إيلوز” و”ليمور سون هار-ماليخ”، إذ ينصُ صراحةً على اعتبار الضفة الغربية وغور الأردن “جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، ويدعو إلى اتخاذِ خطواتٍ استراتيجيةٍ لتثبيت ما وصفوه بـ”الحق التاريخي” وتعزيز الأمن القومي الإسرائيلي، وعلى الرغم من أن التصويت لا يحملُ صفةً تنفيذيةً، فإن توقيتَه، وسياقَه السياسيَ والأمني، وتأييد رئيس الكنيست له علنًا، يشكل رسالةً رمزيةً تتجاوز الطابع الإجرائي، ويُنظر إليه كتصعيدٍ مدروسٍ ضمن أجندة الحكومة الإسرائيلية الحالية.
أولًا: تفاصيل مشروع القانون ودلالاته
في 23 يوليو 2025، صوّت الكنيست الإسرائيلي على بيانٍ غير ملزمٍ يدعم فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن[1]، وهو تطورٌ يحملُ أبعادًا رمزيةً وتشريعيةً عميقةً، رغم عدم امتلاكه صفةً قانونيةً مُلزمةً للحكومة، وقد طُرح البيان ضمن بند “اقتراح على جدول الأعمال” بمبادرة من أعضاء الكنيست المنتمين إلى تيارات اليمين القومي والديني المتشدد، مثل سيمحا روتمان، أوريت ستروك، ودان إيلوز، وبدعمٍ واضحٍ من رئاسة الكنيست، وجاءت هذه الخطوةُ لتحملَ عدةَ دلالاتٍ ومن أهمها ما يلي:
1- سياق متكامل للضم – من السيطرة الفعلية إلى السيادة القانونية: يُنظر إلى التصويت في الكنيست باعتباره تتويجًا لمسارٍ طويلٍ من السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تحويل السيطرة العسكرية والإدارية الفعلية إلى سيادةٍ قانونيةٍ وتشريعيةٍ، فقد تبنّى اليمين الإسرائيلي، خلال العقدين الماضيين، استراتيجيةً تقومُ على التدرّج في تقويض الأساس القانوني لأي تسويةٍ سياسيةٍ، من خلال:
التوسّع الاستيطاني سواء العشوائي أو المنظّم.
تفكيكٌ الخط الأخضر فعليًا من خلال البنية التحتية والمواصلات.
منْحِ المستوطنين مكانة قانونية موازية للمواطنين داخل إسرائيل.
تقديمِ مشاريع قوانين متكررة للضم، مثل مشروع “القدس الكبرى” وضم جنوب الخليل.
2- تصفية حل الدولتين ودخول عصر “الأبارتهايد القانوني”: يشيرُ هذا المشروعُ إلى مرحلةٍ جديدةٍ في الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني، وهي المرحلةُ التي تنتقل فيها إسرائيل من السيطرة الاحتلالية التقليدية إلى نظام “الأبارتهايد” المعترفِ به دستوريًا، حيث يتمُّ ضمُّ أراضٍ محتلةٍ دون منح سكانها الأصليين حقوقًا متساوية[2]، وبالنظر إلى هذا السياق، نجدُ تصاعدَ التنسيق بين الكنيست والحكومة، بدفعٍ من اللوبيات الاستيطانية، لتوسيع نطاق التشريعات التي تخدم هذا التحول الأيديولوجي العميق داخل بنية الدولة الإسرائيلية، والذي يفتح الباب أمام:
تفكيكِ رؤيةِ حلّ الدولتين بشكلٍ منهجيٍ.
شرعنةِ التهجير والضمِّ في مناطق (ج) والقدس ومحيطها.
تحويلِ الفلسطينيين إلى مجموعات معزولة بلا سيادة أو حقوق سياسية.
ترسيخ نظام استيطاني–عنصري تمييزي ينفي أي أفق للتسوية.
3- تكريس مبدأ الضم الزاحف: تعتبرُ خطوةُ تصويتِ الكنيست على دعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية غور الأردن عن انهيار المسار التفاوضي وتلاشي أيِ أفقٍ حقيقيٌ لحلّ الدولتين. فهذه الخطوةُ لا تمثّلُ فقط تعبيرًا رمزيًا عن موقفٍ سياسيٍ، بل تُعيد إلى الواجهة الجدل حول سياسات الضم الزاحف التي تنتهجها إسرائيل منذ سنوات[3]، سواءٌ عبر التوسّع الاستيطاني أو من خلالِ تشريعاتٍ ترمي إلى شرعنة السيادة الإسرائيلية على أراضٍ محتلة، في تحدٍ مباشرٍ لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصةً القرارين 242 و338، ولأُسس الشرعية الدولية[4]، ولا يمكنُ قراءةُ هذا التصويت بمعزلٍ عن التحولات الأيديولوجية العميقة داخل النظام السياسي الإسرائيلي، حيث تشهد مؤسسات الحكم انزياحًا واضحًا نحو اليمين القومي والديني المتطرف، ما أفرزَ ديناميكياتٍ سياسيةً جديدةً تُعيد تشكيل العلاقة مع الفلسطينيين من منطق القوة والضم، بدلًا من منطق التفاوض والاعتراف، وتُعيد صياغةَ الخطاب الرسمي الإسرائيلي تجاه الأرض والهوية والسيادة، بعيدًا عن أي التزامٍ فعليٍ بالحلول السياسية العادلة.
4- مُباركة ترامب للرؤية التوسعية الإسرائيلية: جاءَ تصويتُ الكنيست لصالح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن متكئًا على دعمٍ صريحٍ من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي وفّرت غطاءً سياسيًا غير مسبوقٍ لسياسات الضم والتوسع الاستيطاني، وذلك من خلال عبارة ترامب الشهيرة بأن “مساحة إسرائيل صغيرة جدًا ويجب توسيعها” [5] حيث لم تعدْ مجرد تصريحاتٍ، بل تحوّلتْ إلى ضوءٍ أخضرَ لتحصين مشروع الضم بوسائل تشريعية في ظل هذا الانحياز الأميركي.
ثانيًا: الضفة الغربية وغور الأردن كعمق استراتيجي في أجندة الضم الإسرائيلي
تُمثل منطقةُ الضفةِ الغربيةِ وغور الأردن لإسرائيل أكثر من مجرد أراضٍ مُتنازعٍ عليها، حيث إنها مشروعٌ استيطانيٌ، وقاعدةٌ أمنيةٌ، وموردٌ اقتصاديٌ، ورمز ديني، وأداة ضغط سياسي واجتماعي، وساحة صراع إقليمي. ولهذا، فإن كل الإجراءات الإسرائيلية ومحاولات السيطرة على هذه المناطق ليست عشوائيةً، بل جزء من خطةٍ منهجيةٍ لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وتكريسِ واقعٍ استعماريٍ طويل الأمد، حيث تبرز أهميتهم فيما يلي:
1- محور مشروع الاستيطاني الصهيوني: تُعد الضفة الغربية جوهر المشروع الإسرائيلي الهادف إلى إقامة دولةٍ يهوديةٍ نقيةٍ عرقيًا، استنادًا إلى الأيديولوجيا التوراتية التي تتبناها حكومة نتنياهو وتحالفاته اليمينية المتطرفة. فقد نصت “خطة الحسم” التي وُقعت عام 2022 بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية، على أن “الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) حقٌّ غيرُ قابلٍ للتصرف للشعب اليهودي”[6]. وهذا يُفسر الإصرار على ضمها بالكامل، ورفض أي تسوية تُفضي إلى تقسيم الأرض أو إقامةِ دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلةٍ.
2- عمق استراتيجي أمني لا غنى عنه: من منظورِ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تُعد الضفة الغربية – وخصوصًا مناطق مثل غور الأردن – خط الدفاع الأول شرقًا، إذ تمنحُ إسرائيل سيطرةً على المرتفعات المشرفة على الأراضي الأردنية، وتحولُ دون نشوءِ كيانٍ فلسطينيٍ متماسكٍ جغرافيًا يمكن أن يشكل تهديدًا في المستقبل. لهذا، فإن السياسات الإسرائيلية لا تتعامل مع الضفة كأرضِ تفاوضٍ بل كأرضٍ يجبُ تفكيكُها أمنيًا من الداخل، عبر تقطيع أوصالها بجدار الفصل العنصري والمستوطنات والحواجز العسكرية، بينما غور الأردن يشكّل الشريطَ الحدوديَ الشرقيَ مع المملكة الأردنية، ويمتدُ بطول أكثر من 100 كم من شمال الضفة إلى البحر الميت. وبالنسبة لإسرائيل، فإن هذه المنطقة هي “الحدود الأمنية المثلى” ضد أي تهديدٍ شرقيٍ محتمل[7]، كما أن رؤساء أركان الجيش الإسرائيلي المتعاقبون أكدوا أن الانسحابَ منها يعرّضُ الأمنَ القوميَ الإسرائيلي للخطر، ولهذا تصرّ حكومة نتنياهو على إبقائها تحت السيطرة العسكرية الكاملة، بل وضمّها رسميًا في سياق مشروع السيادة.
3- الأهمية الاقتصادية: الضفة الغربية وغور الأردن معًا يشكلان مخزونًا اقتصاديًا مهمًا لإسرائيل. غور الأردن غني بالتربة الزراعية والمياه، ويُستخدم لزراعة منتجاتٍ تصديريةٍ عاليةِ الجودة، وقد حوّلت إسرائيل هذه المنطقة إلى مركزٍ زراعيٍ استيطانيٍ ضخم، يستغل الأراضي الفلسطينية ويُشغّل آلافَ العمال الفلسطينيين في ظروفٍ مجحفةٍ، من جهةٍ أخرى، تسيطر إسرائيل على أكثر من 80٪ من مصادر المياه في الضفة[8]، خصوصًا في الأغوار، وتمنع الفلسطينيين من حفر الآبار أو تطوير شبكاتهم المائية، مما يجعل من “الماء” أداة هيمنة واستعمار بيئي، تُستخدم لتطويع السكان أو تهجيرهم.
4- هيمنة عسكرية على الأرض والموارد: عبر السيطرة على غور الأردن، تحتفظ إسرائيل بقدرتِها على التحكم الكامل بالحركة الفلسطينية، من خلال الحواجز العسكرية والمناطقِ المغلقة. هذا الانتشارُ العسكريُ لا يحصّن الحدود فحسب، بل يُبقي السلطةَ الفلسطينيةَ محاصرةً ومجردةً من أي عمقٍ جغرافيٍ أو استراتيجيٍ في الضفة، وتحويل المناطق المصنفة “ج” والتي تشمل أكثر من 60٪ من الضفة الغربية إلى مناطق عسكرية بحكم الأمر الواقع، وبالتالي إطلاق يد المستوطنين الإسرائيليين بحرية.
5- الردع بالقوة- عسكرة الفضاء المدني: تستنسخُ إسرائيل في الضفة الغربية نموذج غزة، ولكن بأساليب مركّبة. فإلى جانب انتشار الطائرات المسيّرة والاغتيالات الميدانية، تستخدمُ إسرائيل أدواتِ الردع الجماعي مثل تدميرِ البنيةِ التحتية، وإغلاقِ المعابر، هذا التوجّهُ لا يُخفي نواياه بإعادةِ إنتاجِ النموذج الغزي في الضفة، ولكن دون الحاجة لفكِّ الارتباط، بل ضمن ضمِّ وسيطرةِ شاملة تمهّد لتفكيك المجتمع الفلسطيني تدريجيًا ، وصولًا إلى الدفع باتجاه “الرحيل الطوعي”.
ومن هنا، تمثلُ الضفةُ الغربية وغور الأردن مجتمعتين قلب المشروع الصهيوني، حيث تتقاطع فيها الرؤية الدينية مع الأمن القومي والمصالح الاقتصادية. تسعى إسرائيل إلى فرض أمر واقع طويل الأمد عبر عسكرة الأرض، وتفكيك المجتمع الفلسطيني، والاستحواذ على الموارد. وهذا يجعل أي حل سياسي حقيقي بعيد المنال ما لم يتم تفكيك هذه البنية الاستعمارية ووقف سياسات الضم والتهويد.
ثالثًا: ردود الفعل العربية والإقليمية
جاءتْ الإداناتُ العربية والإسلامية لتُعبّر عن رفضٍ شاملٍ للقرار الإسرائيلي، وتأكيدٍ على وحدة الموقف الإقليمي في مواجهة محاولات شرعنة الاحتلال، وذلك على النحو الآتي:
1- الموقف الفلسطيني: وقال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إن “محاولاتِ فرض قوانين وقرارات حكومية عنصرية تحت مسمى فرض السيادة الإسرائيلية على الأماكن الاستيطانية في الضفة الغربية، تمثّل تصعيداً خطيراً وتقويضاً لحقوق الشعب الفلسطيني في دولتهِ المستقلةِ وذات السيادة”[9]، كما أدانت القوى والفصائل الفلسطينية، وعلى رأسِها حركةُ حماس، تصويت الكنيست، واعتبرته إجراءً باطلاً وغير شرعيٍ لا يغيّر من حقيقة الأرض الفلسطينية. دعت حماس إلى تصعيد المقاومة بكافة أشكالها لإفشال مخططات الاحتلال ووقٍف عمليات الضم، مؤكدةً أن القرار يشكل تحديًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الأممية.[10]
2- الموقف الأردني: أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية رفضًا مطلقًا لهذا التصويت، معتبرةً إياه انتهاكًا للقانون الدولي وخرقًا صريحًا للقرار 2334 لمجلس الأمن. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية أن مثل هذه الخطوات تقوض حل الدولتين وتضرُّ بالاستقرار الإقليمي، مطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية في منع إسرائيل من فرض واقع الاحتلال على الأرض.[11]
3- بيان عربي وإسلامي مشترك: صدرَ بيانٌ مشترك عن 11 طرفًا عربيًا وإسلاميًا، من بينها: مصر، البحرين، إندونيسيا، الأردن، نيجيريا، فلسطين، قطر، السعودية، تركيا، الإمارات، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي[12] ، حيث أدان هذا التحالفُ الإقليميُ مصادقةَ الكنيست بأشد العبارات، معتبرًا القرار خرقًا سافرًا للقانون الدولي، حيث جاء البيان ليؤكد على ما يلي:
أكد البيان أن القرارَ يمثّلُ خرقًا سافرًا للقرارات الدولية الهامة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن 242 (1967)، 338 (1973)، و2334 (2016)، التي تعتبر جميعها أن أي إجراءات تهدف إلى شرعنة الاحتلال أو توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة باطلة ولا شرعية لها.
جدّدَ البيانُ تأكيده أن إسرائيل لا تملكُ أي سيادةٍ على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن أيَ تحركٍ أُحاديِ الجانب لفرض السيادة الإسرائيلية لا يحملُ أيَ أثرٍ قانونيٍ ولا يغيرُ من الوضع القانوني للأرض، بما في ذلك القدس الشرقية التي تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من فلسطين.
نبّهَ البيانُ إلى أن هذه الخطوة الإسرائيلية ستؤدي إلى زيادة حدة التوترات في المنطقة، خصوصًا في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.
حثّتْ الأطرافُ الموقّعةُ على البيان المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، وجميع الأطراف المعنية، على الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية للضغط على إسرائيل لوقْفِ هذه السياساتِ غير القانونية، ومنْعِ فرْضِ أمرٍ واقعٍ بالقوة على الأرض الفلسطينية.
شدّدَ البيانُ على ضرورة وقْفِ السياسات التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيقِ سلامٍ عادلٍ ودائمٍ، والتي تقوضُ آفاقَ حل الدولتين كحلّ وحيد للقضية الفلسطينية.
أكدت الأطراف مجددًا التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، خصوصًا خطوط الرابع من يونيو 1967، مع إقامةِ دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلةٍ ذات سيادةٍ وعاصمتها القدس الشرقية.
رابعًا: التداعيات المُحتملة
يحملُ مشروعُ القرار الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية في طياته تداعياتٍ استراتيجيةً خطيرةً تؤثر بشكلٍ مباشرٍ على مسار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، رغم طابعه الرمزي الحالي، فإنه من المتوقع أن يؤدي إلى ما يلي:
على المستوى الميداني، من المتوقّعِ أن يسهمَ القرار في تحفيز تصاعد الاستيطان وتوسيع الأنشطة الاستعمارية، ما يعزّزُ حالة التوتر والاحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين في مناطق ذات حساسية جغرافية وأمنية مثل الخليل ونابلس، مما يهدد الاستقرار الأمني في الضفة الغربية ويزيد من احتمالية اندلاع مواجهات عنيفة.
سياسيًا، يُمثلُ القرارُ تعبيرًا عن تصاعد النفوذ السياسي للأحزاب اليمينية المتشددة داخل النظام الإسرائيلي، ما يساهم في تعقيد أفق المفاوضات المستقبلية مع الفلسطينيين ومع الأطراف الدولية الفاعلة، ويُحتمل أن يؤديَ إلى مزيدٍ من العزلة الدبلوماسية لإسرائيل، لا سيَّما في ظل تصاعد دعوات عددٍ من دول أوروبا مثل فرنسل الداعمة لحل الدولتين، حيث يمكن أن تتخذَ مواقفَ احتجاجية أو خطوات دبلوماسية للضغط على الحكومة الإسرائيلية.
من الناحية التشريعية، فإن تحويلَ هذا القرار إلى قانونٍ ملزمٍ يتطلبُ سلسلةً من الإجراءات البرلمانية داخل الكنيست، بما يشملُ ثلاثَ قراءاتٍ برلمانية وموافقة حكومية، وهو ما قد يواجه تحدياتٍ داخلية تتمثل في معارضة من بعض الكتل السياسية أو تحركات ضغط دولية، وهو ما قد يعكسُ وجود حالة من عدم اليقين حول تنفيذ القرار على أرض الواقع، لكنه لا يلغي الأبعاد الرمزية والسياسية التي يحملها القرار كأداةِ ضغطٍ وتثبيت للسياسات الاستيطانية.
أمنيًا وإنسانيًا، قد يؤدي فرض السيادة إلى تصعيدٍ ميدانيٍ واسع النطاق في الضفة الغربية، حيث من المتوقّع أن تتكثف العمليات العسكرية الإسرائيلية والمواجهات الشعبية، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت قيودٍ صارمةٍ في الحركة والموارد الاقتصادية، الأمرُ الذي يُنذرُ بتدهور الأوضاع الإنسانية وتهديدِ الاستقرارِ الإقليمي. لذا، يستوجبُ هذا المشهد تحركًا دوليًا فاعلًا لتفادي انفجارِ الأوضاعِ وفرض آليات تحفظ فرص السلام المستدام.
عرقلة مسار حل الدولتين، يُعدُّ قرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة الغربية عائقًا جوهريًا يعمّقُ الأزمةَ السياسيةَ ويعرقل مسار التفاوض بشكل كبير، حيث يعكسُ تمسّكَ الجانب الإسرائيلي بسياساتِ الأمرِ الواقع التي تقوض أساسيات حل الدولتين. هذا القرار، الذي يعززُ شرعيةَ الاستيطان وضمَّ الأراضي المحتلة، يُجهض فرص الحوار البناء ويُضعف الثقة المتبادلة بين الأطراف، مما يجعلُ العودةَ إلى طاولة المفاوضات أمراً بالغ الصعوبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار هذه السياسات أحادية الجانب يدفع المجتمع الدولي، إلى إعادة تقييم دورهم وتأثيرهم، ويزيدُ من احتمالاتِ الانسحابِ أو تقليص الدعم السياسي، ما يُضعفُ آفاق الحل السياسي ويزيدُ من احتمالية استمرار الصراع على المدى الطويل.