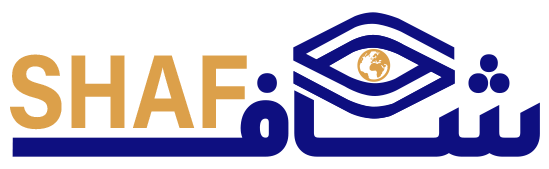المقالات
مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية > تقارير وملفات > الدراسات الأمنية والإرهاب > من الأمن إلى الوقاية: كيف نجحت بعض الدول في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف؟
من الأمن إلى الوقاية: كيف نجحت بعض الدول في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف؟
- سبتمبر 1, 2025
- Posted by: Maram Akram
- Category: إصدارات دورية الدراسات الأمنية والإرهاب
لا توجد تعليقات

إعداد: إلهام النجار
باحث في برنامج الأمن والإرهاب
إيمانًا بأهميةِ الدور والتثقيف السياسي لدى مراكز الفِكر البحثية، والمسئولية التي تقع على عاتقنا بأهمية نشر الوعي ، يُقدم “مركز شاف للدراسات المُستقبلية وتحليل الأزمات والصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا” هذه السلسلة التي تتضمن تقريرًا شهريًا عن التطرف والإرهاب، وكذلك تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة التي تمَّ تصديرُها من الغرب عن التطرف والإرهاب، وأن هذه المجموعة من التقارير المتنوعة تُسلط الضوء على العديد من العوامل والتأثيرات المُتعلِقة بجذور الإرهاب والتطرف، حيث يمثّلُ التطرفُ العنيفُ والإرهابُ أحدَ أبرز التهديدات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، بما يحمله من تداعياتٍ أمنيةٍ، وسياسيةٍ، واقتصاديةٍ، وثقافيةٍ عميقةٍ، وعلى الرغم من تعدّد مقاربات التصدي لهذه الظاهرة، إلا أن التجربةَ التاريخيةَ والبحث الأكاديمي أظهرا أن المعالجة الأمنية وحدها غيرُ كافيةٍ، ما لم تواكبها جهودٌ وقائيةٌ عميقةٌ تُعنى بجذور التطرف ومسبباته البنيوية، وفي هذا السياق، يُعد التطرف والإرهاب من أخطر التحديات العابرة للحدود التي واجهها العالم منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، إذ لم تعدْ تهدد استقرار الدول الهشة فحسب، بل طالت آثارُها السلبية المجتمعاتِ المتقدمة أيضاً، محدثةً هزاتٍ أمنية وسياسية واقتصادية عميقة. ومع اتّساع نطاق هذه الظاهرة، تباينت استجابات الدول في التعامل معها بين المقاربات الأمنية الصارمة، والسياسات الوقائية الشاملة التي تسعى إلى معالجة الجذور الفكرية والاجتماعية والاقتصادية للتطرف.
ومن خلال التجارب الدولية المتنوعة، برزت عدةُ نماذج ناجحة استطاعت الحدَّ من خطورة التطرف أو إعادة تأهيل الأفراد المنخرطين فيه، مثل النموذج الدنماركي (آرهوس) الذي اعتمد على منظومة إحالة متعددة الوكالات، والنموذج المغربي المرتكز على المرجعية الدينية الوسطية، والنموذج السعودي القائم على المناصحة وإعادة الإدماج، والنموذج السنغافوري الذي يجسّد شراكةَ الدولةِ والمجتمع المدني، والنموذج الألماني الذي ركّز على التربية والدعم الاجتماعي، وأخيراً النموذج المصري الذي جمع بين الردّ الأمني والبُعد الفكري والديني.
وعليه، يناقش التقرير الحادي عشر تحليل هذه التجارب الناجحة ، حيث لا يهدفُ فقط إلى فهْمِ أسباب نجاحها، بل إلى استكشاف كيفية توظيف دروسها المستفادة في السياقات المحلية، بما يعزّزُ قدرةَ المجتمعاتِ على تحصين نفسها ضد التطرف العنيف ويؤسسُ لسياساتٍ أكثر توازناً واستدامةً، ومن هنا تأتي أهمية هذا التقرير الذي يسعى إلى تقديم قراءة تحليلية شاملة لهذه النماذج، مع إبراز عناصر قوتها وإمكانية تكييفها مع البيئة العربية والإسلامية.
أولًا: لماذا “المنع والاحتواء” إلى جانب “الأمن الصلب”؟
منذ 2015 رسّخت خطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف مقاربةً شاملة تكمّل إجراءات مكافحة الإرهاب التقليدية بسياساتٍ وقائيةٍ تُعالج الجذور الاجتماعية والفكرية والنفسية، وتؤكد على الشراكات متعددة الجهات واحترامِ حقوقِ الإنسان، هذه الرؤية وفّرت إطارًا مرجعيًا استندت إليه كثير من النماذج الوطنية الناجحة.[1]
ثانيًا: تجربة الدنمارك (نموذج آرهوس) – منظومة إحالة متعددة الوكالات
يُعد”نموذج آرهوس” منظومةً محليةً – وطنيةً بدأت في مدينة آرهوس بشراكةٍ رسميةٍ بين بلدية آرهوس وشرطة شرق يوتلاند، مع انخراط الجامعة (آرهوس)، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الاندماج، وجهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي PET. يرتكز على الوقاية المبكرة، والتدخّل الفردي، وخيارات “الخروج/الExit”، وقد صار لاحقًا ممارسةً وطنية مُعمَّمة عبر أقاليم الشرطة.[2]
وأظهرت تقييماتُ ووثائقُ سياسات أوروبية (RAN) وطنيّة (DIIS) أن الفكرة المحورية هي شبكةُ إحالةٍ متعددةِ الوكالات تتشارك المعلومات ضمن أُطرٍ قانونيةٍ، وتُسند كل حالةٍ إلى خُطة تدخل مُخصصة بدل مقاربة “مقاسٍ واحد”،كما حَظِيَ النموذجُ باهتمامٍ دوليٍ بسبب طريقة تعامله مع العائدين من سوريا، والعراق عام (2013–2015) ضمن مزيج من الاحتواء المهني وإنفاذ القانون. [3]
البنية المؤسسية وآليات الحوكمة (كيف تُدار الإحالات)؟
(أ) بيت المعلومات“ Info-house “:
ليس مبنى فعليًا، بل إطار تعاون محليّ يُنسّق بين الشرطة والخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة النفسية، لتلقي البلاغات من الأسرة/المدرسة/الشرطة/الجيران، وفرزها وتقييم الخطورة وإحالة الحالة إلى المسار الأنسب (دعم اجتماعي، إرشاد، أو تدخل متخصص). أُنشئت “بيوت المعلومات” في جميع مناطق الشرطة الاثنتي عشرة في الدنمارك، كما راجعتْ وزارة الشؤون الاجتماعية الدنماركية النموذجَ واعتبرته ممارسةً نموذجيةً؛ كما عُمِّمَت آليات “بيت المعلومات” وبرنامج الإرشاد كسياسة وطنية عبر دوائر الشرطة[4].
كما توضح أدلة OSCE أن الدنمارك تجعل الشرطةَ محورًا للتنسيق مع المدرسة والخدماتِ الاجتماعيةِ والصحة النفسية ضمن منظومة إحالة واضحة، وهو ما يتسق تمامًا مع “بيت المعلومات”.[5]
(ب) الشراكة الأمنية – المدنية:
– يقود PET (مركز الوقاية) جانب الوقاية والتوعية والدعم المهني، مع أدواتٍ وخدماتٍ موجّهة للأفراد والأُسر والمؤسسات، في تكامل مع الشرطة والبلديات.
– SSP Aarhus (شرطة–مدرسة–خدمات اجتماعية) تمثّل آليةَ إشرافٍ محلية تُنسّق الموارد وتربطها بخبرات أكاديمية (قسم علم النفس بجامعة آرهوس) وخبراء الدين والمجتمع.[6]
(ج) الأُطر القانونية وتبادل المعلومات:
مشاركة البيانات محكومة بقوانين إجرائية وإدارية (كـ Administration of Justice Act)، بما يقيّدُ استخدامَ المعلوماتِ ويؤطرها لغرض الحماية/الوقاية؛ وهذا ما أبرزه تقرير DIIS المرجعي عن المقاربة الدنماركية. [7]
مكوّنات التدخّل: ماذا يحدث بعد الإحالة؟
(1) الفرز والتقييم:
يتلقى “بيت المعلومات” الإشعارات، ويُجري تقييمًا أوليًا لتمييز سلوك الشباب “المقلق” عن مؤشرات التطرّف العنيف؛ فإذا لم تكنْ الحالةُ راديكاليةً تُحال للخدمات الاجتماعية/الاستشارات، أما إن وُجدت مؤشراتُ خطورة تُفتح خُطة حالة متعددة العناصر. [8]
(2) خُطة تدخل فردية (Case Plan):
– مُرشد (Mentor) معتمد يتابع المستفيد/ة بخطة زمنية مُحددة (تعليم، عمل، مهارات حياتية، ضوابط رقمية)، مع دعمٍ أسريّ واستشارات متخصصة، وقد اعتُمدت برامج الإرشاد هذه و”بيت المعلومات” وطنياً. [9]
– مكوّن تعليمي/مهني: ربط المستفيد بمسارات تعليمٍ وتدريبٍ وتشغيل واقعية لتقليل قابلية الانخراط في شبكات العنف. [10]
– صحة نفسية ودعم أسري: توفير جلسات علاج/استشارة، وخدمات مرافقة للأسرة لتقليل النكسات وتحسين الالتزام بالخطة.
(3) مسارات الخروج/EXIT وإعادة الاندماج:
تُصمَّم للمُنخرطين في بيئاتٍ متطرفة والـعائدين من مناطق الصراع، وتجمع بين الإرشاد، متابعة الشرطة المجتمعية، دعمٍ تعليمي–مهني، وإجراءات حماية عند الحاجة، كما وثّقت RAN وDIIS هذه المسارات بوصفها “ممارسةً مُلهمة” ومتكاملة مع الجهود الجنائية. [11]
استجابة آرهوس لملف العائدين (2013–2015) – ماذا فعلت عمليًا؟
طوّر شركاء آرهوس (البلدية وشرطة شرق يوتلاند) خطةَ طوارئٍ لمنْعِ السفر إلى سوريا/العراق وللتعامل مع العائدين، بالاعتماد على قنوات التعاون القائمة، و ركّزت الخطةُ على إرشادٍ فردي لمن يفكّر في السفر، ومساندة إعادة اندماجٍ منظّمة للعائدين بالتوازي مع أدوات إنفاذ القانون عند الاقتضاء، هذا “النهْجُ العملي” (learning-by-doing) كان جزءًا مهمًا من جاذبية التجربة دوليًا. [12]
ماذا تقول الأدلة عن الفاعلية والانتشار؟
تُجمِع المصادر الأوروبية أن النموذج قدّم هيكلًا تشغيليًا قابلاً للنقل+ (Info-house + Mentoring) شراكة أمنية – مدنية، وتبنّته الحكومة على نطاقٍ وطنٍي عبر مناطق الشرطة، مع إشاداتٍ متكررةٍ ضمن شبكة RAN.
وهناك تقاريرُ دولية (DIIS)ٌ، (USIP)تُظهر منطقيةَ تصميم الإحالة والتمييز بين “قلق شبابي” وبين حالة راديكالية فعلية، ما يحدّ من الإفراط في الإحالة ويُبقي الثقةَ المجتمعية أعلى، لكنها تُوصي بتحسين قياسات الأثر الطولية (نِسَب العَود، جودة الحياة، الاستدامة). [13]
نقدٌ بنّاء وتحديات معروفة:
القياس والشفافية: كثيرٌ من الأرقام المتداولة إعلاميًا حول “النجاح” تظلّ وصفية أو محليّة، وتحتاج لتتبّعٍ مستقل ومعرّفات واضحة لقياس العَود والتغيّر المعرفي – السلوكي، وهذا نقد متكرر في الأدبيات المقارنة.
المشروعية المجتمعية: قيام الشرطة بدور “البوابة” مفيد تنظيميًا لكنه يتطلبُ استثمارًا مستمرًا في الثقة وحماية البيانات وتلافي الوصم، كما تؤكد أدلة OSCE وأبحاث مقارنة عن الانخراط المجتمعي.
قابلية التوطين: اعتمد نجاح آرهوس على بنى دنماركية تاريخية (SSP) وثقافة تعاون بين المدرسة والشرطة والخدمات الاجتماعية؛ نقلها لسياقات أخرى يستلزم تكييفًا قانونيًا ومهنيًا، لا نسخًا حرفيًا. [14]
وعليه، إن “آرهوس” ليس برنامجًا فكريًا معزولًا ولا أمنيًا صرفًا؛ إنما بنية عملياتية: (أ) غرفة إحالة متعددة الوكالات «Info-house»، (ب) إرشاد فردي ودعم أسري–نفسي وتعليمي–مهني، (ج) مسارات خروج وإعادة إدماج مرتبطة بمتابعة شرطية مجتمعية، (د) إطار قانوني حارس لتبادل المعلومات، (هـ) تقييم دوري للأثر، هذه “الوصفة التشغيلية” قابلة للتوطين عربيًا إذا توفّرت تشريعاتُ مشاركةِ بيانات محكومة، واعتماد مهني للمرشدين، وشراكات رسمية بين الأمن والتعليم والشؤون الاجتماعية والصحة والمؤسسة الدينية، مع قياس أثرٍ شفاف وطويل المدى.
ثالثًا: تجربة المغرب
يقوم النموذج المغربي على ثلاث ركائزٍ مترابطة:
إصلاحُ الحقلِ الديني وبناء مرجعية وسطية مؤسسية: مركزية إمارة المؤمنين، تأطير العلماء، تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، ودبلوماسية دينية إفريقية[15]
مقاربة أمنية-قانونية احترافية: قانون 03-03 (2003) وتعديلاته بعد 2015، وإنشاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ) داخل منظومة الاستخبارات الداخلية (DGST) .
إعادةُالتأهيل والاندماج: برنامج “مصالحة” لنزلاء قضايا التطرف داخل السجون، يؤطره مزيجٌ ديني-حقوقي-نفسي وينتهي بخيارات عفو/إدماج مراقَب.[16]
الركيزة الأولى: إصلاح الحقل الديني
ويمكن توضيح كيفية تفعيل ذلك من خلال الآتي:
مؤسسة العلماء والتأطير المركزي:
بعد تفجيراتِ الدار البيضاء (16 مايو 2003) تحوّل إصلاحُ الحقلِ الديني إلى أولوية دولة، و إعادة تنظيم الوزارة، تقوية المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، وترسيخ خطابٍ أشعري-مالكي-جنيدي (تصوفي) معتدل. تُوثّق الأدبيات هذا التحوّلَ بوصفه “إعادةَ تعريفٍ رسمي للإسلام المغربي” لضبط المجال الديني وتحسين مناعته ضد الاختراقات السلفية الجهادية. [17]
معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المُرشدين والمرشدات:
أُحدِث المعهد بظهير 20 مايو 2014 لتكوين الأئمة والمرشدين/المرشدات المغاربة والوافدين من الخارج، ضمن رؤيةٍ مهنيةٍ موحدة للمضامين والمهارات والخطابة والإفتاء المحلي، كما تُبيّن صفحات المعهد الرسمية نطاق التفويض وهيكلة التكوين، وعلى صعيد “الدبلوماسية الدينية”، استقبلت الرباط آلاف الطلبة من إفريقيا خلال السنوات الأخيرة؛ وتفيد بيانات عمومية بأن عددَ الطلبة الأفارقة الذين تخرّجوا أو يتابعون الدراسة في المعهد بين 2015 و2022 بلغ نحو 2798 طالباً (من مالي، السنغال، الكوت ديفوار… إلخ).[18]
المرشدات (morchidates): تمكينٌ ديني واقٍ
أطلقت الرباط برنامج المرشدات سنة 2006، وتخرّجت الدفعة الأولى في مايو من ذلك العام، ليتواصلَ تكوينُ دفعاتٍ سنوية تعمل في المساجد والمدارس والسجون ومراكز محو الأمية، مع مهامّ تعليمية وإرشادية واجتماعية، هذه الخُطوة – غير المألوفة في كثير من البلدان – وسّعت قنوات التأثير الوقائي في محيط النساء والشباب. [19]
مراجعة مناهج التربية الدينية (2016):
أمر العاهلُ المغربي سنة 2016 بمراجعة مقررات التربية الدينية في التعليم العام والعتيق لتكريس قيم الاعتدال والتسامح وتقليل قابلية التأويل المتطرف للنصوص المدرسية، المهم هنا هو تثبيتُ المعاييرِ المرجعيةِ داخل المدرسة بما يُساند خطابَ المسجد والعالم والمرشد/ة.
أدوات داعمة: الرابطة المحمدية ومؤسسة العلماء الأفارقة
فعّلت الدولة أذرعًا ناعمةً، وكذلك الرابطة المحمدية للعلماء بمشاريع رقمية وتربوية لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف، ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة لبناء شبكات علماء قارّية وتوحيد مرجعيات الاعتدال.
لماذا تنجح هذه الركيزة؟ لأنها تمأسس المرجعية الدينية (وحدة المذهب، ضبط الفتوى، تمكين المرأة الداعية)، وتحوّل «الخطاب المضاد» إلى منظومة مهنية مستمرة، لا حملة عابرة.[20]
الركيزة الثانية: الأمن والقانون
الإطار القانوني والمؤسسي:
أُقِرّ قانون 03-03 لمكافحة الإرهاب بعد 2003، ثم عُدّل لاحقاً (خاصة في 2015) لتجريم الالتحاق ببؤر التوتر وتوسيع أدوات الملاحقة والوقاية، و تؤكد تقارير الخارجية الأميركية استمرارَ تحديثِ القدرات والتشريعات مع تعاون دولي واسع.
المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ) :
أُنشئ سنة 2015 كذراع تحقيقاتٍ واستخباراتٍ قضائيةٍ متخصصة داخل بنية DGST، ومسؤول عن تفكيك عشرات الخلايا سنوياً وإحباط عملياتٍ مستلهمة من «داعش» أو شبكاتٍ عابرة للحدود، تقدّر تقارير دولية أن السلطات اعتقلت/أوقفت أكثر من ألف مشتبهٍ جهادي منذ 2015، مع استمرار تفكيك خلايا في 2024-2025. [21]
لماذا تنجح هذه الركيزة؟ لأنّها مهنيةٌ-استباقيةٌ تعتمد على معلوماتٍ استخباراتيةٍ دقيقةٍ، وتكامل مع النيابة العامة والتعاون القضائي الدولي، ما يُقلّل «الهجمات المنجزة» ويُبقي التهديد في خانة الإحباط المبكر.
الركيزة الثالثة: التأهيل داخل السجون والاندماج بعد الإفراج
ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي:
برنامج “مصالحة”:
تُديره المندوبية العامة لإدارة السجون (DGAPR) مع شركاء رسميين (الأوقاف، المجلس الوطني لحقوق الإنسان…)، ويقوم على ثلاثة محاور:
محورٌ دينيٍ: تصحيحُ التصوّرات العقدية والفقهية.
محورٌ قانونيٌ-حقوقي: الاستيعاب التدريجي لقِيمِ المواطنة والعدالة وحقوق الإنسان.
محور نفسي-سوسيولوجي: تفكيك آليات الاعتناق المتطرف وبناء بدائل الهوية والانتماء.
أُنشئ «مركز مصالحة» كإطارٍ مؤسسي داعم، وتفيد البيانات الرسمية أنّ عدد المستفيدين بلغ 322 شخصاً حتى 2 يوليو 2024، مع حالات عفوٍ ملوكي مرتبطة بإتمام المراحل بنجاح.
لماذا تنجح هذه الركيزة؟ لأنها تربطُ الاعترافَ بالخطأ والتحوّلَ القيميَ بخطة إدماجٍ واقعيةٍ (تعليم ومهارات ومواكبة أسرية)، وتُحافظ على صدقية الدولة عبر مسارٍ واضح: تقييم→تأهيل→مراجعات علنية→انضباط بعد الإفراج. [22]
عناصر القوة والقيود (قراءة نقدية سريعة):
التكامل الأفقي والعمودي: دين-أمن-سجون تعمل بتزامن وتغذية راجعة، لا جزر معزولة.
مأسسة المرجعية الدينية: توحيدُ المذهب وقنواتُ الإفتاء والتأهيل النسائي (المرشدات) داخل إدارة عامة واضحة.
الدبلوماسية الدينية الإفريقية: توسيع «مناطق العزل» ضد الخطاب العنيف إقليمياً عبر تكوين الأئمة.
قيود/نقاشات: جدل حقوقي رافق حملات ما بعد 2003 حول الثمن الحقوقي لمقاربات الاستباق، وهو ما استدعى مراجعاتٍ قانونية وتحسينات إجرائية عبر السنين. [23]
رابعًا: النموذج السعودي في مكافحة التطرف والإرهاب
يُعد النموذجُ السعودي من أبرز التجارب العربية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، حيث تبنّت المملكة العربية السعودية نهجًا شاملاً يوازن بين الأمن الصارم والمعالجة الفكرية وإعادة التأهيل، ويستند هذا النموذجُ إلى إدراك أن الإرهاب ليس مجردَ ظاهرةٍ أمنيةٍ، بل هو نِتاجٌ فكريٌ، اجتماعيٌ، اقتصاديٌ، وسياسي، وبالتالي فإن المواجهة يجب أن تكون متعددةَ الأبعاد.[24]
البُعد الأمني والمؤسسي:
الملاحقة الأمنية والاستخباراتية: لعبتْ الأجهزة الأمنية دورًا محوريًا في تفكيك الخلايا الإرهابية، وتعزيز قدرات الاستخبارات الداخلية والخارجية للتنبؤ بالعمليات الإرهابية قبل وقوعها.
مركز المعلومات الوطني: أُنشئ لربط قواعد البيانات الخاصة بالأمن والإرهاب وتطوير تقنيات لرصد المشتبه بهم.
المشاركة العسكرية: الانخراطُ في التحالف الدولي لمكافحة داعش منذ 2014 يعكسُ البُعد الخارجي في الاستراتيجية السعودية.[25]
البُعد الفكري والديني:
مركز الحرب الفكرية: تأسس عام 2017 تحت إشراف وزارة الدفاع، بهدف مواجهةِ الخطابِ المتطرف على الإنترنت ونشْرِ خطابٍ إسلاميٍ معتدل.
مراجعة الخطاب الديني: أُعيدت صياغةُ مناهج التعليم الشرعي والديني لتقليص التأويلات المتشددة التي استغلتها الجماعات الإرهابية.
العلماء والمؤسسات الدينية: تمَّ تفعيلُ دور هيئة كبار العلماء في إصدار فتاوى تُحرّم الإرهاب والانضمام للجماعات المتطرفة.[26]
برامج المناصحة وإعادة التأهيل:
يُعد برنامج “مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية” من أبرز مكونات النموذج السعودي:
تأسس عام 2004 عقب تفجيرات الرياض.
يهدف إلى إعادةِ تأهيل السجناء المتورطين في قضايا التطرف والإرهاب عبر برامجَ فكرية، ونفسيةٍ، واجتماعية.ٍ
يعتمد على المناصحة الدينية، العلاج النفسي، إعادة الاندماج المجتمعي، وتقديم الدعم الاقتصادي والوظيفي بعد الإفراج.
وفق تقارير رسمية، بلغت نسبة النجاح أكثر من 80% في منْعِ العائدين إلى الإرهاب.[27]
البُعد الاجتماعي والاقتصادي:
برامجُ دعم الأسر: تُقدمُ مساعداتٍ لأسر الموقوفين في قضايا الإرهاب لتقليل تأثير التنظيمات على محيطهم الاجتماعي.
المبادرات التنموية: دمْجُ فئاتِ الشباب في مشروعاتٍ اقتصاديةٍ ورياضية وثقافية للحدّ من القابلية للتجنيد من قبل الجماعات المتطرفة.
حملات التوعية: عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، لنشر قيم الاعتدال والتسامح.[28]
التقييم والنجاحات:
تصنّف المملكة بين أكثر الدول نجاحًا في تفكيك الخلايا الإرهابية داخليًا، وتعتبر تجربةُ “المناصحة” رائدة عالميًا.
يشير بعض الباحثين الغربيين إلى أن شموليةَ الاستراتيجية (أمنية + فكرية + اجتماعية) تجعلها نموذجًا متميزًا مقارنة ببعض الدول الأخرى التي ركّزت على الجانب الأمني فقط.
ومع ذلك، وُجهت انتقاداتٌ بأن المعالجةَ الفكرية قد لا تكونُ كافيةً إذا لم تُستكملْ بإصلاحاتٍ أوسع في المجال السياسي والاجتماعي.[29]
خامسًا: النموذج السنغافوري في مكافحة التطرف والإرهاب
تُعد سنغافورة من أبرز الدول التي طورت نموذجًا ناجحًا لمواجهة التطرف والإرهاب، خصوصًا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وتفجيرات بالي في إندونيسيا عام 2002، والتي شكّلت تهديدًا مباشرًا لها نظرًا لموقعها في جنوب شرق آسيا ووجود جماعات مثل الجماعة الإسلامية JI وارتباطها بالقاعدة[30].
اعتمدت سنغافورة على مقاربة شاملة Whole-of-Government Approach تمزج بين:
الردْعِ الأمني والاستخبارات، والمعالجة الفكرية والدينية، والتماسك الاجتماعي والاندماج المجتمعي، وكذلك الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.[31]
البُعد الأمني والاستخباراتي:
الاعتقالُ الوقائي: طبّقت سنغافورة قانون الأمن الداخلي (ISA) الذي يسمح باعتقال المشتبه بهم دون محاكمةٍ لفتراتٍ محدّدة، ما مكّنها من تفكيك الخلايا الإرهابية قبل تنفيذ عملياتها.
التعاون الإقليمي والدولي: عززت التعاون مع دول الآسيان، وشاركت في تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة وأستراليا لمواجهة شبكات الإرهاب العابرة للحدود.
– مكافحة التمويل: سنّت قوانين صارمة ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.[32]
البُعد الفكري والديني (برنامج إعادة التأهيل):
برنامج إعادة التأهيل الديني Religious Rehabilitation Group (RRG):
أُطلق عام 2003 بمشاركة علماء ودعاة إسلاميين محليين لمواجهة التأويلات المتشددة التي روّجتها الجماعة الإسلامية.
يقومُ على المناصحة الفكريةِ والدينيةِ داخل السجون مع المعتقلين، عبر تفكيك المفاهيم الخاطئة حول “الجهاد”، “التكفير”، و”الحاكمية”.
يُقدَّم الدعم أيضًا لعائلات المعتقلين لتجنّبِ تعرضهم لانتكاسةٍ أو انجذاب للتيارات المتطرفة.
المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في سنغافورة (ICPVTR): أُنشئ عام 2002، ويُعتبر مركزًا بحثيًا وتعليميًا يعمل على رصد الاتجاهات الفكرية وتطوير أدوات للوقاية الفكرية.[33]
البُعد الاجتماعي والمجتمعي:
بناء التماسك الاجتماعي Social Cohesion:
أطلقت الحكومةُ مبادراتٍ لتعزيز الوحدة الوطنية بين المكونات العرقية والدينية (الملايو المسلمين، الصينيين البوذيين، والهنود الهندوس).
برامج مدرسية لترسيخ قيم التعددية والتعايش منذ سن مبكرة.
المجالس المجتمعية الدينية: تمَّ تفعيلُ دور المجلس الإسلامي في سنغافورة (MUIS) لضمان أن الخطابَ الدينيَ يواكب الاعتدال ويعزز المواطنة.
حملات التوعية العامة: من خلال الإعلام والتواصل الاجتماعي لرفع وعي المواطنين بخطر التطرف وأهمية الإبلاغ المبكر.[34]
البُعد النفسي والاجتماعي لإعادة الاندماج:
الدعمُ النفسي للمفرج عنهم ولأسرهم عبر برامج إعادة الدمج.
توفيرُ فرص التوظيف والتدريب لتقليل مخاطر العودة إلى الفكر المتطرف.
تقديمُ مِنحٍ تعليميةٍ ومساعداتٍ ماليةٍ لأبناء المعتقلين لتقليل آثار الوصم الاجتماعي.[35]
تقييم النموذج ونجاحاته:
النجاحات:
لم تشهدْ سنغافورة أي هجماتٍ إرهابيةٍ كبرى منذ 2001، بفضل الجمع بين الردع الأمني والمعالجة الفكرية.
نموذج المناصحة الدينية (RRG) أصبح مرجعًا عالميًا يُستشهد به في المحافل الدولية.
الانتقادات:
الاعتمادُ على قانون الأمن الداخلي (ISA) أثار جدلًا بين منظمات حقوق الإنسان لكونه يسمح بالاعتقال دون محاكمة.
رغم فعاليةِ برامجِ الاندماج، يبقى الخطرُ قائمًا بسبب البيئة الإقليمية في جنوب شرق آسيا حيث تنشط جماعات مرتبطة بداعش.[36]
الدروس المستفادة من التجربة السنغافورية:
الشمولية: مواجهة الإرهاب عبر الأمن + الفكر + المجتمع.
الشراكة المجتمعية: إشراكُ العلماء، المجتمع المدني، والأسر في برامج الوقاية.
التعليم المبكر: تعزيز قيم التعددية والتعايش منذ المدرسة.
المرونة: المواءمةُ بين قوانين صارمة وبدائل لإعادة التأهيل وإعادة الدمج.
سادسًا: النموذج الألماني في مكافحة التطرف والإرهاب
شهدت ألمانيا منذ تسعينيات القرن الماضي تحدياتٍ متزايدةً متعلقةً بالتطرف، سواء التطرف اليميني بعد توحيد ألمانيا، أو التطرف الإسلامي خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، حيث انطلق عدد من منفذي الهجمات من مدينة هامبورغ، دفع ذلك السلطات الألمانية إلى تطوير استراتيجيةٍ شاملةٍ تقومُ على المقاربة الأمنية – الوقائية – المجتمعية.
ركائز الاستراتيجية الألمانية:
الإطار القانوني والأمني:
تمَّ تعديلُ القوانين لتوسيع صلاحيات الشرطة وأجهزة الاستخبارات الداخلية (BfV) لمراقبة الجماعات الإرهابية واليمينية المتطرفة.
إنشاءُ قوانين لمكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت ، قانون NetzDG لعام 2017.[37]
برامج الوقاية وإعادة التأهيل:
طورت ألمانيا برامج لإعادة دمج العائدين من مناطق النزاع مثل سوريا والعراق، من خلال الدعم النفسي والاجتماعي.
مبادرات مثل برنامج HAYAT لمساعدة الأسر على التعامل مع أفراد معرضين للتطرف.[38]
التعاون متعدد المستويات:
مشاركة البلديات، منظمات المجتمع المدني، المؤسسات التعليمية، والجمعيات الدينية.
مشروع “Demokratie Leben!” (عِش الديمقراطية) الممول من وزارة الأسرة الألمانية، والذي يدعم مئات المبادرات المحلية لمكافحة التطرف.[39]
المقاربة التعليمية والثقافية:
إدخالُ برامجَ توعيةٍ في المدارس والجامعات لتشجيع التفكير النقدي والحد من خطاب الكراهية.
دعمُ الأبحاثِ الجامعية حول الإرهاب والتطرف، وإنشاء مراكز مثل “المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة”.[40]
المقاربة الدينية:
دعم تكوين الأئمة داخل ألمانيا بدلًا من استقدامهم من الخارج، لتقليص التأثيرات الأجنبية.
إنشاء “المجلس الإسلامي الألماني” للحوار بين الدولة والجاليات المسلمة.[41]
عناصر النجاح:
التركيزُ على البُعدِ الوقائي بجانب الإجراءات الأمنية التقليدية.
العملُ التشاركيُ بين الدولة والمجتمع المدني.
المرونةُ في تطوير البرامج حسب طبيعة التهديدات (يمين متطرف، جهادي، أو حتى تطرف يساري).
توظيف البحث العلمي في صياغة السياسات (Evidence-Based Policy).
التحديات القائمة:
تزايدَ خطرُ اليمين المتطرف وحركات “بيغيدا” و”الهوية الجديدة”.
صعوبة التعامل مع العائدين من داعش، خصوصًا النساء والأطفال.
الانتقادات الحقوقية لتوسيع صلاحيات الاستخبارات.
الدروس المستفادة للسياقات العربية:
أهميةُ النهج متعددِ الوكالات: الأمن، التعليم، المجتمع المدني، المؤسسات الدينية.
تعزيزُ المقاربة الوقائية، خاصةً عبر التعليم والدعم النفسي والاجتماعي.
ضرورة إشراك المجتمع المحلي بدل الاعتماد فقط على أدوات الدولة القسرية.
نقاط تقاطُع بين قصص النجاح:
حوكمة متعددة الوكالات: شرطة + تعليم + خدمات اجتماعية + صحة نفسية + مجتمع مدني/ديني، ضمن مسارات إحالة واضحة وشفافة. إرشادات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تُبرز أن تصميم آليات الإحالة وجودة التعاون يحددان الأثر.
تدخّلٌ فردي ٌمخصص مع متابعة لاحقة (Aftercare) وإدارة مخاطر ديناميكية بدل حلول “مقاس واحد للجميع”.
مشروعيةٌ مجتمعيةٌ وخطاب ديني/مدني موثوق: المعاهد الدينية في المغرب، وRRG في سنغافورة، و”السابقون” في ألمانيا عززوا الثقة وخفّضوا الوصم.
الدمج مع سياسات اجتماعية–اقتصادية لمعالجة القابلية للبروباغندا المتطرفة.
كيف نُوطّن الدروس المستفادة محليًا (خارطة طريق تنفيذية)
إنشاء منظومة إحالة وطنية (National/Local Referral Pathway):
غرفة إحالة محلية يقودها الأمن الوقائي مع التعليم والخدمات الاجتماعية والصحة العقلية والشباب والجهات الدينية المعتمدة.
بروتوكولات مشاركة معلومات محكومة قانونيًا، ونماذج تقييم خطورة طبقية (من ضعف/قابلية إلى خطورة عالية). دروس الدنمارك والـOSCE مرجع عملي.
برنامج مرشد/مرافِق حالة (Case Mentoring):
توظيف مرشدين مدرَّبين على المقاربة الحلولية والتوجيه التعليمي–المهني، مع خطط فردية بأهداف زمنية ومؤشرات تقدم. (مستوحى من آرهوس).
مكوّن ديني/فكري مؤسسي:
شراكةّ رسميةٌ مع مجلسٍ علمي/معهد وطني لتأهيل أئمة ومرشدات، وتطوير “أطقم دروس مضادة” للشبهات الشائعة، وخط ساخن للردّ الديني السريع (على غرار المغرب وRRG).
صحة نفسية ودعم أسري:
فرق اختصاصيين (علم نفس سريري، اضطرابات صدمة)، ومجموعات دعم للأهالي، وإحالات علاج إدمان عند الحاجة (توصيات RAN).
صندوق “مسار ثانٍ للحياة”: مساعدة سكنية، تدريب مهني، وساطة تشغيل، ودعم قانوني وحماية لمن ينسحب من شبكات عنيفة (مستوحى من EXIT-Germany).
اتصال واستجابة مجتمعية:
حملات تواصل موجهة (مدارس/جامعات/منصات رقمية) لخفْضِ الوصْمِ ورفْعِ الإبلاغ المبكّر من الأسرة والأقران (نموذج CTCE في الخبرات الأنجلوسفيرية).
حوكمة وقياس أثر:
لوحة متابعة وطنية بمؤشرات: زمن الاستجابة للإحالة، نسبة الالتزام بخطط التدخل، معدلات التعليم/العمل بعد 6–12–24 شهرًا، ومقاييس جودة الحياة، مع تقييمٍ خارجيٍ دوريٍ. راجع توصيات RUSI في أهمية جودة عملية التدخل والثقة.الصحة النفسية عامل مكمّل: توصيات RAN تؤكد مراعاة الاضطرابات/الصدمة ضمن خطط التغيير السلوكي.[42]
النموذج المصري في مكافحة الإرهاب والتطرف
تُعَدّ مصر واحدةً من أكثر الدول التي واجهت تحدياتٍ إرهابيةً ممتدةً منذ السبعينيات مع جماعات العنف الديني (الجماعة الإسلامية، تنظيم الجهاد)، وصولًا إلى تصاعد الإرهاب بعد 2011 خصوصًا في سيناء مع جماعة “أنصار بيت المقدس” التي بايعت داعش لاحقًا، هذا السياق دفع مصر إلى صياغة مقاربة شاملة تعتمد على المستوى الأمني – القانوني – الفكري – التنموي في آن واحد.[43]
الركائز الأساسية للنموذج المصري:
1. المقاربة الأمنية والعسكرية:
شنّت الدولة عملياتٍ عسكريةً واسعةً، أبرزُها العملية الشاملة سيناء 2018، والتي هدفت إلى القضاء على البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية في شمال سيناء، وتعزيز التنسيق بين القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن الوطني.[44]
2. المقاربة القانونية والتشريعية:
إصدار قوانين مكافحة الإرهاب (قانون 94 لسنة 2015) التي منحت السلطات أدوات قانونية واسعة لملاحقة الإرهابيين وتمويلهم، وإنشاء دوائر قضائية مختصة بنظر قضايا الإرهاب.[45]
3. المقاربة الدينية والفكرية:
– الأزهر الشريف: أطلق مرصدُ الأزهر لمكافحة التطرف عام 2015، لمتابعة خطاب الجماعات الإرهابية والرد عليه بأكثر من 12 لغة.
– دار الإفتاء المصرية: أنشأت “مرصد الفتاوى التكفيرية” لمواجهة الفتاوى المتشددة.
– تنظيم مبادرات لنشر “الخطاب الديني الوسطي” عبر الأئمة والوعاظ.[46]
4. المقاربة الإعلامية والثقافية:
أطلقت الدولة حملاتٍ إعلاميةً لمواجهة الفكر المتطرف مثل حملة “مصر بلا إرهاب”.
إنتاج أعمال درامية وسينمائية تعكس خطورة الإرهاب (مثل مسلسل “الاختيار”).[47]
5. المقاربة التنموية والاجتماعية:
الدولة ربطت بين التنمية ومكافحة الإرهاب، خصوصًا في سيناء، من خلال مشروعات البنية التحتية والإسكان وتوفير فرص عملٍ للشباب.وبرامج تمكين المرأة والشباب للحد من استقطاب الجماعات المتطرفة.[48]
عناصر النجاح في التجربة المصرية:
التكاملُ بين الأبعاد الأمنية والفكرية والتنموية.
مركزيةُ المؤسساتِ الدينية المعتدلة مثل الأزهر ودار الإفتاء.
الاستفادة من الإعلام والثقافة لتغيير الوعي المجتمعي.
التنسيق الإقليمي والدولي عبر المشاركة في التحالفات الدولية ضد الإرهاب.