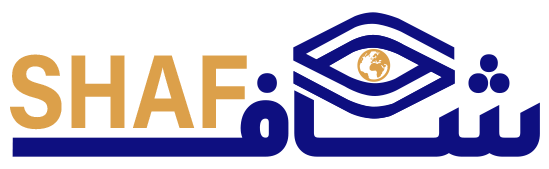المقالات
مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية > تقارير وملفات > الدراسات الأمنية والإرهاب > من التنظيم إلى الدولة: تحولات الإسلام السياسي في ظل الإسلاموفوبيا العالمية
من التنظيم إلى الدولة: تحولات الإسلام السياسي في ظل الإسلاموفوبيا العالمية
- أغسطس 3, 2025
- Posted by: Maram Akram
- Category: إصدارات دورية الدراسات الأمنية والإرهاب
لا توجد تعليقات

إعداد: إلهام النجار
باحث في برنامج الأمن والإرهاب
إيمانًا بأهميةِ الدورِ والتثقيفِ السياسيِ لدى مراكز الفِكر البحثية، والمسئولية التي تقع على عاتقنا بأهمية نشْرِ الوعي ، يُقدم “مركز شاف للدراسات المُستقبلية وتحليل الأزمات والصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا” هذه السلسلة التي تتضمنُ تقريرًا شهريًا عن التطرف والإرهاب، وكذلك تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة التي تمَّ تصديرُها من الغرب عن التطرف والإرهاب، وأن هذه المجموعة من التقارير المتنوعة تُسلط الضوء على العديد من العوامل والتأثيرات المُتعلِقة بجذور الإرهاب والتطرف، حيث يمثّلُ التطرفُ العنيفُ والإرهاب أحدَ أبرز التهديدات التي تواجهُ المجتمعاتِ المعاصرةَ، بما يحملهُ من تداعياتٍ أمنيةٍ، وسياسيةٍ، واقتصاديةٍ، وثقافيةٍ عميقةٍ، وعلى الرغم من تعدد مقاربات التصدي لهذه الظاهرة، إلا أن التجربةَ التاريخيةَ والبحث الأكاديمي أظهرا أن المعالجة الأمنية وحدها غير كافية، ما لم تواكبْها جهودٌ وقائيةٌ عميقةٌ تُعنى بجذور التطرف ومسبباته البنيوية، وفي هذا السياق، شهدَ العالمُ الإسلامي، منذ بدايات القرن العشرين، تحولاتٍ عميقةً على المستويات السياسية والفكرية والاجتماعية، كان من أبرز تجلياتها صعودُ ما يُعرف بـ”الإسلام السياسي” كتيارٍ يسعى إلى إعادة توظيف الدين في المجال العام، وتقديمِ الإسلام كمرجعيةٍ شاملةٍ لتنظيم الدولة والمجتمع، وقد تشكّل هذا التيارُ في البداية كاستجابةٍ لأزماتِ التفكّك الحضاري، والاحتلال الأجنبي، والانحطاط الداخلي، قبل أن يتطوّر لاحقًا إلى حركاتٍ سياسيةٍ منظمةٍ، لعبت أدوارًا محوريةً في الصراع على السُلطة، سواء من موقع المعارضة أو من موقع الحُكم، وقد تعزّز حضور الحركات الإسلاموية بعد ثورات “الربيع العربي” (2011)، حيث وجدت الفرصة للمشاركة السياسية والوصول إلى السُلطة عبر صناديق الاقتراع، لكن سرعان ما اصطدمت هذه التجارب بجملةٍ من التحدياتِ البنيوية، من بينها ضعْفُ الخبرةِ السياسية، الاستقطاب المجتمعي، الصدامُ مع الدولةِ العميقة، والتحولاتُ الإقليميةُ والدوليةُ التي أعادت تشكيل موازين القوى، هذا إلى جانب الضغوط الأمنية والإعلامية التي واجهتها بعض الحركات، والتغيرات الفكرية التي فرضت نفسها على خطابها الاستراتيجي، وفي السياق الموازي، شهدَ العالمُ تصاعدًا لافتًا لظاهرة الإسلاموفوبيا، لا سيٌما في الغرب، حيث باتت هذه الظاهرة تتجاوز حدود الكراهية الفردية إلى أشكال ممنهجة من التمييز السياسي والتشريعي والاجتماعي ضد المسلمين، وقد ساهمت أحداث كبرى – مثل هجمات 11 سبتمبر، وصعود الجماعات الجهادية المتطرفة، والأزمات الأمنية في الشرق الأوسط – في تعزيز صورة “المسلم كتهديد”، مما وفر أرضية خصبة لإنتاج خطاب معادٍ للإسلام، توظّفه بعض الحكومات والتيارات الشعبوية لأهداف انتخابية أو أيديولوجية.
وعليه، يُناقش التقرير التاسع بشكلٍ تحليليٍ شامل جذور الإسلام السياسي وتكوينه، وأبرز تحوّلاته الفكرية والاستراتيجية، وتجارب انتشاره وتراجعه بعد 2011، والتحديات الكبرى التي واجهته، كما يتناولُ ظاهرةَ الإسلاموفوبيا من حيث نشأتها، مظاهرها المعاصرة، سياقاتها السياسية، وتداعياتها الدولية، كما يهدف إلى تقديم فهم مُركّب ومتوازن لإحدى أكثر القضايا تعقيدًا وتشابكًا في الفكر والسياسة المعاصرين.
أولًا: الإسلام السياسي :
الإسلامُ السياسي هو تيارٌ فكريٌ وحركيٌ يرى أن الإسلام ليس مجرد عقيدة دينية وشعائر تعبدية، بل هو نظامٌ شاملٌ للحياة، يشمل الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ويجب أن يُطبّق في المجال العام والدولة.
الجذور والتكوين:
شكّلت الحركاتُ الإسلاموية الحديثة نتاجًا تراكميًا لمزيجٍ من التحوّلات الدينية والاجتماعية والسياسية التي عرفها العالم الإسلامي منذ أواخر القرن التاسع عشر. فقد نشأت هذه الحركات في سياقِ شعورٍ عميقٍ بالأزمة الحضارية، بعد تفكّك الدولة العثمانية وتزايد التدخل الاستعماري، وارتبطتْ بسؤالٍ مركزيٍ: كيف يمكن استعادة قوة الأمة الإسلامية ومكانتها في مواجهة الغرب؟ ، كما تبلورتْ البذورُ الأولى للإسلام السياسي كمشروعٍ يهدفُ إلى تفعيل الإسلام كمرجعيةٍ شاملةٍ تنظّم شؤونَ الدولة والمجتمع، وليس فقط كعقيدةٍ فرديةٍ أو شعائريةٍ، وقد تلاقحتْ أفكار هذه الحركات مع مشاريع الإصلاح الإسلامي التي طرحها رواد مثل جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، ومحمد رشيد رضا، لكنها انتقلت لاحقًا من مستوى “الفكر الإصلاحي” إلى “الممارسة التنظيمية” في إطار جماعاتٍ سياسيةٍ منظّمةٍ، أبرزُها جماعة الإخوان المسلمين في مصر (1928).
أ. مرحلة ما قبل الحداثة (الخلافة):
في العصر الإسلامي الكلاسيكي (الخلافة الراشدة، الأموية، العباسية)، لم يكنْ هناك فصلٌ بين الدين والسياسة، كان الخليفةُ هو القائدَ الدينيَ والسياسي، هذا النموذجُ التاريخيُ ألهَمَ لاحقًا منظّري الإسلام السياسي الذين يرون ضرورة العودة إلى نظام “الخلافة” أو ما يشبهه.[1]
ب. مرحلةُ المواجهةِ مع الحداثة والاستعمار (القرن 19):
شهدتْ هذه المرحلة بروز مفكرين رأوا أن الانحطاطَ الحضاريَ للمسلمين نتجَ عن الابتعاد عن الإسلام، وطرحوا رؤىً للإصلاح ترتكز على الدين، ومن أبرز المفكرين:
جمال الدين الأفغاني (1838–1897):
دعا إلى نهضةٍ إسلاميةٍ سياسيةٍ، ورفْضِ الاستبداد والاستعمار. مثّل نواة الفكر الإسلاموي الحديث، كما دعا إلى “الوحدة الإسلامية” كأداة لمواجهة التفوق الغربي.
محمد عبده (1849–1905):
رغم توجّهه الإصلاحي المعتدل، فتحَ الباب أمام ربط الدين بالحكم، ونقد التقليد الديني الجامد.
رشيد رضا (1865–1935):
تأثر بمدرسة الأفغاني–عبده، وبدأ في بلورة مشروع “دولة إسلامية” تستلهم الخلافة وتُدار بالشورى.[2]
ج. مرحلةُ التنظيمات والحركات (1928–1950)
– تأسيسُ جماعة الإخوان المسلمين – مصر 1928
– المؤسس: حسن البنا (1906–1949).
– أهمُّ أهدافه: “إقامةُ الدولة الإسلامية” من خلال التربية، العمل الاجتماعي، ثم التغلغل في السياسة.
سيد قطب – التأصيل الجهادي للفكرة
في الستينات، طوّر سيد قطب رؤيةً راديكاليةً تقوم على رفض المجتمع الجاهلي والدعوة إلى “الحاكمية لله” بدلًا من قوانين البشر.[3]
التحول من الفكر إلى التنظيم
انتقلتْ الجماعاتُ الإسلامية من الدعوة إلى التنظيم السياسي، ثم في بعض الحالات إلى العنف (مثل الجماعة الإسلامية في مصر)، وفي جنوب آسيا، ظهرت جماعة الإسلام على يد المودودي في باكستان، وهي من أبرزِ منظّري الإسلام كأيديولوجيا سياسيةٍ شاملةٍ.[4]
أبرز الحركات والمنظمات:
الحركات الإسلاموية هي تنظيماتٌ سياسيةٌ – دينيةٌ ترى أن الإسلام ليس دينًا فقط، بل منظومةً سياسيةً متكاملةً يجب تطبيقها في الحُكم والمجتمع والدستور، وتتنوع هذه الحركات بين السلمية والجهادية، وبين المشاركة السياسية والعزوف عنها.
جماعة الإخوان المسلمين – مصر
التأسيس: 1928، حسن البنا.
الفكر: الإسلام شامل (دين ودولة)، تطبيق الشريعة، الدعوة إلى دولة إسلامية عبر التربية والمجتمع.
التاريخ السياسي:
توسّع التنظيمُ في العالم العربي والإسلامي.
دخولُ البرلمان المصري منذ الثمانينات.
وصولُ محمد مرسي إلى الرئاسة (2012) ثم الإطاحة به .(2013)
أبرزُ الفروع الدولية:
حزب النهضة في تونس.
جماعة الإخوان في الأردن وسوريا.
التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في أوروبا وتركيا.[5]
حزب التحرير الإسلامي :فلسطين – بلاد الشام
التأسيس: 1953 على يد القاضي الفلسطيني تقي الدين النبهاني.
الفكر: رفضُ الدولة القُطرية والديمقراطية، والسعي لإعادة الخلافة الإسلامية عبر “العمل الفكري والسياسي غير العنيف”.
النشاط: انتشارُ في الأردن، فلسطين، لبنان، أوروبا (ألمانيا، بريطانيا)، أوزبكستان.
لا يشارك في الانتخابات ولا يعترف بالدساتير.[6]
جماعة الدعوة والتبليغ : الهند- باكستان
التأسيس: 1926 على يد محمد إلياس الكاندهلوي.
الفكر: حركةٌ دعويةٌ غير سياسيةٍ، تركز على التبليغ والدعوة في الأحياء والمجتمعات الفقيرة.
الانتشار: في أكثر من 150 دولة، خصوصًا في جنوب آسيا، شرق إفريقيا، الخليج، أوروبا.
تتجنب السياسة لكن تؤثّر على الهوية الدينية العامة.[7]
جماعةُ الإسلام (Jamaat-e-Islami): باكستان – الهند
التأسيس: 1941، على يد سيد أبو الأعلى المودودي.
الفكر: الإسلامُ هو نظامُ حياةٍ ودولةٍ، ويدعو لتطبيق الشريعة عبر الدولة، والمشاركة السياسية لتحقيق ذلك.
النشاط: لعبتْ دورًا محوريًا في السياسة الباكستانية، وتشارك في الانتخابات.
الجماعة تؤمن بـ”التدرّج” وتحقيق الدولة الإسلامية عبر الوسائل السلمية.[8]
النهضة الإسلامية – تونس
التأسيس: نهاية السبعينات، برئاسة راشد الغنوشي، متأثرة بالإخوان.
الفكر: مزْجُ الإسلامِ بالديمقراطية، وتبنّي القيم الجمهورية، مع مراجعة فكرية في 2016 للتفرقة بين “الدعوي” و”السياسي”.
الدور السياسي: شاركت في الحكم بعد ثورة 2011 حتى 2021، ثم تراجعت مكانتها بعد انقلاب قيس سعيّد.[9]
الجماعاتُ الجهاديةُ (القاعدة – داعش)
أ. القاعدة:
– التأسيس: 1988، على يد أسامة بن لادن وعبد الله عزام، بعد الحرب السوفيتية في أفغانستان.
– الفكر: الجهادُ العالميُ ضد “العدو البعيد” (أمريكا، الغرب)، وإقامة “الخلافة”.
– النشاط: ضرباتٌ إرهابيةٌ عالميةٌ (نيويورك، مدريد، نيروبي).
ب. داعش (الدولة الإسلامية):
– التأسيس: من رحم تنظيم القاعدة في العراق، على يد أبو بكر البغدادي، ثم إعلان “الخلافة” في 2014.
-الفكر: تكفيري شديد، يستهدف المسلمين والغرب معًا، ويمارس “الصدمة والرعب” الإعلامية.[10]
الجماعة الإسلامية – مصر
التأسيس: نهاية السبعينات، على يد طلاب الجامعات.
الفكر: بدأ سلفيًا–جهاديًا، ثم دخل في مواجهة مع الدولة (اغتيال السادات 1981)، ثم تحوّل لاحقًا بعد المراجعات الفكرية إلى “الجماعة الدعوية” المعتدلة.
أبرز قادتها: عمر عبد الرحمن، ناجح إبراهيم.[11]
ج. انتشار وتحوّلات الإسلام السياسي:
شهدت حركات الإسلام السياسي مراحلَ متعددةً من الانتشار الإقليمي والعالمي، وتحولاتٍ فكريةً واستراتيجيةً فرضتها المتغيرات السياسية والدولية، خاصةً بعد أحداث مثل: هزيمة 1967، الثورة الإيرانية، نهاية الحرب الباردة، الربيع العربي، وصعود الإسلاموفوبيا.
1- الانتشار الجغرافي
العالم العربي:
مصر: كانت المركزَ الأيديولوجيَ لحركات الإسلام السياسي عبر الإخوان، ثم انتقل الفكر منها إلى الأردن، سوريا، السودان، فلسطين.
تونس: برزت حركة النهضة بقيادة راشد الغنوشي بعد الثمانينات.
السودان: تحالفَ الإسلاميون بقيادةِ حسن الترابي مع الجيش عام 1989 وسيطروا على الحكم حتى 1999.
الجزائر: الجبهةُ الإسلامية للإنقاذ (FIS) فازت في الانتخابات عام 1991، قبل إلغاء نتائجها واندلاع الحرب الأهلية (1992–2002).[12]
آسيا:
باكستان: جماعةُ الإسلام لعبتْ دورًا بارزًا في السياسة والبرلمان، وتأثرت بها طالبان.
تركيا: بدأ التيار الإسلامي مع نجم الدين أربكان (حزب الرفاه) ثم تطوّر إلى حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان (إسلام سياسي محافظ مع خطاب علماني).
إيران: نموذج الثورة الإسلامية 1979 بقيادة الخميني أحدث تحولًا عالميًا في الإسلام السياسي الشيعي.[13]
أوروبا والغرب:
انتشرت الجماعات المرتبطة بالإخوان عبر المراكز الثقافية والمنظمات غير الحكومية:
في فرنسا: اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF).
في بريطانيا: رابطة المسلمين البريطانيين (MAB).
في ألمانيا: جماعة Millî Görüş (الرؤية الوطنية) وأفراد من التنظيم الدولي.[14]
التحوّلات الفكرية والاستراتيجية:
لم يكنْ الإسلامُ السياسيُ كيانًا جامدًا أو خطابًا مغلقًا، بل مرّ خلال العقود الماضية بسلسلةٍ من التحولات الفكرية والاستراتيجية، عكست تفاعله مع تعقيدات الواقع السياسي المحلي والإقليمي، وضغوط الأنظمة، وتبدّل موازين القوى الدولية، فمنذ نشأته كتيارٍ يدعو إلى “أسلمة الدولة والمجتمع”، شهدَ الإسلامُ السياسي تقلباتٍ في الرؤية والمنهج والأهداف، خاصةً في ظل التحولات الكبرى التي عرفها العالم العربي، مثل انهيار الخلافة، صعود القومية، الحروب مع إسرائيل، ثم الثورات والانتكاسات بعد 2011، وقد دفعت تجربة الحكم، والانخراط في العملية السياسية، ثم الإقصاء أو القمع لاحقًا، العديد من الحركات الإسلاموية إلى مراجعة مقولاتها التأسيسية، وطرّح أسئلةٍ جديدةٍ حول مفاهيم: “الدولة الإسلامية”، “الشريعة”، “الحُكم”، و”الشرعية”،هذا ما أفرز ملامح خطاب جديد يسعى إلى المواءمة بين المرجعية الدينية ومتطلبات الديمقراطية، وبين الهوية الإسلامية والتعددية السياسية.
كما أدّت المتغيرات الجيوسياسية وصعود الإسلاموفوبيا إلى إعادة صياغةِ الاستراتيجيات التنظيمية، سواء بالتحول من الصدام إلى التدرج، أو من الحزبية المغلقة إلى الانفتاح المدني، أو من المركزية التنظيمية إلى اللامركزية والانتشار الخارجي، ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي:
أ. من الجهاد إلى السياسة:
بعد فشل محاولاتِ العنف في التسعينات (الجزائر، مصر، سوريا)، اتجهت معظم الحركات إلى المشاركة السياسية والديمقراطية، مثل:النهضة التونسية، الإخوان في مصر بعد الثورة، حماس في فلسطين (دخول الانتخابات عام 2006).[15]
ب. المراجعات الفكرية:
أجرتْ الجماعة الإسلامية المصرية “مراجعات فكرية” داخل السجون بعد التسعينات، وقررت التخلي عن العنف، كما تحوّلت السلفيةُ السياسيةُ من عزوفها عن السياسة إلى دعم الأنظمة في بعض الدول (مثل دعم السلفيين لنظام السيسي في مصر 2013–2015)[16]
ج. إعادة التموضع بعد 2013:
بعد انقلاب 3 يوليو 2013 في مصر وسقوط حكم الإخوان، دخلَ الإسلامُ السياسيُ مرحلة “النكسة الثانية”، كما واجهت الجماعات الاستئصال السياسي والأمني والإعلامي في العديد من الدول، ما أدى إلى:
انقسام داخلي بين الواقعية والمواجهة.
انتقال ثِقَلِ التنظيم الدولي إلى تركيا وقطر.
استخدام “الإسلاموفوبيا”ذريعة لتجريم كل النشاط الإسلامي.[17]
ثانيًا: الإسلاموفوبيا
التعريف والأصول التاريخية:
كلمة “إسلاموفوبيا” (Islamophobia) مركبة من “إسلام” و”فوبيا” (رهاب أو خوف مَرَضي).
يُشير المصطلح إلى العداء أو الخوف أو الكراهية الموجّهة ضد الإسلام أو المسلمين، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع أو المؤسسات، وفي الأدبيات الغربية: أُعيد استخدام المصطلح في تقرير Runnymede Trust البريطاني عام 1997 بوصفه “تحيزًا غير عقلاني ضد الإسلام والمسلمين”، وحدّد ثماني خصائص لهذا العداء، منها: اعتبارُ الإسلامِ دينًا متخلفًا، وعدوانيًا، وغير قابل للإصلاح.[18]
الأصول التاريخية:
أ. في العصور الوسطى: الجذور الصليبية:
نشأت الكراهيةُ تجاه الإسلام في أوروبا مع الحروب الصليبية (1096–1291) حيث صُوّر المسلمون كـ”أعداء المسيح”، وظهر خطاب “الشرق البربري”، وسادت صورة مشوّهة عن النبي محمد في الأدبيات المسيحية القروسطية بوصفه “كاذبًا أو دجالًا”، كما في كتابات دانتي (الكوميديا الإلهية).[19]
ب. خلال العصور الاستعمارية:
خلال القرنين 18–19، اعتبرَ المستشرقون الإسلام دينًا جامدًا غير قابل للتحديث، كما برّرَ الاستعمار الأوروبي وجودَه في العالم الإسلامي بأنه “تحضيريٌ”، وظهر خطاب “عبء الرجل الأبيض” لتطوير “الشرقي المتخلف”، كما وصف إرنست رينان (Renan) – وصف الإسلام بأنه “يُعادي العقل والفلسفة”، كما أن اللورد كرومر – حاكم مصر البريطاني، اعتبر الإسلام “عقبة أمام تقدم المرأة”[20]
ج. بعد الحرب الباردة (1989–2001):
– بسقوط الاتحاد السوفييتي، بدأ الغرب يبحث عن “عدو جديد”.
– جاء صموئيل هنتنغتون في مقالته الشهيرة “صدام الحضارات” (1993) ليطرحَ الإسلامَ .كـ”أخطر تهديد للحضارة الغربية”.
– قال هنتنغتون: ” الحدود الإسلامية دموية”.
– هذا الفكر غذّى عداءً سياسيًا وثقافيًا ضد المسلمين حتى قبل أحداث 11 سبتمبر.[21]
د. بعد أحداث 11 سبتمبر 2001:
– تصاعد الإسلاموفوبيا عالميًا بعد هجمات 11 سبتمبر، حيث تمّ ربطُ الإسلام بالإرهاب بشكلٍ مباشر.
– سنّت الدول الغربية قوانين استثنائيةً تمس الجاليات المسلمة:
– قوانين الهجرة والمراقبة.
– حظْرُ النقاب والحجاب (فرنسا، النمسا).
– خطاب إعلامي يصوّر المسلم كخطر محتمل.[22]
مظاهرُ الإسلاموفوبيا وتطورها المعاصر:
تطورتْ الإسلاموفوبيا في العقود الأخيرة من كونها مجردَ تحاملاتٍ فرديةٍ أو صورٍ نمطيةٍ إلى أن أصبحت ظاهرةً مُمأسسة ومعولمة، تتجلّى في السياسات الحكومية، والتشريعات، والخطاب الإعلامي، والسلوك المجتمعي، وقد ساهمت أحداث كبرى مثل هجمات 11 سبتمبر 2001 وصعود تنظيمات متطرفة في ترسيخ صورة “المسلم كتهديد”، مما وفّر غطاءً سياسيًا وأيديولوجيًا لتبرير القيود والتمييز ضد المسلمين في الغرب، وأحيانًا في أوطانهم، ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي:
الإسلاموفوبيا كممارسة ومؤسسة:
تجاوزتٍ الإسلاموفوبيا مجرد “تحيّز ثقافي” لتصبحَ ممارسةً مؤسساتيةً، تتجلّى في السياسات العامة، والتشريعات، والإعلام، وسلوكيات الأفراد، حيث:
السياسة: سنّ قوانين موجّهة ضد المسلمين (حظر الحجاب، قيود على بناء المساجد، قوائم مراقبة).
الإعلام: تصويرُ المسلمين كإرهابيين، متطرفين، غرباء، أو كارهين للمرأة.
المجتمع: جرائمُ كراهية، مضايقات، تمييز في الوظائف، المدارس، والمطارات.
القانون: قوانين استثنائية بعد 11 سبتمبر، المراقبة دون إذن قضائي، تصنيف جمعيات إسلامية كمتطرفة.
2- أشكالُ الإسلاموفوبيا المعاصرة:
أ. الإسلاموفوبيا السياسية (المُمأسسة)
قوانين فرنسا مثال صارخ:
حظْرُ الحجاب في المدارس (2004)
حظر النقاب في الأماكن العامة (2010)
قانون “مكافحة الانفصالية” (2021) يستهدف المسلمين ضمنيًا.[23]
وفي الهند، الإسلاموفوبيا أصبحت سياسةً رسميةً ضمن خطاب “الهندوسية القومية” بقيادة حزب BJP:
قوانين الجنسية تستثني المسلمين.
تَزايدُ الاعتداءات الجماعية عليهم.[24]
ب. الإسلاموفوبيا الإعلامية:
دراساتٌ غربيةٌ أثبتت أن وسائل الإعلام تضاعف ُالتغطية عندما يكون الفاعلُ مسلمًا، كما أن تغطية الهجمات الإرهابية التي ينفذها مسلمون تزيد بـ 357% إلى 449% مقارنة بغيرهم
في السينما والدراما الغربية:
صورة “الإرهابي العربي” أو “الرجل الملتحي العنيف” أو “المرأة المسلمة المضطهدة” متكررة.[25]
ج. الإسلاموفوبيا المجتمعية (جرائم الكراهية والتمييز)
جرائمُ الكراهيةٌ ضد المسلمين تزايدت في أوروبا والولايات المتحدة بعد كل حادثٍ إرهابيٍ كبيرٍ، مثل:
بعد هجمات 11 سبتمبر 2001: سجلت FBI مئات الهجمات ضد مسلمين ومساجد.
بعد هجمات باريس 2015: زادت الاعتداءات الجسدية واللفظية على المحجبات في فرنسا.
مذبحة كرايستشيرش في نيوزيلندا (2019): مقتل 51 مسلمًا داخل المسجد على يد متطرف أبيض.[26]
3- الإسلاموفوبيا الرقمية (Online Hate)
صارتْ مواقعُ التواصل الاجتماعي ساحاتٍ رئيسيةً لنشْر الكراهية ضد المسلمين،حيث :
حملات منظمة مثل BanIslam، StopSharia
خطابات السياسيين اليمينيين المتطرفين مثل ترامب، لوبان، فيلدزر، بولسونارو.[27]
في الهند، يُستخدم واتساب وتويتر لتأجيج العنف الطائفي ضد المسلمين.
ثالثًا: تطور الإسلام السياسي بعد الثورات والتحولات الإقليمية
شهدَ الإسلامُ السياسيُ تحولاتٍ جذريةً بعد اندلاع ثورات الربيع العربي (2011)، إذ انتقل من هامش المعارضة إلى مركز السُلطة في بعض الدول، قبل أن يتعرّض لاحقًا إلى نكَساتٍ عميقةٍ بفعل الثورات المضادة، الانقلابات العسكرية، والانقسام المجتمعي.
مراحل تطور الإسلام السياسي بعد 2011:
صعود الإسلاميين (2011–2013):
في أعقابِ انهيار أنظمةٍ استبداديةٍ (مبارك، بن علي، القذافي)، وصل الإسلاميون للسلطة عبر الانتخابات:
مصر: فوْزُ الإخوان (حزب الحرية والعدالة) بالرئاسة والبرلمان.
تونس: فوْزُ حركةِ النهضة بقيادة راشد الغنوشي.
المغرب: صعودُ حزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل).
ليبيا واليمن: مشاركة الإسلاميين في المرحلة الانتقالية.
أسباب الصعود:
التنظيم القوي والتغلغل المجتمعي.
غياب البدائل السياسية المنظمة.
تعاطف شعبي مع الخطاب الديني بعد عقود من التهميش.[28]
النكسة والانهيار (2013–2017)
مصر: انقلابُ 3 يوليو 2013 ضد الرئيس محمد مرسي وعودةُ النظام العسكري – حظْرُ جماعة الإخوان وتصنيفها “إرهابية”.
تونس: تصاعد الاستقطاب، انسحاب النهضة من الحكومة طواعية في 2014 لصالح التوافق.
ليبيا واليمن: الفوضى الأمنية، تحولَ الصراعُ إلى حروبٍ أهليةٍ وتدخلاتٍ خارجيةٍ.
ونتجَ عن ذلك انقسامٌ داخل صفوف الإسلاميين: تيارات إصلاحية مقابل راديكالية.[29]
التكيّف وإعادة التموضع (2017–2022)
الإسلاميون المعتدلون بدأوا يراجعون تجاربهم، فبرزتْ دعواتٌ لفصْل “الدعوي” عن “السياسي” (كما في النهضة التونسية).
اتجهت الحركات نحو الاندماج المدني أو الهجرة التنظيمية إلى الخارج (تركيا، أوروبا)، والتمسك بـ”الشرعية الانتخابية” خفّ، لصالح خطاب الواقعية والبقاء.[30]
الانقسام والشتات (2022–2025)
مع ازدياد الضغوط الإقليمية:
تصنيفُ بعض الحركات كإرهابية (خليجيًا وعربيًا).
تجفيفُ منابع التمويل والدعم.
هجرة قياداتها إلى المنفى (تركيا، لندن، أوروبا).
وتبلورت تيارات ثلاثة:
التيار البراغماتي: يتبنّى خطابَ المواطنة والديمقراطية (مثال: إسلاميو المغرب، أردوغان، النهضة سابقًا).
التيار الجهادي: يرى أن الخيارَ السلميَ فشل (بقايا داعش، بعض السلفيات الجهادية).
تيار فكري تجديدي: يعيدُ النظر كليًا في فكر الإسلام السياسي، مثل مبادرات د. عبد الله النعيم أو إياد أبو مغيْصيب.[31]
رابعًا: التحديات الكبرى التي واجهها الإسلاميون
رغم ما حققتهُ الحركاتُ الإسلاميةُ من حضورٍ واسعٍ في المشهدين الدعوي والسياسي، خاصةً بعد ثورات الربيع العربي، فإنها اصطدمت بجملةٍ من التحديات البنيوية والوظيفية التي أضعفت من قدرتها على الاستمرار والتأثير، فقد وجدت نفسها بين مطرقة الضغوط الداخلية من أنظمةٍ سلطويةٍ ترى في الإسلاميين تهديدًا وجوديًا، وسندان التوقعات الشعبية العالية التي لم تستطعْ الإيفاءَ بها، إضافةً إلى التحديات الفكرية والتنظيمية الناتجة عن تغير السياقات الإقليمية والدولية، وقد تنوعت هذه التحديات بين أزمات الهوية والمشروع، وضعْفِ الكفاءة في إدارة الدولة، والانقسامات الداخلية، والاستهداف الأمني والسياسي، فضلًا عن تصاعد الإسلاموفوبيا الذي أثّر على صورتها الدولية، ويمكن توضيح هذه التحديات من خلال الآتي:
ضعف الكفاءة السياسية: عدمُ الجاهزيةِ للحكم رغم الشعبية الواسعة.
الاستقطابُ الأيديولوجي: مواجهةٌ شرسةٌ من التيارات العلمانية والقومية.
العداء الإقليمي والدولي: تحالفاتٌ إقليمية ضد صعود الإسلاميين (السعودية، الإمارات، إسرائيل).
الانقسامات الداخلية: خلافاتٌ فكريةٌ وتنظيمية – صراعات بين “قُدامى” و”شباب”.[32]
خامسًا: موقع الإسلام السياسي في التحولات الإقليمية (2025)
لم يعدْ الإسلامُ السياسي هو البديل الأوحد أو “المخيف”، بل أصبحَ جزءًا من المشهد المتعدد، وفشَلْ الإسلاميين في الحكم منحَ الفرصة لعودة الأنظمة السلطوية، لكنه أيضًا أجبر الإسلاميين على تطوير خطابهم.
وهناك بعض الحركات انخرطت في التحولات من أبرزها:
في تونس: بعد الانقلاب الدستوري لقيس سعيّد، تعرّضت النهضة للتهميش، ما دفعها لتفكيك خطابها القديم.
في السودان: الإسلاميون يعيدون التموضع بعد الإطاحة بالبشير.[33]
في المغرب: حزب العدالة والتنمية خسر الانتخابات (2021) بعد عشر سنوات في الحكم.