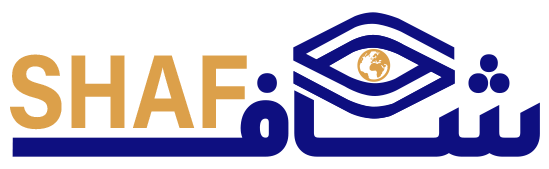المقالات
مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية > تقارير وملفات > وحدة الدراسات الأفريقية > العلاقاتُ المصرية-الصينية: الأبعاد، المُحددات، والآفاق
العلاقاتُ المصرية-الصينية: الأبعاد، المُحددات، والآفاق
- أغسطس 21, 2025
- Posted by: Maram Akram
- Category: تقارير وملفات وحدة الدراسات الأفريقية وحدة الشؤون الدولية
لا توجد تعليقات

إعداد: دينا دومه
باحث مساعد في وحدة شؤون الشرق الأوسط
تُمثّلُ العلاقاتُ المصريةُ–الصينيةُ نمُوذجًا مُتفردًا في مسار التفاعلات الدولية، لاسيَّما بين دول الجنوب العالمي، إذ تجمعُ بين عُمقٍ تاريخيْ مُمتد وجذورٍ حضاريةٍ ضاربةٍ في القِدمِ من جهة، ورؤيةٍ استراتيجيةٍ مُعاصرة تسعى إلى تحقيق مصالح مُتبادلة وتوازنات مُشتركة من جهةٍ أخرى، فمُنذ إرساء أسس التواصل الدبلوماسي بين القاهرة وبكين في مُنتصف القرن العشرين، قامت هذه العلاقات على مُرتكزاتٍ راسخةٍ قوامها الاحترامُ المُتبادل، وعدمُ التدخلِ في الشؤون الداخلية، والتعاون البنّاء، الأمرُ الذي أتاح لها أن تتطورَ تدريجيًا وصولًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في العِقْد الأخير، وبذلك أصبحت العلاقات بين البلدين إحدى الركائز المحورية في مُعادلة الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي، ولا تقف أهميتها عند حدود البعد الثنائي فحسب، بل تتجاوز ذلك لتغدوَ عنصرًا فاعلًا في إعادة صياغة التوازنات العالمية في ظلّ التحولات البنيوية المُتسارعة للنظام الدولي، ومن هذا المُنطلق، يتناول هذا المقال تحليل الأبعاد المُتعددة للعلاقات المصرية–الصينية، ورصْدَ المُحددات التي تحكم مساراتها، واستشراف آفاقها المُستقبلية في ضوء ما تطرحه البيئة الدولية من تحديات وما تُتيحه في الوقت ذاته من فرص للطرفين.
أولًا: مسارُ العلاقات المصرية-الصينية: التطور التاريخي وأبرز المحطات
تتمتع مصر والصين بتاريخٍ طويلٍ ومُعقّد من العلاقات الدبلوماسية، يمتد إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث كانت مصرُ أولَ دولةٍ عربيةٍ وإفريقيةٍ تقيمُ علاقاتٍ رسميةً مع جمهورية الصين الشعبية في عام 1956[1]، وقد شكّل هذا الاعتراف المُبكر أساسًا للعلاقات السياسية القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعلى مدار أكثر من نصف قرن، تطورت هذه العلاقات لتصبحَ نموذجًا للشراكة، إذ تُعد الصين أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين لمصر في المنطقة، وتستند هذه الشراكة إلى مراحلَ تاريخيةٍ مُتعاقبةٍ، يمكن تقسيمها على النحو التالي:
1- المرحلة الأولى: مرحلة التأسيس (الخمسينيات والستينيات): بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، شكّلت مصر دعمها الحازم للصين في استعادة مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة مؤشرًا على التوجّهِ السياسيِ المصري تجاه قضايا العدالة الدولية وحقوق الدول في تقرير مصيرها، تم تأسيس العلاقات الدبلوماسية رسمياً في 30 مايو 1956، وشملتْ تبادلَ الدعم السياسي والتعاون الاقتصادي والثقافي. خلال هذه المرحلة، قدّمت الصين دعمها لحركات التحرر الوطني في إفريقيا وآسيا، وهو ما عزّز مكانةَ مصر كدولةٍ محوريةٍ في العالم العربي وإفريقيا، وساعد على تأسيس قاعدة الثقة المتبادلة بين القاهرة وبكين. وقد انعكستْ هذه العلاقات في مجالاتٍ عدة، منها تَبادلُ البعثاتِ الثقافية والزيارات الرسمية، فضلًا عن تقديم المساعدات الفنية في المجالات الاقتصادية الأساسية، مما ساعد مصر على تعزيز قدراتها التنموية في تلك الفترة.[2]
2- المرحلة الثانية: مرحلةُ التحوّلات الجيوسياسية (السبعينيات والثمانينيات): شهدتْ هذه المرحلة تأثيراتٍ كبيرةً للتغيرات الجيوسياسية العالمية، بما في ذلك الثورة الثقافية في الصين، التي أدت إلى سحْبِ معظم السفراء الصينيين من الدول الأخرى، إلا أن الصين أبقت على سفيرها في مصر، ما يعكسُ المكانةَ الاستراتيجيةَ للقاهرة في السياسة الصينية. وقد تجسّدت هذه المكانة بوضوحٍ خلال حرب أكتوبر 1973، حيث سارعت الصين لإعلان دعمها الكامل لمصر في جهودها لاستعادة الأراضي المُحتلة، ما أظهر الثقةَ السياسيةَ المتبادلةَ وأهمية مصر في توازن القوى الإقليمي، كما شملت المرحلة الثانية تعزيز التعاون الأمني والثقافي، من خلال تبادل الوفود الرسمية والمسؤولين، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والتِقَني لمصر في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعات الأساسية والتعليم.[3]
3- المرحلة الثالثة: مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة (التسعينيات حتى الآن): انطلقت هذه المرحلة على أساس مبادئ مؤتمر باندونج عام 1955 المُتعلقة بالمنفعةِ المُتبادلة والمصالح المشتركة، ثم تطورت لتعميق التعاون المستمر بين البلدين، وشهدتْ توقيعَ عددٍ كبيرٍ من الاتفاقيات في مجالات البنية التحتية، التعليم، التكنولوجيا، الثقافة، والاستثمار. وقد ساعد هذا النهْجُ في تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر، حيث أصبحت الصين أكبر شريك تجاري، وأسهمت الشركات الصينية بنشاطها في تطوير الصناعات المختلفة بما في ذلك مشاريع المقاولات الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة.
4-الزيارات واللقاءات الرئاسية المتبادلة : كان للمتغيرِ القيادي دورٌ مهمٌّ فيما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين في الوقت الراهن. بدايةً من جمال عبد الناصر وشوان لاي، وصولا إلى الرئيسين “عبد الفتاح السيسي” و”شي جين بينغ”، اللذين كان لهما دورٌ كبيرٌ في دفْعِ العلاقات الثنائية إلى الأمام[4]، وفيما يلي أبرز محطات اللقاءات:
ففي 22 ديسمبر 2014، بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أولَ زيارةٍ رسميةٍ له للصين عقِبَ انتخابه رئيساً للجمهورية، حيث استقبله الرئيس الصيني شي جين بينغ. وخلال هذه الزيارة تمَّ توقيعُ وثيقة الشراكة الاستراتيجية التي وضعت أسس التعاون الممتد بين البلدين، مؤكدةً الالتزام بالمبادئ المتمثّلةِ في المنفعة المتبادلة واحترام السيادة الوطنية، وهي مُحدداتٌ داخليةٌ هامةٌ تعكسُ الإرادة السياسية للقيادتين لتعميق التعاون.
تواصلت هذه الزيارات في 1 سبتمبر 2015، حيث شارك الرئيس السيسي في احتفالات الصين بالعيد الوطني والذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، بحضور القوات المسلحة المصرية ضمن العرض العسكري، ما يعكسُ تعبيراً عن التعاون العسكري والأمني، وتبادلِ الخبرات في مجالات الدفاع ومكافحة الإرهاب، كجزءٍ من المحددات الداخلية المصرية التي ترتبطُ بتعزيز الأمن الوطني والإقليمي.
في 21 يناير 2016، زار الرئيس الصيني مصر، وجرى استعراضُ سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك دعمُ المبادرات الاقتصادية الكبرى مثل “الحزام والطريق”، وتوسيعُ نطاقِ التبادل التجاري بين الصين والدول العربية والأفريقية. هذا اللقاءُ أبرزَ المحددات الخارجية للعلاقات، إذ تعكسُ مصر موقعها الجغرافي الاستراتيجي كحلقةِ وصلٍ بين آسيا، إفريقيا، والعالم العربي، إضافةً إلى دورها الاقتصادي كمركزٍ للتجارة والاستثمار.
وفي 3 سبتمبر 2016، قام الرئيس السيسي بزيارة الصين للمشاركة كضيفٍ خاصٍ في قمة مجموعة العشرين، حيث ركّز على تعزيز اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يمثّل تفاعلَ المحددات الداخلية لمصر مع التحوّلاتِ الاقتصاديةٌ الدولية. بعد ذلك، في 4 سبتمبر 2017، شارك الرئيس في قمة بريكس 2017، وتناولَ الحوارُ الاستراتيجُي قضايا تنمية الأسواق الناشئة والدول النامية، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، إلى جانب توقيع ثلاثِ اتفاقياتٍ اقتصاديةٍ هامةٍ، ما يعكس الدمج بين المحددات الداخلية والخارجية في إطار التحالفات متعددة الأطراف.
توالت الزيارات في 1 سبتمبر 2018 بمشاركة الرئيس السيسي في قمة منتدى التعاون الصيني–الأفريقي، حيث ناقشَ تعزيزَ العلاقاتِ الثنائيةِ في المجالات كافة، كما زارَ أكاديميةَ الحزب الشيوعي الصيني، ما يعكسُ اهتمامَ مصر بتعزيز التعاون السياسي والثقافي مع الصين، واستفادة الأطراف المصرية من الخبرات الصينية في الإدارة والتنمية.
وفي 25 أبريل 2019، زار الرئيس السيسي الصين للمشاركة في قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، حيث جرى بحْثُ تفعيلِ المبادرة الصينية وتعزيز المشاريع المشتركة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن، مع عقْدِ لقاءاتٍ مع نُخبةِ مجتمع الأعمال الصينيين، ما يوضّحُ الأهميةَ الاقتصادية لمصر كمحورٍ إقليميٍ ومحدّدٍ داخليٍ للاستثمار.
كما شهدتْ الفترة التالية مشاركةَ مصر في فعاليات البريكس بلس في 24 يونيو 2022 عبر الفيديو كونفرانس، بما يعكسُ الدور المتنامي لمصر ضمن التجمّعاتِ الاقتصاديةِ متعددةِ الأطرافِ، وتأكيد مكانتها السياسية والاقتصادية الدولية. وفي 9 ديسمبر 2022، التقى الرئيسان في الرياض على هامش القمة العربية–الصينية الأولى، حيث تمَّ الاتفاقُ على تطوير العمل المشترك لتعزيز العلاقات الاستراتيجية، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
وفي مارس 2023، بعثَ الرئيس السيسي برقيةَ تهنئة إلى الرئيس الصيني لي تشيانغ بمناسبة إعادة انتخابه، مؤكدًا على تعزيز التعاون بين البلدين في جوٍ من الثقة المتبَادلةِ. وفي سبتمبر 2023، التقى الرئيسان على هامش قمةِ مجموعة العشرين في نيودلهي، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المشتركة. وفي مايو 2024، تمت زيارة الرئيس السيسي للصين بمناسبةِ الذكرى العاشرة لترفيعِ العلاقاتِ إلى مستوى الشراكةِ الاستراتيجيةِ الشاملةِ، حيث جرتْ مباحثاتٌ موسّعةٌ حول نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، بما يشملُ السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والصناعات الكيماوية والزراعية الحديثة، إضافة إلى التعاون الإعلامي والثقافي والأكاديمي.
أخيرًا، في 9 يوليو 2025، زار رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج مصر، والتقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، في إطار توجّهٍ استراتيجيٍ متصاعدٍ يعكسُ استمرارَ دفْعِ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ثانيًا: أهم المُحددات والعوامل الحاكمة
ترتكزُ العلاقة بين مصر والصين على عددٍ من المُرتكزات والعوامل الحاكمة التي دفعت في اتجاه التقارب والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث يُمكن إجمالُ ذلك في عددٍ من المُحدّدات والتي أهمها:
1- المُحدد الحضاري والتاريخي: تُعدّ المحدّدات التاريخيةُ والحضاريةُ من أبرز العناصر التي تشكّل قاعدةً صلبةً للعلاقات المصرية–الصينية، حيث تتمتعُ كلٌ من مصر والصين بجذورٍ حضاريةٍ عميقةٍ تمتد لآلاف السنين، وهو ما خلقَ مجموعةً من القيم والمبادئ المشتركة التي أسهمت في تعزيز الثقة والاحترام المتبادل بين الشعبين والدولتين. هذه الخلفيةُ الثقافيةُ أعطت العلاقاتٍ الثنائيةَ دفعةً قويةً منذ بداياتها، إذ ينظرُ قطاعٌ واسعٌ من المصريين إلى الصين بإيجابيةٍ، لا ترتبط بأي تاريخٍ استعماريٍ أو سيطرةٍ خارجيةٍ، ما يعزّز الانطباعَ الإيجابيَ تجاه الشراكة مع بكين. في السنوات الأخيرة، تحولت هذه المحددات الثقافية إلى عنصرٍ استراتيجيٍ في صياغة السياسة الخارجية المصرية، حيث يُنظر إليها كوسيلةٍ لتعزيز الدور المصري على الساحة الدولية، واستثمار القواسم الثقافية المشتركة لتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتعليمية والتكنولوجية والثقافية.
2- احترام السيادة والخصوصية الوطنية: تبرزُ مجموعةٌ من المبادئ والمُرتكزات التي تشكل دافعًا قويًا لتعميق التعاون المصري–الصيني. فالمصالحُ المشتركةُ لكلا البلدين تتمثّل في رفْضِ فكرة “القطب الأوحد”، والسعي إلى بناءِ نظامٍ عالميٍ أكثر عدالةً وتوازنًا، قائمٍ على احترام سيادة الدول ومبادئ الدولة الوطنية، كما يشتركُ البلدان في موقفٍ موحّدٍ تجاه التعامل مع الفاعلين المسلحين غير الدوليين، ودعم الاستقرار الإقليمي دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع رفض تسييس قضايا حقوق الإنسان في السياسة الدولية، وهو ما يعكسُ توافقَ الرؤى حول ضرورةِ احترام الخصوصية الوطنية والحسابات الداخلية لكل دولة. هذه المحدّدات الاستراتيجية جعلت من مصر شريكًا موثوقًا للصين، خاصة في القضايا الإقليمية والشرق أوسطية.
3- الموقف الصيني الداعم تجاه القضية الفلسطينية:
شكّلت الأزماتُ الإقليميةُ، وعلى رأسها الحرب على غزة في أكتوبر 2023، اختبارًا حقيقيًا للعلاقات المصرية–الصينية، حيث تحركت الصين بشكّلٍ فعّالٍ على الصعيد الدبلوماسي للضغط من أجل وقْفِ إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة. استخدمت بكين خطابًا صارمًا ضد الجرائم الإسرائيلية، وأدانت العقبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تمرير قراراتِ وقْفِ النار في مجلس الأمن، مؤكدًا دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامةِ دولةٍ مستقلةٍ والحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة [5].
لعبتْ مصر دور الوسيط والميسر للجهود الصينية، حيث انعقدت في بكين دورتان للحوار الوطني بين فتح وحماس خلال أبريل ويونيو 2024، وأسفرت عن “إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية” الذي تضمن ثماني نقاط رئيسية[6]، من بينها تشكيلُ حكومةٍ وطنيةٍ مؤقتةٍ وقيادة فلسطينية موحدةٍ وإجراء انتخابات لمجلسٍ وطنيٍ جديد. هذه المبادرةُ عكست قدرة الصين على الانخراط في المفاوضات الإقليمية بهدوء وحياد، وتأكيد مصر على أهمية تعزيز الدور الدبلوماسي الصيني في المنطقة، مع الاعتراف بأن التنفيذ الواقعي يظل تحديًا بسبب الخلافات التاريخية والأيديولوجية بين الفصائل الفلسطينية.
4- سياسةُ البراغماتية الصينية: تنطلقُ السياسةُ الخارجيةُ الصينية في التعامل مع الأزمات الإقليمية من مبدءٍ راسخٍ يقوم على البراغماتية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ويظهر ذلك من خلال ما يلي:
الأزمة السودانية، تحرصُ بكين على تجنّبِ الانخراطِ المباشر أو اتخاذ مواقف منحازة، مفضلةً اعتمادَ خطابٍ رسميٍ يتّسم بالاتزان والدعوة إلى الحوار السلْمي وضبط النفس، ويعكسُ هذا التوجّه حِرصَ الصين على الموازنة بين حماية مصالحها الاستراتيجية في القارة الأفريقية، والحفاظ على صورتها كقوةٍ دوليةٍ مسؤولةٍ تسعى إلى دعم الأمن والاستقرار عبر آلياتٍ متعددةِ الأطراف، لاسيَّما من خلال التعاون مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية.
وفي الأزمة الليبية، عمّقت الصين علاقاتها الدبلوماسية والتجارية على أسسٍ من الاحترام المتبادل والوجودِ الناعمِ بعيدًا عن أي تدخلٍ في السيادة الوطنية وذلك انطلاقاً من مبدأ “عدم الانحياز الاستراتيجي”[7]، وقد أكدت مواقفها الرسمية باستمرار على أن حلَّ الأزمة يجبُ أن يكونَ سلميًا قائمًا على الحوار، وأن وِحدةَ الأراضي الليبية أولويةٌ لا يمكنُ المسَاسُ بها. هذا النهْجُ منحَ بكين مساحةً لتعزيز حضورها الاقتصادي والتنموي في ليبيا، مع الحفاظ على موقعها كطرفٍ مقبولٍ من مختلف الفاعلين، بعيدًا عن الاستقطابات الحادة التي طبعت تدخلات قوى أخرى في الأزمة الليبية.
السدُّ الإثيوبي، فقد دعمت الصين بشكلٍ واضحٍ الحقوق المشروعة لمصر في حماية أمنها القومي المائي، مُؤكدةً في الوقت نفسه على ضرورةِ تجنّب التدخل الخارجي والاحتكام إلى طاولة المفاوضات[8]، ويكشف هذا الموقفُ عن خصوصية السياسة الصينية القائمة على الجمْعِ بين حماية مصالح الشركاء الاستراتيجيين وبين الالتزام بمبدأ عدم الانحياز. بذلك، تترسخ صورة الصين كقوةٍ دوليةٍ براغماتيةٍ تستند إلى أدوات “القوة الناعمة” والدبلوماسية الهادئة.
5- المُبادرة الصينية للحزام والطريق: تُمثّل مبادرةُ الحزام والطريق ركيزةً استراتيجيةً محوريةً في تعزيز البعد الاقتصادي للعلاقات المصرية–الصينية، ليس فقط كإطارٍ للتعاون بين دولتين، بل كأداةٍ لتشكيل نموذجٍ متكاملٍ للتنمية المستدامة والتكامل الإقليمي. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعدُّ قلبَ هذه الاستراتيجية، إذ توفّر بنيةً تحتيةً حيويةً تسمح بإنشاء مشاريعَ صناعيةٍ وتجاريةٍ ضخمة، وتسهّل الربط بين الأسواق العربية والأفريقية. وقد تبنت مصر المبادرة ليس فقط كمستقبِل للاستثمارات الصينية، بل كرؤية وطنية متكاملة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، تشمل مجالات متقدمة، وقد ساهم ذلك في تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، ويخلق آليات للاستفادة المزدوجة من الخبرات الصينية والبنية التحتية الوطنية، ما يجعلُ من مصر نقطةً محوريةً ضمن شبكة الحزام والطريق، ويؤكد على دورها الجيواقتصادي كحلقةِ وصلٍ حيويةٍ بين آسيا، أفريقيا، والعالم العربي. هذا البعدُ الاستراتيجيُ يجعل من المبادرة عاملًا محددًا رئيسًا في صياغة العلاقات الثنائية، إذ يرتبطُ مباشرةً بالأهداف الاقتصادية الوطنية لمصر وبخططها التنموية المستقبلية، ويعزز من مكانتها كشريكٍ رئيسيٍ للصين في المنطقة.
6- انضمام مصر لتجمع البريكس: حيث شكّلَ انضمام مصر إلى تجمّع البريكس منذ أوائل 2024 خطوةً استراتيجيةً لتعزيز التمركز الاقتصادي والدبلوماسي في النظام الدولي الجديد كصوتٍ لدول الجنوب العالمي، هذا الانضمامُ يمنحُ العلاقاتِ المصريةَ–الصينية بعدًا متعدد الأطراف، ويُتيح لمصر الاستفادة من مظلةٍ جماعيةٍ لتنسيق الجهود في مجالات التمويل والتكنولوجيا والتجارة بالعملات المحلية، علاوةً على ذلك، يعزّز البريكس قدرةَ الدول النامية، بما فيها مصر، على التأثير في أدوات العولمة الاقتصادية وآلياتها المستحدثة، ما يعكسُ توافقَ الرؤى بين القاهرة وبكين بشأن شمول دول الجنوب في صياغة النظام الدولي الجديد وتحقيق التعددية الاقتصادية والمالية.
ثالثًا: الأبعادُ الاستراتيجية في العلاقات المصرية-الصينية
تتسمُ العلاقات بين مصر والصين بعمقٍ استراتيجيٍ يعكسُ توافقَ رؤى البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية. وتشمل هذه الأبعاد مجموعةً من المحاور الرئيسية التي تعزّز الشراكةَ بين القاهرة وبكين، وتشكّل هذه الأبعاد الاستراتيجية قاعدةً متينةً لدعم الشراكة الشاملة بين البلدين، وفيما يلي أبرز هذه الأبعاد:
1- البعد السياسي:
يُمثل البعدُ السياسيُ أحد الركائز الأساسية التي تقومُ عليها العلاقات بين مصر والصين، ويعكسُ التوافق الاستراتيجي بين البلدين على عددٍ من المبادئ الدولية والإقليمية. وقد تجسّد هذا التوافقُ في دعمٍ مصر لمبادئ الصين الوطنية، بما في ذلك موقفُها من “الصين الواحدة” ووحدة أراضيها، إضافة إلى دعم الموقف الصيني فيما يتعلق بهونغ كونغ وفق مبدأ «دولة واحدة ونظامان» ورفْضِ التدخل الخارجي بحجةِ فرْضِ نموذجٍ ديمقراطيٍ معيّن، كما سعت الدولتان إلى تنسيقٍ مستمرٍ في مكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون مع الدول العربية ضمن إطار منتدى التعاون العربي–الصيني، إضافة إلى دعم التنمية الأفريقية من خلال برامج منتدى التعاون الصيني–الأفريقي، وقد بلغ التقارب السياسي بين البلدين ذروته بشكل واضح بعد ثورة 30 يونيو 2013 في مصر، حيث تبنّت الصين موقفًا إيجابيًا تجاه المتغيرات السياسية الداخلية، مؤكدًا احترامها للخياراتِ الوطنية المصرية، ومن هنا يمكن القول إن البعدَ السياسيَ للعلاقات المصرية–الصينية يقوم على قاعدةٍ من المبادئ المشتركة والاحترام المتبادل، ويشكّل الإطارَ الذي يدعم باقي أبعاد التعاون الثنائي.
2- البعد الاقتصادي والاستثماري:
تشهدُ العلاقاتُ الاقتصادية بين مصر والصين تحوّلاً نوعياً يعكس عُمقَ الشراكةِ الاستراتيجية بين البلدين، حيث تُعد الصين الشريك التجاري الأول لمصر، ويعزز تواجدها الاستثماري بشكلٍ ملحوظٍ عبر أكثر من ألفي شركة تعمل في قطاعات استراتيجية متنوعة، بإجمالي استثمارات مباشرة يقارب 9 مليارات دولار في عام ويعكسُ هذا التوسّع الاستثماريُ الطموحَ رؤيةً مشتركةً بين القاهرة وبكين لتعميق التعاون الاقتصادي، واستثمار الموقع الجغرافي المصري المتميز، خاصةً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي جذبت خلال العامين الأخيرين 128 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، شكّلت الاستثمارات الصينية نحو 40% منها.[9]
تعزّز هذه الديناميكيةُ الاقتصاديةُ انعقاد ملتقياتٍ استثماريةٍ مشتركةٍ، مثل الملتقى المصري–الصيني الأخير الذي ضمَّ وفداً صينياً يضم 37 مستثمراً يمثلون 23 شركة كبرى في قطاع الغزل والنسيج، وهو ما يؤكد التزام الجانبين بتوسيعِ آفاق التعاون التجاري والاستثماري. كما تشملُ شراكاتٍ استثماريةً ضخمةً مشاريع تنموية كبرى، منها البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة بتمويلٍ صيني بقيمة 3 مليارات دولار، والتحالف المصري–الصيني لزراعة مليون فدان باستثماراتٍ بلغت 7 مليارات دولار، فضلاً عن اتفاقيات تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة نحو 15.5 مليار دولار في[10]
ويعكسُ حجمَ التبادل التجاري المتنامي قوةَ هذا البعد الاقتصادي، حيث بلغ نحو 17.37 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ 15.78 مليار دولار في 2023، بنسبة نمو 10%، فيما سجلت صادرات مصر إلى الصين نحو 500 مليون دولار، في مقابل واردات تقارب 17 مليار دولار، وهو ما يدلُ على التفاعل الاقتصادي المكثّفِ بين الجانبين. من جهة أخرى، يعكسُ تواجدَ الشركات المصرية في السوق الصيني، بإجمالي استثمارات نحو 73 مليون دولار، اهتمام رجال الأعمال المصريين بالاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية في الصين، بما يعزّز التكاملَ الاقتصادي المتبادل ويدعم استراتيجية التنمية الوطنية في كلا البلدين.[11]
3- البعد العسكري والأمني:
شهدتْ السنوات الأخيرة تعزيزًا ملموسًا للتعاون العسكري بين مصر والصين، بما يعكسُ الأهميةَ الاستراتيجيةَ التي توليها القاهرة وبكين لهذا الجانبِ من الشراكة. يتضح ذلك من خلال الصفقات العسكرية المتقدمة التي أبرمتها مصر مع الصين، والتي شملت تحديثَ القدرات الجوية، الدفاعية، البحرية، والأنظمة الذكية. فمصر أتمّتْ طلبيةً أوليةً من الطائرات المقاتلة من طراز J-10CE في أغسطس 2024، مع استلام الدفعة الأولى في أوائل 2025، وهو ما يعكسُ رغبةَ القاهرة في تطوير أسطولها الجوي بأسلحة حديثة ومتقدمة تتناسب مع التحديات الإقليمية، وبأسعارٍ منافسةٍ مقارنةً بالمقاتلات الغربية، فضلاً عن الشروط المصاحبة لنقل التكنولوجيا التي تعزز الصناعة المحلية.[12]
في مجال الدفاع الجوي، عزّزت الصين القدرات المصرية عبر تزويدها بنظام HQ-9B بعيد المدى، وهو النظير الصيني لصواريخ S-400، ما يمثّل خطوةً نوعيةً لتعزيز قدرات مصر على حماية أجوائها من التهديدات المحتملة. بالتوازي، شهد التعاون مع الصين تطورًا في مجال الطائرات المسيرة، حيث حصلت مصر على Wing Loong-1D لتنفيذ مهامِ مراقبةٍ طويلةِ المدى وضرباتٍ دقيقةٍ، إضافةً إلى البدء في الإنتاج المحلي لطائرات ASN-209 بدعم تقني صيني، مما يرسّخ الشراكة الصناعية ويتيح نقل الخبرات الفنية إلى مصر.[13]
أما في المجال البحري، فتُجري مصرُ مفاوضاتٍ متقدمةً لشراء غواصاتٍ من الفئة الصينية Type 039A (Yuan)، مع ضمان نقل تكنولوجيا التصنيع، ما يعزّز قدرة الأسطول البحري المصري على تنفيذ مهام دفاعيةٍ واستراتيجيةٍ مع الحفاظ على عنصر الاستقلالية التكنولوجية. كما تشمل مجالات التعاون العسكري توفير أنظمة راداريةٍ متقدمةٍ وصواريخ جو–جو، مثل PL-15، لزيادة جاهزية القوات المسلحة وسد الثغرات الدفاعية على الحدود.[14]
علاوةً على ذلك، تجسّدت قوةُ الشراكة العسكرية من خلال التمارين المشتركة، إذ انطلقت في أبريل 2025 تدريباتٌ عسكريةٌ واسعةٌ تحت اسم “نسور الحضارة 2025”[15]، وهي الأولى من نوعها بين البلدين. شملت هذه التدريبات نشْرَ القوات الجوية والبحرية من كلا الجانبين، بما في ذلك مقاتلاتُ J-10C وطائراتُ إنذارٍ مبكّرٍ KJ-500 وطائراتُ تزويد بالوقود YU-20، إلى جانب مقاتلات مصرية ميغ-29M/M2، ما يعكس مستوى التنسيق العالي وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والصينية.
4- البعد الثقافي والتعليمي:
يشهدُ البعدُ الثقافي في العلاقات المصرية–الصينية زخماً ملحوظاً، إذ يمثّلُ أحد أبرز محددات تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي. ويعكسُ هذا البعدُ إرادةَ قيادتي مصر والصين على تعزيز التبادل الثقافي والإنساني، واستثمارِ الثقافةِ كأداةٍ من أدوات “القوة الناعمة” في السياسة الخارجية لكلا البلدين. ويكتسبُ هذا التعاونُ أهميتَه من التشابه الحضاري والتاريخي بين مصر والصين، إذ تُعد كلتاهما من أقدم حضارات العالم، ولها تأثير كبير على التراث الإنساني والثقافي المعاصر.
أحد أبرز مظاهر التعاون الثقافي بين البلدين يتمثّل في التبادلِ الأكاديمي والتعليمي. فقد زارَ وفدٌ من جامعة شاندونغ الصينية جامعة القاهرة، حيث استعرض رئيس جامعة القاهرة تاريخ الجامعة، وعدد كلياتها ومعاهدها (26 كلية ومعهداً)، بالإضافة إلى أعدادِ الطلاب (250 ألف طالب، بينهم 32 ألف طالب وافد من 100 دولة، مع حضورٍ كبيرٍ للطلاب الصينيين بالجامعة الأمّ والفرع الدولي بمدينة 6 أكتوبر). كما أُشير إلى الدور الحيوي لمعهد كونفوشيوس في تعليم اللغة الصينية وآدابها، فضلاً عن قسم اللغة الصينية بكلية الآداب، والذي يُسهمُ في إعدادِ كوادرَ قادرةٍ على تعزيز التفاهم الثقافي بين البلدين. ومن جانبها، عبّرت جامعة شاندونغ عن تطلعها لتوسيع التعاون الأكاديمي والبحثي، مستندة إلى خبرتها في إدارة 150 كلية ومعهداً ومجموعة واسعة من المراكز البحثية.[16]
يلعبُ معهد كونفوشيوس دوراً محورياً في تعزيز البعد الثقافي والاقتصادي بين البلدين، حيث ينظمُ اختباراتِ الكفاءة الصينية HSK ويؤهل المدرسين المصريين للغة الصينية، إضافةً إلى ترشيح الطلاب المصريين للمنح الدراسية في الصين. على الصعيد الاقتصادي، يُسهمُ المعهد في تلبيةِ احتياجات سوق العمل، عبر تنظيم ملتقيات التوظيف للشركات الصينية العاملة في مصر، خصوصاً في المناطق الاقتصادية مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة. كما أطلقَ البرنامج الدولي للغة الصينية لإدارة الأعمال بالتعاون مع جامعة جياوتونغ في شنغهاي[17]، ما يعكس التكامل بين البعد الثقافي والتنموي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين.
5- في مجال الفضاء والتكنولوجيا:
يُعد مشروعُ مركزِ تجميعِ وتكاملِ واختبار الأقمار الصناعية علامةً فارقةً في هذا المسار، حيث تمَّ إنشاؤه بتمويلٍ من المنَحِ الصينية بقيمة 21 مليون دولار، ما مكّن مصر من امتلاكِ بِنيةٍ تحتيةٍ فضائيةٍ متقدمة، ونقْلِ الخبرات الفنية الصينية إلى الكوادر المصرية من خلال المشاركة المباشرة في تصنيع واختبار القمر الصناعي مصر سات-2، الذي أُطلق بنجاح في ديسمبر 2023. إن هذا المشروع لا يُعزز قدرات مصر العلمية والتكنولوجية فحسب، بل يؤسس أيضًا لتمكينها من لَعبِ دورٍ محوريٍ على المستويين الإقليمي والأفريقي في ظل استضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية.[18]
وفي موازاة ذلك، عززت مذكرات التفاهم الأخيرة بين الجانبين في يوليو 2025 بُعدًا آخر من الشراكة الاستراتيجية، سواء عبر مبادرة التنمية العالمية GDI التي تُرسي لأول مرةٍ إطارًا متكاملًا للتعاون الإنمائي لمدة 3–5 سنوات، أو من خلالِ اتفاقياتِ مبادلةِ الديون من أجل التنمية التي تُعدُّ أداةً مبتكَرةً لتوجيه المديونية الصينية نحو مشروعاتٍ في قطاعات الطاقة، الصحة، التعليم والتدريب المهني. وبهذا المزْجِ بين نقل المعرفة، توطين التكنولوجيا، والتمويل التنموي المبتكر، تُرسّخ العلاقاتُ المصريةُ–الصينيةُ موقعها كأحد النماذج البارزة للتعاون جنوب–جنوب القائم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.[19]